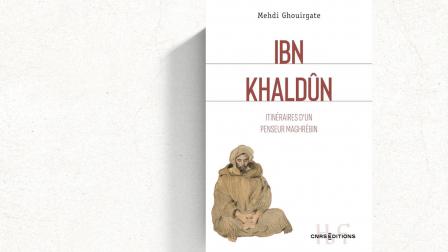استمع إلى الملخص
- **الحياة اليومية في النزوح:** تصف الكاتبة روتينها اليومي في الخيمة، حيث تصلي وتتناول إفطارها قبل التوجه للعمل. تلاحظ معاناة الناس من حولها، مثل السيدة العجوز التي تنتظر دورها للحصول على الماء، والأطفال الذين يجمعون الحطب.
- **ذكريات الفقد والألم:** تتذكر الكاتبة زوجها جمال الذي كان يساندها في حياتها اليومية. بعد استشهاده، تغيرت حياتها بشكل جذري، وأصبحت مليئة بالألم والذكريات المؤلمة، خاصة في المناسبات مثل الأعياد.
صحوتُ على أصوات القذائف. ظننتُ أنني في بيتي، ظننتُ أنّ كلّ شيء قد انتهى وعادت الحياة كما كانت. ولإحباطي الشديد، عندما صحوت وجدت نفسي بين أولاد إخوتي أعيش في خيمة، نعم خيمة أعيش فيها مع عائلتي قبل ان أتزوج ولم أجد جمال زوجي ورفيق دربي، فقد رحَل في الحرب وأخذته ماكينتها اللعينة حين استشهد في ذلك اليوم الأسود. نعم صحوتُ مفزوعة مرتبكة فنحن في خيمة النزوح ووجع الحرب وقهرها وآلامها.
في الليل كنت أحلم أني في بيتي، عدتُ إليه أو أن شيئاً لم يتغير، وأن الحرب انتهت وذهبت وتركتنا وأنني، كما في حلمي، أعيش حياتي كما كانت لم يتغيّر فيها شيء، أعيش مع جمال. أفقتُ لأجد نفسي في خيمة بين أفراد أسرتي وأهلي بعد أن فقدنا من عائلتي شهداء، وهُدمت منازلنا وخربت ديارنا وذهبت أحلامنا أدراج الريح. لقد سرقت منا الحرب كلّ معاني الحياة، وكل تلك الأشياء الجميلة التي كانت لنا.
قمتُ مثلما أفعل كل صباح، أصلي وأرتدي ملابسي لأتوجّه لعملي. شربتُ شاياً وأكلت سندويشاً من الزعتر وخرجت من الخيمة لأرى معاناة الناس وحياتهم الجديدة. كأنني أفيق من حلم.
هذا السيدة العجوز تحمل غالون مياه واقفة أمام برميل المياه تنتظر دوراً.
وذلك الطفل يلملم أوراق الأشجار ليوقد النار للخبز والطبخ بعد أن ضاعت أحلام الطفولة وتبخّرت أوقات الدراسة واللعب، وذاك الطفل يبيع ما تبقّى من الكابونة لشراء أشياء أخرى، ورابع يبيع الخشب للناس، ورجلٌ يبحث في الأسماء المعلّقة على الجدران عن موعد دوره في قائمة الطحين. وزحمة الطريق وركوب الكارات والشاحنات بدلاً عن السيارات.
أفقتُ لأجد نفسي في خيمة بين أفراد أسرتي وأهلي بعد أن فقدنا من عائلتي شهداء، وهُدمت منازلنا
ياه. إلى هذا الحدّ وصلنا! كلّ هذا فقط جزء من نظرة الصباح. نظرة الصباح المؤلمة. صباحٌ بلا جمال. أوجاعنا كبيرة والفقد صعبٌ ومؤلم والأصعب عندما تجلس وحدك وتتذكر شريك حياتك ورفيق عمرك. آاااااااه يا لمرارة الفراق.
أنام وأنا أبكي. والله من كثرة الدموع وفيضه ضعُف بصري ويكاد يذهب.
كنت أظنّ أني قوية قادرة على تخطّي المشوار بسهولة، كنتُ أقول مجرّد حرب أخرى وتنتهي ونعود لسيرتنا الأولى. فجأة انكسر عمودي الفقري عندما استشهد زوجي جمال محمد أبو رقعة، انتهت حياتي. تغيّرت. انقلبت رأساً على عقب.
جمال الطيب الخلوق المحب البسيط المؤمن الذي كان يصحو مع أذان الفجر يصلي، وبعدها يوقظني حتى أصلي. وعند السابعة والنصف وبعد أن تشرق الشمس كان يساعدني في ترتيب أشيائي، وأنا أتجهز للذهاب للعمل مشرفة على نشاطات "مركز يافا الثقافي".
بعد الحرب، صرنا نعمل على تنفيذ نشاطات ترفيهية وتثقيفية وتربوية في مراكز النزوح في منطقة خانيونس، وبعد ذلك ضمن مؤسسات دولية تساعد على تقديم خدمات للنازحين، أو المساعدة في الطهي في "تكية" أقمناها للطهي للناس ولتوزيع الوجبات عليهم. عملنا الثقافي تحول إلى إغاثي في مجمله. هذه حاجات الناس الآن.
أوجاعنا كبيرة والفقد صعبٌ ومؤلم والأصعب عندما تجلس وحدك وتتتذكر شريك حياتك ورفيق عمرك
في منتصف النهار، يتصل بي ليطئمن على سير عملي. كنتُ أشعر بهذا الحب وهذا الاهتمام. عند عودتي من العمل كان ينتظرني أمام الخيمة نسرق الوقت للحديث معا قبل أن أدخل خيمة النساء حيث إننا نسكن مع العائلة الكبيرة وثمة خيمة للرجال وخيمة أخرى للنساء.
كان جمال يمضي وقته في متابعة شؤون المركز الثقافي. يذهب هنا ويذهب هناك باسم المركز يحاول أن يقدّم خدمات الناس ومساعدتهم قدر المستطاع. في الحرب، شعرتُ بخوفه الكبير علي وبحبّه الأكبر لي، وكنتُ أبتسم في داخلي وأفرح.
ذهَب جمال. أخذته ماكينة الحرب. انكسر العمود الفقري، وضاعت الابتسامة ولم أعد أجد الاهتمام والحب، ولم أعد أهتم فضاعت ابتسامتي. كان وجوده في الدنيا يهوّن عليّ صعوبة الحياة وقسوة النزوح، ويجعل للحياة معاني كثيرة. وكنتُ دائماً أراه ينظر إليّ من بعيد يدفعني للأمام.
لماذا ذهبتَ وتركتني!
أيام الحرب أيام عصيبة وقاهرة. تمرّ بنا كأنها كابوس لا ينتهي وسرقت منا الأمان وراحة البال وسرقت مني زوجي. أطلق القناصة عليه النار وتركه الجنود ينزف حتى صعدت روحه إلى السماء.
هذة لحظات صعبة كلما أفكر فيها أموت، وأموت في اليوم ألف مرة كلّما خطرت على بالي. كلما أصحو ولا أجده بجواري، عندما يأتي موعد الغداء ولا يكون، عندما يأتي الليل ولا أجده لأتحدث معه قبل النوم. تغرق الدموع عيني وأنا أتقلّب في ذكرياتي معه وأقول "ليتك أخدتني معك".
في هذه اليوم، خرجتُ إلى عملي كالمعتاد. كنا نعيش في الخيام بعد أن اضطررنا لترك مخيم خانيونس بعد دخول الجيش إليه. عند انسحاب الجيش من المناطق التي قام بتدميرها عقب اجتياحه لمدينة ومخيم خانيونس عدنا لنتفقد بيوتنا وحارتنا ومخيمنا. سرنا من منطقة المواصي قرب البحر التي نزحنا إليها لمناطق الاجتياح السابق. ما أصعب تلك اللحظات!
كنتُ برفقة أخي الذي استشهد ابنه مع جمال نسير في الشارع في طريق عودتنا للبيت. في الطريق، يا الله، رأيت سيارة جمال. وسمعت صوتاً ينادي ويقول "هذه سيارة جمال". وقفت أمامها. أمسكتُ الكرسي الأمامي حيث كان يجلس وهو يقود وأنا أجلس بجواره. تذكرت مشاويرنا لمدينة غزّة. كانت طريقاً طويلة نسبياً. وكان جمال طوال الطريق يستمع لأغنية "تعب المشوار"..
سمعت الأغنية الآن وأنا أقف أمام السيارة. سمعتها وأنا أمسك بالكرسي، أتخيل جمال يقود بنا الطريق لغزة. بكيت. يا لقسوة التذكر. كانت الساعة السابعة صباحاً، رأتني امرأة عجوز تجلس في خيمتها بجوار السيارة، سألت: "هل هذه سيارة أخوكِ أو سيارة زوجك؟". هززتُ رأسي ومسحت دمعتي ومشيت. يا الله تعبت من المشوار.
استمرت أيام الحرب واستمر الوجع. كل يوم حكاية وكل يوم ألم جديد. في الحرب كل فقْد قصة خاصة، وفقدي كما قصتي موجع ومؤلم. في العيد كما أفعل كل عيد، جهزت ملابس وأحذية العيد لجمال لكنه لم يلبسها. في عيد الفطر، جهزتُ كل شيء وانتظرت أن تحدث معجزة ويأتي ليلبسها، كذلك في عيد الأضحى، لكنه لم يأت. ذهب وتركني. ذهبتُ للمقبرة لزيارته وعدت بوجع أكبر وأشد.
هكذا، بهذه البساطة، تستمر الحياة ويستمر وجعنا.
أول أيام عيد الأضحى
16 حزيران/ يونيو 2024.
* كاتبة من غزة