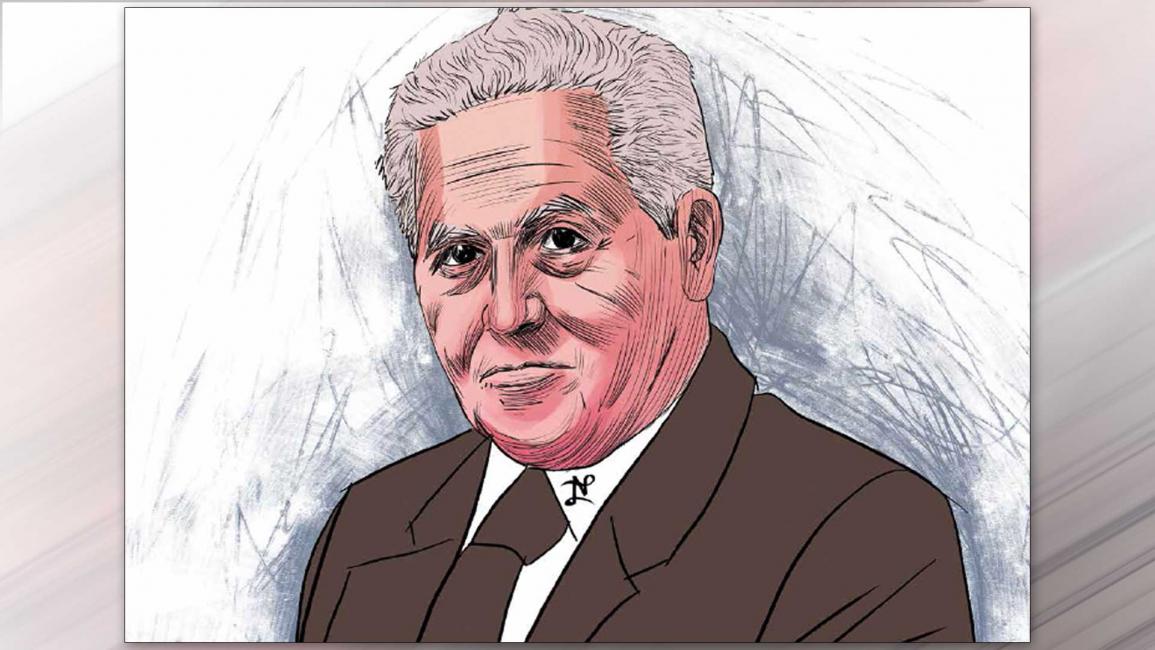الجزائر في تفكير عبد الله العروي
ليس من الصعب أن يدرك القارئ من كتابات عبد الله العروي ومواقفه السياسية والفكرية من قضية الصحراء، أنّه يقف بـ "حزم تاريخي خاص"، لم يتوفّر لغيره من المُؤرّخين، على الأرجح، في جانب المغرب، دولةً ومؤسساتٍ وسياساتٍ، بل ويتوافق بصورة واضحة مع الاختيارات الاستراتيجية العامّة المُنْتَهَجَة في الدفاع عن تلك القضية، بما في ذلك، بطبيعة الحال، أسلوب ومنطق مقارعة التصوّرات الجزائرية الرسمية، التي تناصر جبهة بوليساريو، وتدعم ما تطمح إليه هذه الجبهة من انفصال، وبناء جمهورية خاصّة بالمعايير "التحرّرية" نفسها؛ العربية والديمقراطية والشعبية، التي اعتمدتها دولة الجزائر بُعَيْد حصولها على الاستقلال في أوائل الستينيات.
وليس في هذا كلّه ما قد يثير، إن كان قارئ العروي على علم مُؤكّد بأنّه كتب في هذا مقالات بالفرنسية، نُشر أغلبها في مجلة لاماليف سنتيْن، منذ أوائل الثمانينيات، ثم جمعها في كتاب "الجزائر والصحراء المغربية"، الذي صدر في 1978؛ في عزّ المواجهات العنيفة، التي قامت بين جبهة بوليساريو (بدعم من الجزائر) والمغرب. والسند في تلك المقالات المُتعلّقة بالصحراء، والصراع ضدّ الجزائر بصورة أساسية، تتّسم بما يمكن الاصطلاح على تسميتها "الدعامة الوثوقيّة"، النابعة من المعرفة التاريخية بتجاربَ الدول المغاربية، الأكثر أهمّية، في حقب متواصلة من التاريخ، تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ما يعني أنّ المُؤرّخ، في هذه الحالة، وبناءً على الموضوع، لا يُخفي قناعاته الفكرية ولا السياسية في تناول قضية الصحراء من مختلف الجوانب المرتبطة بها، واعتباراً لمجمل الفاعلين السياسيين المُتدخّلين في شأنها، مع إقراره الواضح، وله فيه بيانات وحجج، بالموقف الحاسم؛ أنّ الصحراء مغربية. وأمّا المُؤامراتُ، التي تحاك ضدّ المغرب في سبيل سلبها منه، فلا سندَ لها، ولا أملَ في تحقيق مطامحها، ولا مستقبل لما يُعلّق، من الناحية الاستراتيجية، على جمهوريتها المُستقلّة آجلاً.
تبرير العروي الأيديولوجي ينطلق من تحليل مواقف السياسة الجزائرية، التي تلوك الاستراتيجية "اليعقوبية"، على الطريقة المُعَرَّبَة، التي كرسها هواري بومدين (1978) في سلوك الدولة
ولكنّ الموضوع الجوهري في الموقف من الصحراء، ليس من هذه القضية إلا بمقدار ما هي عليه دولة الجزائر من أهمّية ودور، وأثر في الدعم والمساندة لمسألة الانفصال، تحت شعار "تقرير المصير"، وما يتبعه مادياً وإعلامياً من مبادرات وأفعال، تتحوّل بها دولة الجزائر، وخصوصاً في صعيد المواجهات العامّة ضدّ المغرب في المحافل الإقليمية والدولية، إلى القوّة الأساسية المباشرة المُستهدَفة بكلّ نقدٍ، والمُعَرَّضَة لكلّ هجوم. فالصحراء، في نظر العروي، موضوع مهمّ، يتعلّق بالتاريخ والسيادة والحقّ، ولكنّه بديهي لا يتطلب كبير عناء لتسفيه أطروحات الخصم وإثبات خطلهم. ومن هذا المنظور، تصبح الجزائر الخصم والعدو الأكبر، والدولة الساعية إلى الهيمنة ضدّ الحقّ ومنطق التاريخ، خصوصاً، عندما صنعت لذلك جَبْهَةً، وَكَّلَتْهَا أمرَ الكفاح المتواصل، بشعارات مطلقة، تبتغي الانفصال، ضدّ المغرب للحَدّ من طموحاته التنافسية، وتقليم وجوده التاريخي المبني على ما يسميه كاتبنا بـ"البَيْعَة"، واستنزاف قدراته الماديّة، التي يمكن أن تكون أساساً وجيها للتنمية المُستدامة، أمّا المعنوية، فشبح الحرب وسباق التسلح قائمان باستمرار، يتوعّدان كلّ حالمٍ بالسلم والتغلب على المشكلات العالقة بين البلديْن. والتركيز، هنا، على الموضوع بهذا الإلحاح، لتبيان أنّ الموقف، الذي يتبنّاه العروي، يمكن أن يقود إلى نوعيْن من المُفارقات، تفعل فيهما سنوات الصراع، الذي طال واستطال، بل وأصبح ينتج، بسبب ذلك، أشكالاً وصوراً مختلفةً من العداوات، التي لم يسبق أن كانت بنفس الحدّة والضراوة بين بلديْن (شقيقيْن)، يرى كاتبنا أنّ لهما معاً "نفس الثقافة، ونفس الماضي، وهما بالنتيجة يواجهان نفس المشاكل الاجتماعية والتعليمية". وهذه، بالذات، هي المفارقة الأولى التي تعني، معنوياً وفكرياً، ذلك التجَاوُز الخارج عن المألوف لبعض الأفكار المتناقضة، والتي تُخاض فيها، من الناحية السياسية، حربٌ غير معلنةٍ من الطرفيْن، بعد أن كانت العلاقة في التاريخ بينهما على قدرٍ من الوئام والتضامن كَبِيرَيْن. أمّا المفارقة الثانية، فهي القول المُؤكّد بالاستحالة المُطلقة لتحقيق "التفاهم الممكن بين النظاميْن والدولتيْن". وتبرير ذلك، بالنظر إلى أنّ "الذين يتحكمون في الجزائر اليوم لا يعملون إلا على متابعة سياسة يجهلون أسسها بدون شك"، كما أنّ تبريره الأيديولوجي ينطلق من تحليل مواقف السياسة الجزائرية، التي تلوك الاستراتيجية "اليعقوبية"، على الطريقة المُعَرَّبَة، التي كرسها هواري بومدين (1978) في سلوك الدولة، وركّزها في عقول النُخب، ثم سارت عقيدة شعبية تقريباً، منها ينطلق التفكير، الذي يحدّد العلاقة مع الجار الغربي، وعليه، يُبني التحليل، الذي يُعْقَدُ به تدبير العلاقة معه.
ومن هاتين المُفارقتين، يصل العروي إلى رأي فيه تَقْدِيرٌ، يراه كاتب هذه السطور خاطئاً، لدورٍ يجب أن يُنْجَز "سوياً، بعيداً عن الإطار الرسمي للإفلات، بهذا الصنيع، من تقلبات السياسات المُتبعة من طرف الدولتيْن". وفي هذا الدور، كما يُقدّر كاتبنا، المَعْبَر الوحيد نحو تجاوز "الاستحالة المطلقة" المشار إليها أعلاه. فالاعتقاد هنا، وهو جوهر الرأي، أنْ يقوم ما يسمّيه بـ "التعاون المدني" بين مختلف المنظمّات المشابهة الموجودة في البلديْن، والتي تعمل بفعالية ملحوظة في حقول مختلفة، بعضها يسعى للنهوض بأوضاع المرأة والشباب، وبعضها الآخر يدافع عن تَطْوِيرِ "وضعية اللغتين الموجودتين في البلديْن، وهما العربية والأمازيغية"، ومن تلك المنظّمات، أيضاً، من تدافع عن "الحقّ في الإجهاض، ومناهضة الحكم بالإعدام". وهذا هو السبيل إلى توليد "الحوار والتفاهم ومختلف الأسباب والأساليب التي قد تدعو إلى تجاوز الحاجز الجوهري ... وفي العمق منه قضية الصحراء"، بين المغرب والجزائر. بيد أنّه من الواضح أنَّ العروي لا يدرك، إدراكاً واضحاً، طبيعة الهُوَّة القائمة بين الدولتيْن في آخر عقديْن، تبعاً للإجراءات والقرارات المُتّخذة، فضلاً عن طبيعة المواقف المُعلنة من الجانبيْن، بكثير من الحدّة واللؤم والعماء السياسي، المُؤثّرة في القرارات السيادية، بمبرّرات أيديولوجية خرقاء، تُفسد الوعي والجوار والأخوّة المغاربية بأبعادها المختلفة؛ عربية وأمازيغية وإسلامية وأفريقية وإنسانية.. والواضح أنّ ذلك كلّه كان، باختلافات واضحة وأدواره المتباينة، من فعل سياسة الدولتيْن وتوجّهاتهما الاستراتيجية في المنطقة، بالإضافة إلى تحالفاتهما على الصعيد الدولي. مؤدى ذلك، هو الوصول بالوضعية إلى شفير الحرب، التي لا يستطيع المجتمع المدني، مهما كانت أدواره ومجالات عمله، أن يتخطّاها للقيام بأيّ بفعل ممكن أو مستحيل في استقلال عن الدولة التي تُحَدِّد له، هنا وهناك، مساحة الوجود القانوني، والدور الفعلي، كما ترسم له الحدود التي لا يمكن تخطّيها من دون الوقوع في المحظور.
وليست جمعيات المجتمع المدني، مهما كانت وتعدّدت أدوارها، بأفق مُعارِضٍ أو مضادّ للسلطات القائمة، إلا "مظاهر" ظرفية لوجود اجتماعي
وعموماً، هناك من الأمثلة، الخاصّة والعامّة، المُعبّرة أشد تعبير ممكن عن المحاصرة والقمع والتسويف وقلّة الدعم، أو غيابه التام، والعوائق القانونية والإدارية، التي تحدّ من إمكانية القيام بعمل حرّ في توجّهاته واختياراته، ما قد يعجز اللسان عن التعبير عنه بوضوح، أو أن يدينه بفعل ديمقراطي نزيه. أضف إلى ذلك، أنّ القضايا التي يُناضل "المجتمع المدني"، وهو أبنية ضعيفة ومُخْترَقة ومَدِينَة للمُورّدِين الأجانب، من أجلها مختلفة ومتفاوتة، ولها في كلّ بلد سياقها الخاص في جميع المستويات. فلا يمكن للحوار إذا تمّ، وقد تمّ في فترات سابقة بالفعل، أن يتخطّى الإجراءات العملية، التي تقوم بها الدولة والأذون الخاصّة، التي تصدر عنها. ثم كيف للمجتمع المدني أن ينوب عن الدولة، التي هي، قبل كلّ حوار أو تعاون، مفهومٌ سياسيٌ يتعلّق بشكل من أشكال التنظيم الاجتماعي، الذي له مؤسّسات سيادية تنظّم حياة مجموعة كبيرة أو صغيرة من الأفراد في مجال ترابي مُعيّن؟ إذ هي الأساس العام، والمُنظّم الأكبر، بأجهزتها المختلفة، لوجود المجتمع ومستويات بنياته وأوجه العمل فيه، وليست جمعيات المجتمع المدني، مهما كانت وتعدّدت أدوارها، بأفق مُعارِضٍ أو مضادّ للسلطات القائمة، إلا "مظاهر" ظرفية لوجود اجتماعي، غالباً ما يكون مرتبطاً بالمهام التي يختارها بإذن من الدولة نفسها لعمله في ميادين محدّدة، تبعاً للاختيارات التي يرسمها، ومن هذه ما هو سياسي، وله تبريرات إيديولوجية متداولة بين المُهتمّين والعاملين، بها يُقاس ويُحدّد الدعم، وترصد الميزانيات الملائمة، أو غير الملائمة لذلك.
أعود إلى "الاستحالة المُطلقة" لأستخلص ما يأتي: إنّ المصالحة بين الأمم تقوم بها الدول، وتستجيب لها الشعوب، ولها آليات مُختلفة لا يمكن أن تَفْلِتَ، كما كان على كاتبنا عبد الله العروي أن يقول، وليس شرطاً، من التوجّه الديمقراطي والحقوقي والإنساني والسلمي والمستقبلي، حتّى تكون مصالحة تاريخية مطلوبة.