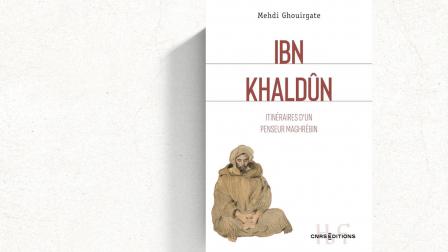عندما قدم ألبيرتو أنجيلا مدينة القدس هذا الموسم في حلقةٍ عاد فيها 2000 سنة إلى الوراء من حياة المسيح، ضمن حصته الثقافية الشهيرة "أوليسي"، وصف القدس بالمدينة الاستثنائية الشبيهة في عمقها الحضاري بمدينة روما، ولكنها أقرب في مشهديتها إلى مدينة ماتيرا جنوب إيطاليا "في شكل حجرها الحارّ الذي ينطق تاريخا". ليتم في الشريط الوثائقي الذي عُرض على القناة الوطنية الأولى Rai 1 اقتباس من قصيدة "قدس" للشاعر الفلسطيني نجوان درويش مترجمة إلى الإيطالية من وسيم دهمش وبإلقاء الممثل الإيطالي لوكا ورد:
"عندما أُغادركِ أَتحجَّر
وعندما أَعودُ إليكِ أَتحجَّر
أُسمّيكِ ميدوزا
أُسمّيكِ الأُخت الكبرى لِسَدَومَ وعَمورة
أَيتها الجُرْن الصغير الذي أَحرق روما
القتلى يَزْجِلون على التلال
والعصاةُ عاتِبون على رواة قصَّتِهم
وأَنا أَتركُ البحرَ ورائي وأَعود إليك
أَعودُ
بهذا النهر الصغير الذي يَصُبُّ في يأسِكِ
[...]
عندما أُغادركِ أَتحجَّر
وعندما أَعود إليكِ أَتحجَّر".
وهكذا أيضا وصفت باولا كاريدي في إصدارها الأخير "القدس" سكان هذه المدينة "المصنوعون من حجر. تماما مثل حجر هذه المدينة". (ص. 120) المدينة التي قدمتها الصحافية الإيطالية في عمل قصصي موجّه لليافعين صدر مؤخراً عن منشورات فيلترينيللي العريقة، بعنوان "القدس. حكاية/تاريخ الآخر".
الكتاب الذي يقع في 140 صفحة يأخذ شكل الـ chapter book الرائج في الأدب الأميركي والموجّه للشريحة العمرية بين 9 و12 سنة. رسمت صوره "مارتشيلا أونزو" بألوان طغى عليها الذهبي الذي يذكّر بلون قبة الصخرة، وهو أيضا اللون الذي اختير للغلاف الذي حاول أن يعكس التنوع الإثني والعقائدي والثقافي للمدينة. وتحت عناوين: "من يد ليد"، "بيت دجاني"، "إبراهيم المغربي"، "تحت المِشط"، "لمن هذا البيت؟"، "المبارزة"، "اقفز على الجدار"، "جاران"، "سميرة وأنا"، توزعت الفصول التسعة للقصة التي حاولت الكاتبة الإيطالية، التي أقامت في القدس عشر سنوات كاملة، تبسيط تاريخها ومرافقة قرّائها إلى شوارعها التي "تتلامس فيها حيوات البشر وتتقاطع بمسافات مدروسة".
وهكذا ومن خلال لحظة تلامس غير مقصودة بين بطلتي القصة بدأ كل شيء في "القدس"، على نحو لم تخلقه سوى الصدفة. الصدفة التي قد نعتبر حصولها أمراً رائعاً في الحياة اليومية، لكن حدوثها في الكتابة يعدّ هِنة سردية، بعيدا عن مميزات أدب العصر الفيكتوري وتقنيات دوستوفسكي وديكنز الخاصة.
ففي كتابه "أسرار القصص المروية جيداً" يشبه ويليام سي. مارتل حبك أي قصة بلعبة تنس بين بطلين يتقاذفان الكُرة، فإن خرجت الكُرة عن الملعب وقرّر الكاتب توظيف الصدفة لإعادتها للبطل من خلال جعلها تلف وتدور في الحقول ثم تعود بقدرة قادر داخل الميدان، فنكون هنا خارج قواعد لعبة الكتابة.
وفي ملعب كمدينة القدس المحتلة تدرك كاريدي جيدا أنه يخضع لقواعد صارمة، أتى توظيف الصدفة مدروساً بحِرفية عالية، ففي ميدان تدرك الكاتبة صرامة التقسيم فيه شرحت كاريدي باستفاضة قواعد العيش فيه على لسان البطلة العربية: "هنا في القدس، الجميع حريص على عدم التعثر بالخطوط اللامرئية للحدود... كل يوم أشعر بأنني السارق الذي يحاول تفادي خطوط الليزر في فيلم Ocean’s Eleven. أعبر من رصيف لآخر بحسب الحيّ الذي أمرّ به. أدخل محلاً تجارياً وأتفادى آخر. أقصد صيدلية بعينها وليس أخرى... لدي خارطتي الخاصة للقدس. وهي ليس نفس خريطة الفتاة التي خرجت من بيت دجاني" (ص. 23).
وهكذا كان توظيف الصدفة لدى كاريدي في هذه القصة مقصوداً، ومبرَّراً بخلفية اللحظة المشحونة تاريخياً، والتي أدت للتلامس/التشابك بين شابتين تقطنان نفس المدينة وتتشابهان في الملامح والسن والذوق، بل والخلفية المهنية لجديهما اللذين كان يعملان في ذات الحرفة "صناعة النسيج" الأول في القدس والآخر في فاس، لكن إحداهما فلسطينية والأخرى "إسرائيلية"، سميرة وسارة. وتذهب الصدفة بعيداً ويتبين أن سارة التي تقطن في شارع اسمه بالدوين، كما أطلق عليه الإنكليز، لكنه يحمل اسماً آخر الآن ذلك أن "كل من يأتي إلى القدس يعطي لنفسه حق تسمية الشوارع ومسح الذاكرة" (ص 16)، هو البيت الذي كان ملكاً لجد سميرة، التي تعيش عائلتها في بلدة العيزرية حالياً، وكل ذلك قبل أن يضرب المدينة زلزال "التاريخ".
"التاريخ" الذي لم تقتصر وظيفته على التأثيث السردي للعمل بل تحوّل إلى شخصية شبحية تتجوّل بين صفحات الكتاب وتطل في مشاهد محسوبة على نحو مربك، تخلع عن نفس سارة بالتحديد الطمأنينة وتبثّ فيها الخوف والتوجّس من كلّ شيء وأيّ شيء وحتى من أطفال في سن العاشرة، وذلك عندما انحرفت في أحد المشاهد عن الطريق المخصص للإسرائيليين ودخلت عن غير قصد البلدة القديمة وبالتحديد "الحيّ المسيحي" حيث كان الأولاد يلعبون ويركضون دون أن يسقطوا على الأرض ويكسروا سيقانهم "كانوا مرنين كالوعال الجبلية، يتحدون الجاذبية". فكّرت سارة: "لو لم تكن هذه الحرب التي لا يبدو لها أي نهاية، لكنت قد اعتبرتهم كأبناء أخ أو أخت. أطفال يركضون دون أغلال "التاريخ". (ص 68).
وقد أخذت الكاتبة على عاتقها شرح تاريخ هذه المدينة، تارة من خلال مقاطع مفكوكة من المت تميّز قصص chapter books شارحة الخلفية التاريخية والثقافية للمدينة. ولكنها تركت أيضا لشخوصها المجال لسرد تاريخهم على لسان عم سميرة في الفصل الافتتاحي وهي حكاية والده قبل 1948 على الجانب الآخر من المدينة نفسها، أما على لسان والد سارة "أفراهام"، فكان تاريخه مرتبطا بذكريات طفولته في المغرب وحنينه لأصدقائه في حيّ اليهود في فاس: "... لقد تركنا كل شيء وراءنا، محل الأقمشة، حي "الملاّح"، أصدقائي، رفاقي في المدرسة، المدافن البيضاء للمقبرة اليهودية القديمة". ليأتوا بعدها إلى "الأرض الموعودة" التي عاشوا فيها أولاً في بؤس شديد داخل خيام مهترئة، يقضون حاجتهم في العراء "أمن أجل هذا؟ أمن أجل هذا تركنا المغرب؟" هكذا كانت تبكي والدته وهم يقفون في الصف للحصول على الماء. (ص 54).
في المقابل، تركت الكاتبة الحصة الأكبر من التاريخ لتسرد على لسان شخصية لا هي فلسطينية ولا هي إسرائيلية، بل راهب إيطالي "أبونا غابرييلي" أرادت له كاريدي أن يتحوّل إلى همزة وصل بين الشابتين، اللتين تجمعهما إيطاليا أيضا بحب "النوتيلا"! توظيف هذه الشخصية في القصة، ومعها "النوتيلا" أيضا كان أساسياً، ليس لضمان شيء من الحيادية على السرد ومَنَح فضاء سردها طابعاً معولماً، بل لإخراج القضية من فضاء أيديولوجي لا يستسيغها عموم الشعب الإيطالي. وبتوظيف صوت الراهب هذا، قد قدمت للقضية الفلسطينية في إيطاليا مساحة لا يبلغها النشطاء ذوو التوجهات الأيديولوجية المتشددة، والذين نخشى أن القضية الفلسطينية تحولت معهم إلى فولكلور يتم التسويق له بمفردات تيارات فكرية غير محبوبة شعبياً، ولا تكفي شعاراتها لصناعة خطاب رصين بخصوص أي من قضايا المنطقة.
 هذا وقد كان البعد الروحي أيضا حاضراً بقوة في السرد، من خلال صوت مؤذن الأقصى في الفجر، والذي كانت تربطه الكاتبة بلحظات الانفتاح الفكرية عند الصباح وتبادل الأحاديث المثمرة بين الأبطال، بينما رافقت دائماً فكرة انسداد الآفاق والتوجس مشاهد الوصول إلى "حائط البُراق/المبكى"، ليس لسميرة والفلسطينيين الذين كانوا يقفون على الحواجز بانتظار التدقيق في هوياتهم وهم يشعرون بالإهانة، بل لسارة أيضا نفسها التي ولدى دخولها خطأ "الحيّ المسيحي" كان عليها لتخرج منه العبورُ بين "الأعداء" في البلدة القديمة حتى تصل إلى "حائط المبكى" (ص. 66)، إلا أنها ولدى وصولها للتقاطع الذي يؤدي إلى الطرق التي يعبرها الإسرائيليون خصوصاً يوم السبت مارّين ببوابة دمشق (باب العمود)، كانوا أولئك هم "اليهود الأرثوذكس بملابس الاحتفال التي كانوا يرتدونها، وبالرغم من أنهم يهود مثلها، إلا أن سارة كانت تشعر أنهم بعيدون. بعيدون هم أيضا كالفلسطينيين" (ص 71).
هذا وقد كان البعد الروحي أيضا حاضراً بقوة في السرد، من خلال صوت مؤذن الأقصى في الفجر، والذي كانت تربطه الكاتبة بلحظات الانفتاح الفكرية عند الصباح وتبادل الأحاديث المثمرة بين الأبطال، بينما رافقت دائماً فكرة انسداد الآفاق والتوجس مشاهد الوصول إلى "حائط البُراق/المبكى"، ليس لسميرة والفلسطينيين الذين كانوا يقفون على الحواجز بانتظار التدقيق في هوياتهم وهم يشعرون بالإهانة، بل لسارة أيضا نفسها التي ولدى دخولها خطأ "الحيّ المسيحي" كان عليها لتخرج منه العبورُ بين "الأعداء" في البلدة القديمة حتى تصل إلى "حائط المبكى" (ص. 66)، إلا أنها ولدى وصولها للتقاطع الذي يؤدي إلى الطرق التي يعبرها الإسرائيليون خصوصاً يوم السبت مارّين ببوابة دمشق (باب العمود)، كانوا أولئك هم "اليهود الأرثوذكس بملابس الاحتفال التي كانوا يرتدونها، وبالرغم من أنهم يهود مثلها، إلا أن سارة كانت تشعر أنهم بعيدون. بعيدون هم أيضا كالفلسطينيين" (ص 71).
"أنا لا أرى سوى حواجز وحيطان. أخطئ في الطريق، لأجد نفسي في البلدة القديمة. ضائعة كلياً. فكّرت سارة. وفي تلك اللحظة، أدارت ظهرها للشلالات البشرية من المؤمنين الذاهبين لحائط المبكى. وعادت أدراجها، مدفوعة برغبة لم تعد قادرة على قمعها..." (ص 71).
وكانت هي تلك اللحظة التي قرّرت فيها الدخول لمحل تصفيف شعر فلسطيني لصاحبه إلياس المسيحي، والذي كانت تعمل سميرة في محله. وتبدأ بعدها التبادلات بين الشابتين، وحيث أظهرت كاريدي الفتاة الفلسطينية جريئة، قوية، معتدّة بنفسها وقادرة على التعبير عن رأيها بثقة، وأحيانا تكون نزقة. بينما كانت تعتري سارة في لحظات كثيرة حالات فزع من التعرض للاعتداء من سميرة:
"... سميرة لقد دعوتك إلى بيتي، وعندما كنت نائمة انتابتني نوبة فزع. شعرت وكأن قلبي سيقفز من صدري. لقد كنت خائفة منك".
"مني أنا؟ أنت هي من أنهت الخدمة العسكرية! أما أنا فلا أعرف حتى كيف هو شكل البندقية." (ص 107).
بندقية M16 كانت حاضرة في العمل في صورتها الرمزية. "الأحكام المسبقة تقتل كطلقات M16 أيضا". (ص 76). ولكن في صورتها الحقيقية عندما انتصب جندي إسرائيلي وهو يحمل سلاحه أمام "أبونا غابرييلي" والفتاتين غير بعيد عن حائط المبكى، مطالبا إياهم بالرحيل، ليضع حدا لحوار قد بدأ بينهم، وحيث كان الراهب الإيطالي يروي تاريخ الحي اليهودي لسميرة.
قدرة الكاتبة على توظيف الرمز في القصة أتت أيضا مع النظارات السوداء التي كانت مضطرة دوما سارة لارتدائها.
"... ألا يمكنك الذهاب إلى حائط المبكى دون نظارات شمسية؟ لماذا يا ترى؟".
"تعلمين أن الشمس تعمي الأبصار في القدس عند الغروب. أصبت بالتهاب الملتحمة بسببها، الشهر الماضي. ولا أرغب في حشو نفسي مجدداً بالأدوية..." (ص. 64) هكذا أجابت سارة أمها وكأنها لم تكن جزءاً أصيلاً من المكان يستطيع أن يتعايش مع عناصره الطبيعية. تماماً مثل مستعمري أستراليا الأوروبيين الذين تتزايد بينهم نسبة الإصابة بسرطان الجلد، لأن جلدهم ليس مكيفاً لتحمّل شمس أستراليا الحارقة. في المقابل، وفي حالة تناغم تلقائية مع عناصر المكان الطبيعية اندفعت سميرة مباشرة لدى دخولها المنزل الذي كانت تعيش فيه سارة إلى شجرة توت كانت تنتصب وسط البستان، وأكلت من ثمارها بتلذذ ودون أي توجس، في حين أن سارة وعائلتها لم تفكّر يوماً في قطف ثمار تلك الشجرة التي كانت قد غرستها جدّة سميرة بيدها. وهكذا وبالرغم من أن والد سارة يتكلّم العربية إلا أنه لم يعلّمها لابنته، فكانت لغة الحوار بين الشابتين هي العبرية، دون أن يمر الأمر بلا احتجاج من سميرة. "ولماذا أنت لا تتكلمين العربية؟ ألا تروننا؟ نحن غير مرئيين بالنسبة لكم؟ نحن موجودون على هذه الأرض منذ الأزل، ولم تفكري يوما في تعلّم لغتنا" (ص 75). وبالرغم من اختيار يهودية شرقية لتمثل الآخر (والآخر هنا هو رغم كل التعقيدات الإنسانية يظل رهينة المشروع الاستعماري) في هذه القصة لصنع شيء من التقارب بين البطلتين، إلا أن كاريدي لم تغفل في كتابها سرد تاريخ وجنسيات بقية المستعمرين، لا سيما الإثيوبيين والروس الذين لا يزالون يحافظون على لغتهم، كما وضّحت ذلك الكاتبة للقارئ الإيطالي.
وهكذا طرحت كاريدي بحرفية ورصانة تاريخ المدينة المعقد للقارئ الإيطالي، من خلال سرد ذكي، شخوص معبرة، ومفردات منتقاة بعناية، معيدة بذلك الإصدارات الإيطالية الخاصة بفلسطين هذه السنة إلى ساحة الكبار.
يذكر أن باولا كاريدي هي صحافية إيطالية من مواليد 1961 في روما، تعتبر من أهم الصحافيين المتخصصين في "الشرق الأوسط" وشمال أفريقيا، حاصلة على دكتوراه في العلاقات الدولية. تعاونت طيلة سنوات مع كبريات الصحف والمجلات الإيطالية، على غرار "سولي 24 أوري"، "فاميليا كريستيانا"، "إل فاتو كوتيديانو" و"لاستامبا". صدر لها عن فيلترينيللي عام 2009 "حماس"، وعام 2013 "القدس بلا إله". وعام 2007 "عرب لا نراهم"، وهو الكتاب الذي حاز جائزة كابالبيو في 2008، وترجم إلى العربية عن المركز القومي للترجمة عام 2011.
* روائية جزائرية مقيمة في روما، تكتب باللغتين العربية والإيطالية