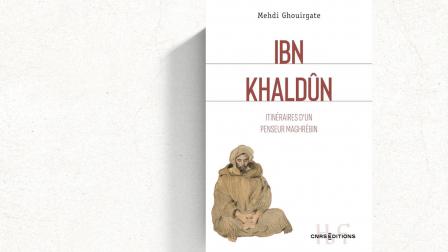عكست تجربة الكاتب محمود تيمور (1894-1973)، الذي تمرّ ذكرى رحيله في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ضرورةَ استحداث جنسٍ سردي جديدٍ، يستقي من التراث عباراته، ومن السرد الأوروبي يقتبس آلياته، ليتسامى، قصصيًا، بتحوّلات مصر في فترة ما بين الحربيْن وما بعدها.
فقد أسفر التِقاء نصوص التراث، في مُخيّلته، بأحياء القاهرة الشعبية، السائرة وقتَها من العهد العثماني نحو الطور الأوروبي فالاستقلال، عن ظهور شكل سرديّ مُبتَكر، هو الأقصوصة والقصة القصيرة، التي اجتهد تيمور في التأصيل لهما عبر مقاله: "فنّ كتابة القصة" (1940). فلماذا اختار الاشتغال على الأقصوصة من دون غيرها من أجناس الحَكْي؟
عمل صاحبُ "البارونة أم أحمد"، من خلال ممارسته لفنّ القَصص، الممتدة عقودًا، على اجتراح طريقٍ ثالث يَشقُّه بين الخطاب الروائي الغربي، الذي قرأه في لغته الأصليّة بحكم إتقانه للفرنسية واطلاعه على الكتابات الروسية والأميركيّة، وبين الكلاسيكية العربية التي دَعمتها حَركة الإحياء، لا سيما وهو يمتلك عيونَ نصوصها ونفائس مخطوطاتها في "المكتبة التيمورية"، التي أصبحت بمثابة أسطورة.
ومن هذا وذاك، مزج أساليب "الخبر"، كما أنضجته ريشة ابن عبد ربه، في "عقده الفريد"، والأصبهاني في "أغانيه"، فضلاً عن الحريري والهمذاني في "المقامات"، مزجها بآليات السرد الحديث التي كانت، على أيامه، في طور اكتمالها. ثم ما لبث أن سلّط هذا المزيج لتصوير أحياء القاهرة، مطالع القرن العشرين، واستلهام حكايات فَلاحيها ومعلّميها، مثقفيها ومُناضليها، مشرديها وعِليَتها، بعد أن هبّت عليهم رياح التحرر والرأسمالية والعقلانية.
تخَصَّص كاتب "سَلوى في مَهب الريح" في الأقصوصة، لأنها الأقدر من غيرها على استشفاف التحولات الخاطفة والمتسارعة التي أسفر عنها التحديث وقد ضرَب سائر قطاعات المجتمع. فلكلِّ شخصية حكايةٌ مع موجات التغيير، وكان لا بدّ من تسجيل تفاعلها مع المحيط الجديد عبر التقاطاتٍ قَصيرة وجيزة، تتابع المصائر المعقدة لتلك الشخوص وهي تُواجه عالمًا لم تَهضم بعدُ كلَّ مفارقاتِه.
وقد يُفسّر اختيار تيمور للأقصوصة بطبيعة "آفاق انتظار" القارئ، والمفهوم للمُنظّر الأدبي الألماني ياوس (1921-1997). فقد بات هذا القارئ يَتطلع إلى فهم متغيرات مُجتمعه، التي طاولت كلّ قطاعاته، عبر سردياتٍ "تحاكي"، والعبارة لفَلاسفة الإسلام عن الشعر، مَسيرات تلك الشخصيات التائهة بين فَكَّيْ الحداثة والأصالة، بين الأوضاع التقليدية والأدوار المستحدَثَة.
يريد القارئ أن "يتسلَّى" بتعقب مَصائر الناس التي يقرأها في الأقاصيص المنشورة في الجرائد والمجلات السيّارة. قارئ ما بين الحربين مَلولٌ: يَتَوجّس من المفاجآت ويراقب سَريع التحولات. ولكنه يتطلع إلى الفهم. والأقربُ إلى ذوقه تصويرٌ مُركَّزٌ سريع لشخصياتٍ طاولتها الأحداث، كما طاولته تمامًا. هذا الضربُ من التصوير لا ينهض به سوى فنّ الأقصوصة، ولا يَفي به غيرُهُ.
ولذلك سَلَّط تيمور ريشة سرده على "أحداث" يستلهمها من صميم الواقع المصري ويشوبها بِلُمعٍ من الخيال الرومانسي، غائصًا في أعماق شخصياتٍ تسير في إطار زمكاني منضودٍ بما يتلاءم مع طبيعة التجارب المنتقاة. يُجري تفاصيلَها بذكاءٍ لتصبَّ كلها في نهر واحد: تشكيل متماسك لسردية موجزة متكاملة، تستعيد ملامح تلك النماذج الاجتماعية التي تُثقلها المفارقاتُ والمحاذير.
ولعلَّ الأثر الأهم، ضمن التجربة التيمورية، كامنٌ في تطوير إحدى وظائف الضاد، وإخراجها من بيت الإنشاء إلى براعة الوصف وسلاسة السرد والحوار وسائر آليات القص التي تَهبُ اللغة قدرتها على إعادة بناء الواقع وإنشاء الشخصيات التي تستوي كائناتٍ من ورقٍ، ولكنها مؤثّرة، تتلبس القارئ وتعايشه، تخاطبه فتسليه أو تُشجيه. ففي أقصوصة "الشيخ عفا الله" (1936)، مثلا، دَغدغ فينا معاناة العشق الممنوع. وفي "الجنتلمان" (1942) أبغض إلينا النفاق والتصنّع والمجاملات الباردة.
وفي "شندويل يبحث عن عروس" رسَم الجرأة في الحب والإقدام عليه. وفي "صاحب الكلب" (1933)، لا ندري أنشفق على الطبيب البخيل العاشق لكلبه أم ننقم على بُخله الذي أردى بحيوانه؟ في كلّ شخوص حكاياته، التي تجاوزت المائة والخمسين، يخاطب منا ذكرَى ثاوية وينقلنا من شعور إلى آخر، يناقضه ويداريه. تَخلق روعة البناء هذا الإحساس المتناقض، الذي هو صورة لما تعيشه الشخصيات، ونعيشُه نحن، من أليم المفارقات.
وفي تأثر واضح بأسلوب غي موباسان (1850-1893)، الذي عبّ مباشرةً من نصوصه، تميزت شخصيات تيمور بسيرها على حافة الجنون والتيه، وبرفضها للدروب المعبدة والنزوع إلى متاهاتٍ على تخوم العَتَهِ. حملت جلُّ شخصياته تمردًا واضحًا على التقاليد ومبادئ المجتمع، في ثورة هادئة عليها. كانت ثورةً مَحجوزة لا تنتهي إلى قلب النظام، بل سرعان ما تنهزم أمام سطوة المجتمع ومصالح الفاعلين فيه.
تلاعبت ريشة تيمور بذلك التمرد، حتى جعلت منه قيمة ثابتة تستجلب تعاطف القارئ. ما يبدو، في البداية، جنوحًا ضد قيم الجماعة يمسي، بالتدريج، نُشدانًا لقيم أخرى. وليس ثمةَ قيمةٌ أعلى من كثافة التشكيل القصصي للمفارقات.
فبسببٍ من إيجازها وكثافتها، تكفل الأقصوصة هذا التلاعب وتسمو به، ولا سيما إذا دَعمَها نمط تعبيريٌّ يُلين شِماسَ الضاد فيسبر به أعماقَ النفس المصرية (البشرية؟) متصرفًا في الحوار والسرد ضمن كونٍ يمكن أن نصطلح عليه، مع إبراهيم بن صالح، في أطروحته "القصة القصيرة"، (2008) "بالعالَم الأقصوصي"، المشيَّد على جِماع المصائر التي اختَطّها. ولكن هل كان تيمور واعيًا بهوية الجنس السردي الجديد، أي الأقصوصة، الذي يَكتب عبره؟
من دون أدنى شكٍّ. ولكنّ ذلك الوعي لم ينضج بالقدر الكافي الذي يسمح للمؤلّف أن يموتَ في نَصّه (والصورة لرولان بارت)، ويَتلاشى من خطابه. ظلّ محمود التاريخي حاضرًا بين الأسطر، يُوجِّه تيمورَ الكاتبَ، وحتى "الراوي"، ويَختلط بهما.
فبالرغم من اجتهاده في تأصيل جنس الأقصوصة، ظلّ عالم تيمور المتخيل يعاني من عائقيْن، لم يتحرر منهما تمامًا: فمن جهة أولى، حَملت كتاباتُه العديد من مظاهر الكلاسيكيّة، فتسللت عشراتُ العبارات البيانية، رَغم يَقظته، وانحدرت من نصوص التراث، وتناثرت طيَّ نصوصه التراكيب البالية والصور المتقادمة. لكنْ، من دون أن تكسر حيوية السرد أو تعطّل نماء الشخصيات. فكأنها جينات متوارثة هيمنت على النصّ من دون أن تكون المحدد الوحيد لهويته.
ومن جهة ثانية، تسرّبت إلى مُدونته نزعاتٌ رومانسيّة، لعله وَرثها من أستاذه المنفلوطي (1876-1924)، حيث تعيش سائر شخصياته تجارب عاطفية عارمة، يُصوّر انفعالاتها ويبالغ في رسم جَيَشانها بشيء من السذاجة والمثالية، قد تدهشان قارئ اليوم. ومع ذلك، تجنب تيمور التصوير الإباحي السهل، الذي بدأ يشيع وقتها، وإن باحتشامٍ، في كتابات بعض معاصريه.
تأصيل تيمور لجنس الأقصوصة لحظة فارقة في تاريخ السرد العربي. جسّدت مرحلة انتقال فعليّ من سجلات الإنشاء بأثقاله البلاغية إلى ابتكار أكوانٍ قصصية محدودة، قُوّتُها في تناهيها. تؤثِّر بما فيها من مقوّمات الحبكة التي تصنعها تقنيات السرد، وترتبط عميقًا بِبُنى المجتمع المصري المتحرّكة. لم تعكس أقاصيصُه الواقعَ، وليس ذلك من وظيفتها، بل أبنيتَه العميقةَ الجانحة إلى الانتقال. هكذا، وَشت أبنيةُ نصوصِه باندفاعة التاريخ وتعثراته.