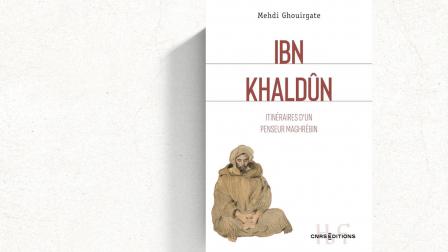ما الذي طرأ على الثقافة من متغيّرات، بعد عواصف "الربيع" المتخمة بالمظاهرات والثورات والانقلابات، وحروبٍ ما زالت مشتعلة، لا تخمد في منطقة من العالَم حتى تشتعل في أُخرى؟
تبقى الثقافة بين أخذٍ وردّ، تتحكّم فيها عوامل تبدو مجهولة، لا يمكن التعويل عليها في إطفاء الحرائق في العالم؛ لا ضمانة، طالما أنها كما تبدو لا أكثر من كلام جميل وتنظيرات في الفكر وشطحات في الفلسفة، لم تشكّل مؤثّراً في أحداث العالم، تركَت الكلام القبيح للسياسيين، هكذا يتغيّر العالم، طبعاً ليس نحو الأفضل. أما الثقافة طيبة النوايا، فلا تستطيع أن تفعل شيئاً.
فلنتكلم عن الثقافة في بلداننا، التي كانت محاصرة بمزاعم سياسية قومية ووطنية، تولاها سياسيون أصولهم عسكرية، تميزوا بأصوات عالية، طغت على الأصوات المخنوقة والمطاردة. لم تسترد الثقافة أدوارها المعوّل عليها، حتى بعدما ارتاحت من المزاعم الاشتراكية، ولم تكن إلا تعلات، فالشعارات المنددة بالبرجوازية الصغيرة والمتوسطة والعملاقة، اختفت من دون صراع الطبقي باختفاء الأيديولوجيات من الخريطة الثقافية، بعدما احتلتها زهاء أكثر من نصف قرن، وكانت في تراجع حثيث في العالم، بينما في بلادنا كانت تزهو متمترسة وراء موظفين محنكين توارثوا ثقافة أحزاب بائدة، حالت بينها وبين السقوط المبكر أقدار السياسات الانتهازية، رغم ما أصابها من نكسات.
الدول الشمولية لم ترحل، رغم حلول أجلها أكثر من مرّة
ليست السياسة قصة إنجاب ولا في أنها عاقر، وإنما لا سياسة ولا ثقافة، فالدول الشمولية لم ترحل، رغم حلول أجلها أكثر من مرة، بل استقرت إلى أمد غير معلوم. مع أنه لم يمض الكثير من الزمن على تساقط أمثالها الأشد صلابة مع انهيار جدار برلين، تداعت حطاماً كأنما انقلاب أتى عليها، كما يحدث في البلدان النامية والمتخلفة، حتى أن مريديها وأصدقاءها أداروا ظهورهم لها، لكن في بلادنا تجدّدت، باتت أعمارها طويلة، وكأنها لا تموت. ما رسخ دكتاتوريات فجة، تتعيّش على ثقافة مهلهلة، كانت في طريقها إلى الاندثار، عاشت مرحلة بطالة وعطالة، الخروج من محنتها ليس بالسهولة، بعدما استنقعت في الترهل زمناً طويلاً، تجتر نفسها في مؤسسات ثقافية متكلسة، كانت بحاجة للهواء، وكان الهواء محتجزاً لدى أنظمة لا تعتقد بالهواء، وتخشى من أي تغيير. فاستعيدت لرأب الصدع المسيرات والحشود الجماهيرية والخطابات المحرضة على النضال في وقت لم يعد هناك من نضال معتبر للأنظمة سوى سحق الشعوب، لم يطل الوقت، عندما استُثمرت بارتكاب الجرائم في عزّ الربيع.
لم تكن مجرد مصادفة انطلاقة الاحتجاجات في البلدان العربية، ومطالبتها بالحرية والعدالة من خلال مطلب الكرامة، التحق بها شبان الثقافة، ووضعت مثقفي النظام والأحزاب أمام تحدٍّ، ما جعلهم يترددون إزاء ما أصبح انتفاضة، ويتخاذلون عن ضم أصواتهم إلى المتظاهرين الذين باتوا يتمتعون بالحرية، ويخوضون على الأرض في ما كانوا يفتقرون إليه، وظفروا به.
حرية الشارع، حرية المظاهرات، حرية الاحتجاجات، كانت في خطر. بات القضاء عليها حالة مستعجلة بجميع أنواع الأسلحة، من الرصاص إلى المدافع، وإخفاء المتظاهرين المطالبين بها عن الأنظار، في السجون والقبور، فالحرية تجسدت تمشي على الأرض، لم تعد موضوعاً للغو به. باتت في دماء المتظاهرين، بينما أصبحت لدى السلطات مشبوهة بالمنظمات الإنسانية.
لماذا السياسة؟ ما علاقتها بالحرية والثقافة؟
تدور الثقافة مع دوران السياسة، فما تسمح به السياسة أو تمنعه، يعود على الثقافة بالسماح أو المنع. فلا ثقافة بلا سياسة والعكس صحيح. فإذا كانت الأولوية لطلب الحرية، فلأن الحرية إمساك بزمام السياسة.
لا ثقافة من دون الحرية، ولا يزدهر الأدب والفن من دونهما، والثقافة العامل الوحيد لاستحضارهما، وحدها تمنح صوتاً للضمير، ولا تتعامى عن واقع سيواصل انحداره إن تُرك لآلية الطغيان، ولن يكون سوى فساد يشارك فيه المثقفون، وارتداد الثقافة إلى سيرتها، متكلسة خانعة مسلوبة الإرادة.
تتلازم السياسة مع الثقافة، إن لم تتحرر السياسة، لن تتحرر الثقافة.
* روائي من سورية