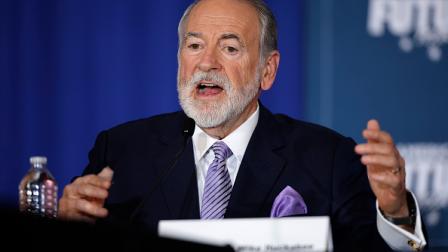نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (في 17 مارس/ آذار)، مع ما رافقها من اصطفافات في اليمين من جهة، وتحالفات ربطت بين حزب العمل التاريخي وبين سليلة الليكود تسيبي ليفني في قائمة جديدة أكدت على القاسم الصهيوني المشترك من جهة ثانية، أثبتت حجم ونطاق التحول الإسرائيلي نحو اليمين. تحول ليس فقط بفعل العامل الديموغرافي، وإنما أيضاً في القرار السياسي الذي مثله تشكيل "المعسكر الصهيوني"، وفي الخطاب الصهيوني الجامع لإقصاء فلسطينيي الداخل من أي تشكيل حكومي أو تحالف ائتلاف سياسي ولو مؤقت أو حتى من خارج الائتلاف الحكومي.
وتمثل هذه التحولات في الخطاب والممارسة والتصريح، تجسيداً للروح الإسرائيلية، التي لا تزال تتمسك بثوابت الصهيونية وشعارها التاريخي (الذي حملته الحركة العمالية ردحاً من الزمن)، والمتمثل في أكبر متسع من الأرض مع أقل عدد من العرب.
اقرأ أيضاً: يوم الأرض وبيتها: ما قاله آذار في العائدين
ولا تزال هذه المعادلة هي المعادلة الأساسية في تعامل إسرائيل بأحزابها مع الفلسطينيين في الداخل، بعد أن تمكن الاحتلال، منذ النكبة وحتى اليوم، من وضع يده، عبر سلسلة قوانين وإجراءات إدارية مختلفة، على 96.4 في المئة من الأرض الفلسطينية التاريخية في حدود فلسطين ما قبل النكبة ليبقي بأيدي الفلسطينيين أقل من 3.6 في المئة، يطمح إلى سلخ ما تبقى منها، ولا سيما في النقب عبر مخطط برافر. والأخير عبارة عن مخطط حكومي يسعى لسلب نحو مليون ومئتي ألف دونم من أيدي الفلسطينيين في النقب، تدعي إسرائيل أنها أرض متنازع عليها، وأن الفلسطينيين لا يملكون أدلة بامتلاكها.
وتسعى إسرائيل عبر المخطط، الذي أُفشل في العامين الماضيين، وتحديداً عبر سلسلة تظاهرات ومواجهات عنيفة في الجليل والمثلث والنقب عام 2014، إلى ترحيل نحو 40 ألف فلسطيني يعيشون في النقب في أكثر من 30 قرية قائمة قبل النكبة، ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها لاقتلاع أهلها واستغلال الأرض لتطوير النقب.
وعلى الرغم من حصول القائمة المشتركة للأحزاب العربية فضلاً عن الجبهة الديمقراطية (وهي حزب يهودي عربي عماده الحزب الشيوعي الإسرائيلي)، على 13 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه سيكون من غير الواقعي الاعتقاد بأن القائمة ستكون، في حال عوّلت فقط على نشاط برلماني، قادرة على منع تمرير مخطط اقتلاعي جديد بالأدوات البرلمانية، لأنها ستواجه عندها، في أي مشروع تقدمه، معارضة أغلبية تلقائية للأحزاب الصهيونية في الكنيست، ما لم ترفد مشاريعها ومخططاتها بنشاط شعبي جماهيري.
ومن الواضح أن الفلسطينيين في الداخل، سيواجهون بعد تشكيل الحكومة المقبلة، حملة تشريعات عنصرية تختص أيضاً بالأرض، تحول دون إعادة أراضٍ صودرت منهم، أو حتى حصولهم على أراضٍ جديدة من تلك التي صادرتها الدولة وحولتها إلى أراضي دولة. تُضاف إلى ذلك مخططات جديدة لإقامة مشاريع قُطرية بالذات على ما تبقى من أراض عربية، وهو تقليد لجأت إليه إسرائيل بشكل خاص بعد يوم الأرض الأول. كما هو الحال عندما شقت أطول طريق سريع على امتدادها من النقب وحتى الجليل على الأراضي العربية بشكل خاص. وهناك مخططات مستمرة لتوسيع وإقامة سكك حديدية تمر وتأكل جزءاً كبيراً من الأراضي المتبقية للعرب.
وفيما يجد الفلسطينيون في الداخل أنفسهم قد باتوا محاصرين في بلداتهم وقراهم بمناطق "عسكرية" أو حدائق ومتنزهات قومية، أو محميات طبيعية، فإن ولاية الحكومة الجديدة، وفي حال تم تسليم وزارة "تطوير الجليل والنقب" لأفيغدور ليبرمان، تحمل نذر حرب شعواء على ما تبقى من أرض ولا سيما في النقب. ويُضاف إلى ذلك زرع الجليل بمزيد من المستوطنات اليهودية، ولا سيما بعد إقرار قانون "لجان القبول" الذي يتيح للمستوطنات الجديدة عدم قبول أسر عربية تحت ذريعة "الخصوصية الثقافية".
تبقى الأرض في الذكرى التاسعة والثلاثين ليوم الأرض، محور الصراع مع إسرائيل، ليس فقط في الداخل، فالحكومة الجديدة، في حال كان زعيم البيت اليهودي، نفتالي بينيت، أحد أقطابها تحمل مشاريع جديدة أهمها إعلان الأخير عزمه السعي لسنّ قانون ينص على ضم المنطقة "سي" في الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها (على الأرض من دون السكان)، ما يعني استيلائها على 61 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وتبدو إسرائيل، خلافاً للعرب، متمسكة بمبدأ أساسي أن من يملك الأرض يملك السيطرة عليها براً وجواً، ويملك مقاليد التطور والبناء الاقتصادي، وهي مفاتيح الوجود في صراع تعتبره إسرائيل صراع وجود بينما بات العرب يرون فيه صراع حدود.
وفي مقابل "بخل إسرائيل"، وحرصها ولو إعلامياً على التشبّث بكل شبر و"بؤرة "استيطانية يصنفها القانون الإسرائيلي نفسه على أنها غير قانونية، يبدي العرب كرماً في الموافقة الضمنية على بقاء مسامير جحا الإسرائيلية على كبرها ككتل استيطانية في الضفة الغربية ضمن أي تسوية مقبلة.
اقرأ أيضاً: عشية آذار: استعادة يوم الأرض