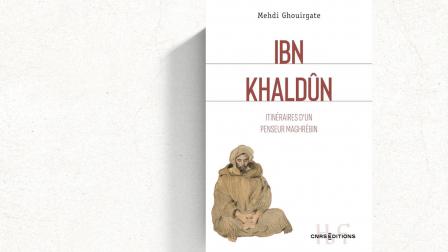كان مقهى ريش ممتلئاً، كعادته، بالكتّاب والمثقفين حين تفاجؤوا بعلي سالم يدخل عليهم بصحبة صديقه السفير الإسرائيلي. وبالرغم من اختلاف توجهاتهم الفكرية ومشاربهم؛ فقد وقف رواد المقهى جميعاً ثائرين على هذه الزيارة الوقحة التي حسمها مجدي ميخائيل صاحب المقهى ومديره بطرد سالم ورفيقه إلى غير رجعة.
لم تكن مقاطعة المثقفين له مذ زار إسرائيل عام 1994، مجرّد تمسّك بالمواقف الوطنية؛ فقد كان سالم رمزاً للفجاجة لدرجة أنه كان ينعت نظام مبارك، الكنز الإستراتيجي لإسرائيل؛ بأنه عدو للسلام، ويصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب!
كان نفور المثقفين منه دليلاً على "تفرّده"، وقد كان له ما أراد من شهرة، كالأعرابي الذي أراد أن يرتفع ذكره بين الناس؛ فبال في بئر زمزم. فعلى كثرة أولئك الذين ينكرون الحقوق التاريخية والجغرافية؛ كان علي سالم نسيجَ وَحْدِه.
فقد صدع بالباطل وحده بجسارة يُحْسَد عليها، ولم يخش في "الشيطان" لومة لائم؛ حين فتح أحضانه مبكراً وبوضوح للكيان الصهيوني متغافلاً عن جرائمه التي لا تنقطع، معلناً أنه لا يراه عدوّاً يهدد الأمن القومي المصري، ومؤكداً أن عصر العداء مع تل أبيب ولّى إلى غير رجعة.
بدأت حماسته التطبيعية بعد رحلة السادات إلى الكيان الصهيوني، لكن زيارته الأولى إلى إسرائيل تأخرت حتى عام 1994، وهي التي دوّنها في كتابه "رحلة إلى إسرائيل". ومن يومها صار صديقاً حميماً وضيفاً دائماً على موائد الصهاينة، حتى بلغت "زياراته" إلى إسرائيل 15 رحلة!
لم يُجر سالم حواراً إلا وصدّر فكرة اضطهاده بوصفه "مثقفاً حرّاً"، وجهاده في سبيل قناعاته، وهو يحكي أن صديقاً قديماً له أخبره بأنه حضر اجتماعاً تقرّر فيه تصفية علي سالم فنياً وثقافياً وأدبياً واجتماعياً إذا ذهب إلى إسرائيل.
وهو ينتقد ذلك بتعال مصفّح بالادعاء قائلاً: "شعرت بالقرف.. عقول تربّت على التصفية. إما أن يقوموا بتصفية مخالفيهم في الرأي بوصفهم أعداء، وإما أن يقوم أعداؤهم بتصفيتهم، وهي عقول جبانة لا تتصوّر أن بعض البشر لا يخافون التهديد والوعيد، بل يزيدهم الابتزاز إصراراً على التمسك بممارسة حرّيتهم في التفكير والفعل".
لكننا لا نصادف "المثقف الحرّ" وهو يشير، ولو لمرة واحدة، إلى سياسة التصفية التي ينتهجها أصدقاؤه بحق الشعب الفلسطيني، بل إنه ينعت المقاومة كلما سنحت له الفرصة بالإرهاب. وبين الحين والحين، كان يحاول أن يبرر موقفه اللاأخلاقي باعتباره البديل الطبيعي لنقيضه، أي عسكرة المنطقة في الحقبة الناصرية، وانتزاع حقوق الإنسان من الشارع العربي، وجرّ الويلات على الشعوب من أجل شعارات زائفة وزعامات هشة.
يمتطي "كولمبوس" سيارته النيفا الروسية، عابراً الحدود مستكشفاً إسرائيل، كأنه لا يعرفها، يقول: "عقب اتفاقية أوسلو 1993 مباشرة، أعلنت أنني أفكر في زيارة إسرائيل بسيارتي لتأليف كتاب يجيب عن سؤالين: من هؤلاء القوم؟ وماذا يفعلون؟".
في تلك الأثناء، يتوه المغامر في شوارع القاهرة التي يحفظها جيداً، ويفسّر ذلك بأن صراعاً داخلياً بين الوعي الذي يؤيد الرحلة واللاوعي التي يرفضها بفضل تراث ثقيل من الكراهية والعداوة. لكنه يعود، فيصف رحلته بأنها ليست رحلة حب، بل هي محاولة للتخلص من الكراهية. وبمناسبة الكراهية، فإنه يؤكد أنها صناعة محلية. فبعد العطف الذي وجده هناك، ينقل إلى القارئ الود الصهيوني الذي حظي به قائلاً: "أعتقد أن أي شعب بحاجة إلى أكبر كمية من الشر ليكره المصريين".
بدأ انبهاره بإسرائيل، قبل أن يدخلها. فمنذ ولجَ باب سفارتها للحصول على التأشيرة التي لم تستغرق مدة استخراجها عشر دقائق؛ أعجبته لياقة موظفيها، وسرعة إنجازهم، إضافة إلى لطف السفير الذي طلب منه أن يجلس معه بعد عودته لمدة خمس دقائق.
بدأت الرحلة في 7 نيسان/ أبريل 1994، بعد أن عبر الحدود وقطع مسافات طويلة، حتى بلغ مستعمرة نتانيا، تلك "المدينة" التي عشقها قبل أن يراها، وتحديداً منذ قرأ عبارة قديمة لأحد الكتّاب الذين زاروها، تقول: "وعلى شاطئ نتانيا الجميل وجدت شرطية حسناء بملابس الاستحمام تضع مسدساً حول خصرها".
يروج سالم لتربية الأطفال الاستقلالية في إسرائيل، وكيف أنه صادف بعض الأطفال في إشارات المرور يروجون لملصقات كتب عليها "مع الجولان"، بمعنى بقاء الجنود الإسرائيليين بها، وكيف أنهم كانوا يتقبلون برحابة صدر رفض بعض أصحاب السيارات للملصقات ويتجاوزونهم إلى غيرهم ممن يوافق.
يقول: "هذا هو ما يجب أن نركز عليه في تربية أطفالنا، من حق البشر أن تكون لهم آراء وأفكار مختلفة عما نعتقده نحن، دون أن يكون ذلك مدعاة للعنف، ولتتصارع الأفكار مع الأفكار، والحجة مع الحجة من أجل صالح الأمة".
ويسترسل في وصف "حرية التظاهر في إسرائيل"، بل والإضراب أيضاً، وكيف أن الأفكار (هناك) ليست محبوسة في مكاتب الأحزاب وأعمدة الصحف، وأنك ستراها وقد تحولت إلى لافتات يحملها الشباب على نواصي الشوارع.
ما يمتدحه بشدة في "إسرائيل"، يناقض غزله بالنظام المصري الحاكم الذي يزج بآلاف الشباب في السجون بجريمة التظاهر. فمن حق "الشباب الإسرائيلي" أن يتظاهر، أما شبابنا فلا يستحق سوى القبور والمعتقلات.
في كل خطوة من خطواته داخل إسرائيل، يطلعنا سالم على إيجابيات: لطف الإسرائيليين البالغ في استضافته، سعة ثقافتهم، حبهم للسلام، روعة الطرق وانسيابية المرور حتى لو كان هناك تفجير إرهابي، تواضع الناس وعدم امتلاكهم لسيارات فارهة. كل شيء في إسرائيل كان جميلاً؛ الذكاء والجمال والدقة، حتى وجبة الإفطار الإسرائيلي تستحق الغزل.
ولكن عندما مرّ سالم على بلدة أم الفحم العربية، لم يتمالك نفسه في انتقاد رئيس بلديتها الذي اتخذ من إبريق الوضوء شعاراً للبلدة. وقد وصف رئيس البلدية المتديّن بأنه خلط بين اختصاصاته واختصاصات إمام القرية؛ واتهمه بأنه ضيّع وقته وجزءاً كبيراً من الميزانية في تأهيل أهل البلدة للتعامل مع الآخرة، تاركاً الاهتمام بهذه الحياة الدنيا للآخرين من رؤساء بلديات المدن الكافرة.
ويبدو أن عقدة النقص أنسته أن الدولة التي يمتدح أهلها أقيمت على أساس ديني عنصري، وأن الاسم المختار للكيان الصهيوني (إسرائيل) كفيل بفهم تلك الإحالة. بينما هو يتذكر خلط الدين بالدنيا فقط حين يتعلق الأمر بالعرب.
أيضاً، نراه لا يفوت الفرصة في تبرير هجرة اليهود العرب إلى فلسطين المحتلة، حين يذكر قصة عبدالله ربيع العراقي اليهودي الذي كان يخرج في مظاهرات في بغداد هاتفاً ضد الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، فيسمع من خلفه هتافاً عربياً يقول "الموت لليهود"، فينتبه إلى أن الشعار يعني ألفاظه بدقة، فيقرّر الهجرة إلى إسرائيل خوفاً من الموت.
أما الأخلاق العبرية وتجاوزاتها، فقد تعرّض لها على استحياء أثناء انتقاده لبعض قرارات الحكومة الإسرائيلية التي تتعلق بعزل الفلسطينيين، بحجة أن ذلك يدفعهم إلى الإرهاب. فيقول: "إن استبعاد القيمة الأخلاقية في السياسة خطأ سياسي باهظ، وفاتورته المرتفعة سيدفعها المجتمع حتماً وإن تأخرت لسنوات". وقد استدرك بأن هذا ما حاول "المفكرون الإسرائيليون" التنبيه إليه منذ سنوات طويلة.
اختار علي سالم، الذي ولد عام 1936، أن يكون طالباً فاشلاً في مدرسة التطبيع، فكانت أقصى أمنياته أن يفتخر بأن بعضهم يقوم بتدريس مسرحيته "إنت اللي قتلت الوحش" في "الجامعة العبرية" في القدس، كما أنه حاول أن يعرض هناك مسرحيته "كاتب في شهر عسل"، ولم يوفق. بعد ذلك توّج "المناضل التطبيعي" بدكتوراه فخرية من جامعة بن غوريون سنة 2005، إضافة إلى حصوله على جائزة "الشجاعة المدنية" سنة 2008 من مؤسسة تراين الأميركية.
قضى علي سالم نحبه أول أمس، عن عمر يناهز 79 عاماً، ونعتقد أن إسرائيل لم تكن لتقصّر مع الرجل، لو أنه أوصى بأن يدفن في مقبرة "كريات شاؤول" في تل أبيب.
اقرأ أيضاً: تطبيع كوكب الشرق