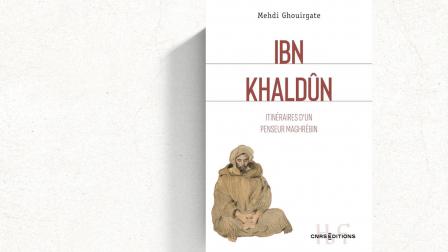حين كنتُ أَكْبَر، كان بيتنا غرفة واحدة مُستطيلة ومطبخاً صغيراً إلى يسارها. إلى يمين المدخل كنبة مُلفّقة عبارة عن وسائد محشوّة بسجاجيد قديمة صُفّت بإحكام فوق هيكل خشبي. كان بيتاً متواضعاً يقتصر على الأساسيات لا غير، لكنه دائماً نظيف جداً، تدرك بمجرّد دخولك أنّ سيدة المنزل ربة بيت ماهرة. فكل شيء في مكانه، ولا شيء زائدا عن الحاجة يَعْلَق بأي سطح.
كان سرير أبويَّ هو الاستثناء الوحيد. يقف في الطرف الأيمن من البيت وقد تدلّى على أربعة أعمدة متينة من حوله حرير ذو نسيج مُعقّد ينساب حتى الأرضية. له فرش يرتفع ثلاثة أقدام كاملة وكأنه يصبو إلى فضاء سماوي من الوَجْد. امرأتان فقط نامتا على هذا السرير: دافني والثانية.
أولى ذكرياتي الواضحة عن أمي تعود إلى وقت كنتُ في الرابعة. هي كانت بالكاد في التاسعة عشرة، حبلى بأخي. كنا في أواخر الأصيل على حافة الشتاء والريح تعصف في الخارج. وكنت أشعر بالأرض الخلاء المحيطة بفنائنا تتشكّل من جديد حيث أشجار الزيتون المتناثرة تنحني أمام السِحر الخام للنسيم القوي فيما سُحُب الغبار تتكوّن من فوق، تتكاثف ثم تَمُر.
أسمع الثيران تخور مُستغيثَةً وأعرف أن أبي الشجاع وسطها يَسدّ الفجوات التي يتسرّب منها الهواء إلى الإسطبل في محاولة محمومة لتهدئة الحيوانات خوفاً من أن تكسر الأبواب وتعدو مُنطلِقة مع العاصفة. داخل البيت كانت تلهث محدّقة عبر الشباك تبحث عنه بعينيها. إلى أنْ طار كأس صفيحٍ كان مَنسِيّاً على المقعد في الخارج واصطدم بباب البيت بقوة دفعتها إلى الخلف حتى كادت تفقد توازنها وتسقط. ولعل فكرة إيذاء الطفل الذي بداخلها أعادتها إلى رشدها، فقد جلستْ وتنفّست بعمق مُغمِضةً عينيها. بَقِيتْ هناك مدة بينما أنا أتعجّب كم تبدو أمي متماسكة وشجاعة وصغيرة السن.
أمي المراهقة التي احتقرها أهلها حين وقعتْ في غرام أبي وهو يكبرها بعشر سنين، المعروف في قريتهم بكَدِّه وكبريائه. كانت بالكاد في الخامسة عشرة يوم هربا وسعيا لصوغ حياة خاصة بهما على قطعة أرض كان أبي قد ورثها من عَمّة له لم تُنجب.
لقد أحبّها بكل فِلذَة في جسده الذي قسّته الشمس وتاق لأن يكون معها. لكن حِسّ الواجب لديه دائماً ما كان أقوى من الرغبة. ومن ثَمّ كان يتركها وحدها بالساعات حتى يَحرث الحقل ويزرع البذور ثم يرويها، حتى يَجني الغلّة ويَفصل القمح عن الشعير، حتى يضع أمله في قوى أعوص من فهمه. كنا نعيش أساساً على الخبز والبيض والخضروات المزروعة في بيتنا، ومرة في الشهر نضحّي بإحدى دجاجات الفناء الخلفي ونتلذّذ بالدجاج المشوي وشوربة الليمون. كانت دائماً وجبة جيدة وكانت تنبئ بأيام أحلى.
لدقيقتين أو ثلاث بدا أن الريح كظمت القسم الأكبر من غيظها، حيث خفت الضجيج المحيط ببيتنا حتى بات أشبه بالحفيف. وكنت أَهمّ بملامستها لألفت انتباهها إلى أن العاصفة هُزمت على الأرجح حين انبجس الهواء عن دَوِيّ مفاجئ يعوي وينبح ويَرعد فيستحضر صوراً لأشجار تفقد لحاءها وزجاج يتشظى، لمجارف ومقصات ومناجل تطير فوق رؤوسنا ولا شيء يقينا من غضبة الطبيعة سوى صفّ من عوارض خشبية مربوطة بحبال.
لم تمر ثوانٍ حتى انسكب في بيتنا الضوء عبر الشباك، تتبعه دمدمة الرعد، فأجفلت من كرسيها تبارز الهواء بكفين مفرودتين وكأنما لتصرع تجَسُّد العاصفة الذي زَحَف إلى الداخل ثم ضغطت صدغيها بيديها كليهما قبل أن تُطلِق آهة هي أول عهدي بالعجز الذي تَشعر به حين تُهلكك العناصر الأربعة وأنت لا تراها.
وقفتُ مرعوبة وركبتاي تتألمان تحت ثقل الشلل الذي أصابهما. وكانت تَذرَع الغرفة النحيلة بهِمّة تتضاءل شيئاً فشيئاً حتى أصبحت خطواتها بطيئة ثم أبطأ، تلك المرأة الطفلة التي ليست لديها فكرة كيف تُبعد الأذى عن نفسها وعن جنينها.
كانت تعتمد عليه في كل شيء، وهكذا فعلت الآن وجسدها يُجمّده الخوف، وعقلها مُدَرّب على اتباع أوامره من قلبها. تسمّرت وأنا أراها تنهار على سريرهما بحركة محسوبة لتعود إلى وعيها خلال ثوان قليلة بين ذراعيه. كان يجب أن أعلم أن حبها له سيباريه دائماً حنقها على كل ما انتزعه منها. بعد أسبوع ولدت أخي عبر مخاض سريع يكاد يكون سهلاً.
وخلال العقدين التاليين، أنجب أبواي خمسة أطفال إضافيين. وفي غضون ذلك كانت مزرعتنا قد كبرت حجماً ومحصولاً. لم يعد البيت كوخاً منبوذاً في الخلاء، فقد بنى أهل القرى المجاورة بيوتاً لهم وأنجبوا أطفالاً على مسافات أقرب إلينا. في مرحلة ما أضاف أبي طابقاً ثانياً ليكون غرفة نوم له ولأمي وأفسح الدور الأرضي لعِزوته النامية. وفي ما بعد قسّم الطرف البعيد من البيت بحائط واطئ ليفصل الذكور عن الإناث.
أثناء بلوغها مرحلة النضج، بالتدريج، اكتسبت ما يكفي من الثقة بالنفس لتبادر، وكان أهم ما بادرت به أن تُدخِل إخوتي المدرسة وإن كان إلى الصف الرابع أو الخامس. فالمزرعة في حاجة إلى أكبر عدد ممكن من الأيدي لتزدهر.
أنا لم أذهب إلى المدرسة أبداً، لكنني علّمت نفسي القراءة والكتابة عبر دأبي على مشاهدة الصغار وهم يقومون بواجباتهم المدرسية، والحقيقة أن بعضهم كان فخوراً بمساعدتي. كانت تعلم بما أفعله ولم تحاول أن تمنعني، فأنا قبل كل شيء مُساعِدَتُها الغالية، صنوتها الراضية المُقتَصِدَة. إلى أن ظهرت دافني، قبل أن أبلغ الخامسة والعشرين بأيام.
كان أكبر إخوتي يعمل سائقاً لدى المرفّهين منذ عمر الثامنة عشرة. لم يكن يحب المزرعة. كان يختفي أياماً ثم يعود ليقضي معنا ليلة أو اثنتين قبل أن ينطلق من جديد إلى عالمه الحديث. إلى أن جلب هذه الفتاة معه يوم الإثنين وقال إنهما خطيبان يستعدان للزواج.
كانت رفيعة ذات صوت حنون، ولعينيها طعم الخبز الساخن الذي يحل على لسانك فيرفض المغادرة. كان اسمها هو الغار الذي يكلّل الفائزين، شجر الغار الذي ينمو في فنائنا، أوراق الشجر التي تضفي على حسائنا نكهة لكنْ تترك فمنا يشعر بالمرارة كلما قضمناها.
وافق أبي أن يعيشا معنا شهرين حتى يدّخرا ما يكفي لاستئجار سكن. ولعله رأى في دافني شيئاً من أمي، بقايا من الحب الذي أحسته تجاهه ذات يوم. وهكذا صنع سريراً جديداً له ولزوجته بيديه، سريراً بسيطاً من الخشب لشخصين وضعه في غرفة الخزين الصغيرة خلف الإسطبل وتخلّى عن سرير الزوجية لابنه الأكبر وعروسه. عروسه التي ستكون.
إلى اليوم تُعذّبني صورتها، أن أَذكُر كم كان طريّاً وأبيضَ جسدها وهو ينزلق على جسدي، أو منبع شعرها الكستنائي وهو يصبّ في صدري، أو نَفَسُها المُعَطّر يتريث فوق سُرّتي وأنا أرتجف من الذهول. تكررت الليالي التي دعتني فيها إلى الليل، وكان غياب أخي يقرّبها مني كل مرة.
لكنّ هناك ليالي أخرى أيضاً في غياب أبي حين يكون لا أثر لها. كنت أستشعر روحها تسعى مبتعدة عنا جميعاً أثناء العشاء. عيناها مُسلّطتان بعناد على طبقها، وذراعاها على جانبيها في أمان وهي حريصة على ألا تلمس شيئاً أو أحداً حولها. في تلك الليالي كانت تختفي، وكان البيت كله يختفي معها: الحيطان والأرضية والفرش والأثاث.
كنت أتخيلها تجول في الخارج وقميص نومها المُخرّم كالشراع المنتفخ من حولها. تدلّها قدماها إلى بحر لا وجود له، تُغَطّسها في برد الليل ثم تدعها تنبثق من الأعماق وشعرها يقطر والخطوط العريضة لجسدها - سلويت بالأبيض والأسود - ظاهرة من خلال القميص. في الصباح كنت أجدها في كامل ملابسها وانتعاشها، تدفّئ حليباً وتسلق بيضاً للصغار. لم أسأل أبداً. ولا مرة سألت.
فقط ظللت أعيش في محيطها، أريح عيني برؤيتها. أتعلم أن أحب نفسي لأنها تعطّفت فكلمتني، وأن أحب جسدي لأنها تستمتع به.
حتى صحوت ذات يوم لأجدها قد راحتْ. ولا أثر لما حدث لها سوى تلك النظرة الخاوية التي تبادلها أخي مع أمي وأنا أسأل عنها.
في البداية حملوا الخوف مسؤولية ما أصابني. أنْ يختفي شخص من وسطنا دون أن يكون أحد رأى أو سمع عنه شيئاً، ظنّوا أن هذا هو الذي خَبَلني. فبدأوا يطمئنوني بأن البنات المهذبات ليس لديهن ما يرتعبن منه. إنني آمِنَة تماماً بِعِفّتي وأدبي وبالتأكيد سيأتي رجل لطيف ومحترم ليطلب يدي للزواج ذات يوم. وقبل أن أغوص في اللامبالاة ببضعة أيام، أعلنتْ أمي لنا جميعاً أن دافني لم يكن لها وجود من الأصل. مَن ظننا أننا نراه يجوب أرجاء البيت لم يكن سوى أضغاث هلوسات يُسبّبها الفِكر المَكّار الشهواني.
كانت فكرة أنها جاءت من لا شيء فقط لتأخذني مُعَزّية ومُفزعة بالقدر نفسه. لم أستطع أن أُفاضِل بين الجانبين.
ونحن جالسون حول المائدة، وسط الغداء، كنت أتصلّب من رأسي حتى أصابع قدمي ثم أُفيق بعد بضع ثوانٍ على نظراتهم المُستهجِنة. لكن في أسابيع قليلة باتت نوبات فقدان الوعي هذه أطول فأطول. وخلال شهر كنت قد زهدت الحياة بالكامل وقصرت نفسي على السرير في كل ساعات النهار والليل. حتى اضطُرّت أمي أن تلف قماشاً قطنياً حول حوضي وتضع القليل الذي أقوى على بلعه الماء والطعام بالملعقة في فمي. ليس لدي أي ذكرى عن هذه الأشهر الثمانية.
■ ■ ■
"وجدناها! ها هي، وجدناها!"
أختي في الثالثة عشرة وقتذاك تُطلِق صوتاً تُلوّنه الحماسة والفزع وسط صياح وبكاء الإخوة الأصغر. جاهدت لأنهض حتى زحفت إلى الخارج في الضوء. كنا في سبتمبر/ أيلول شهر الحصاد، وسماء ممزّقة تنعكس على عُدّة أبي: غيمة على فأسه، قطعة سماء زرقاء على المجرفة، مساحة رصاصية محروثة على المذراة.
كانت دافني مُلقاة على الأرض، متآكلة ومكشوفة، وليس سوى شعرها دليلاً على كم كانت جميلة ذات يوم. أبي المكسور مُنحنٍ فوق جسدها الذي أكله الدود وقد ظَلَّل عينيه بِكَفّ وغطى ثقوب وجهها بالكف الأخرى، ينتفض كقمح فاسد تذروه الريح.
ووقفت أمي جانباً تنتظر مرور العاصفة بصبر ويداها مطبقتان بأناقة فوق بطنها. وكان عليها سمت الفخر، وكأنها استوعبت للتو أنها منحت زوجها سبعة أطفال ولكنها لم تدعه يرى جسدها عارياً أبداً.
* كاتبة مسرح قبرصية حازت درجة البكالوريوس في الترجمة من الجامعة الأيونية في اليونان ودرجة الماجستير في الأدب المقارَن والدراسات الثقافية من جامعة قبرص، وتعمل مترجمة بين اليونانية والإنكليزية والفرنسية.
** ترجمة يوسف رخا