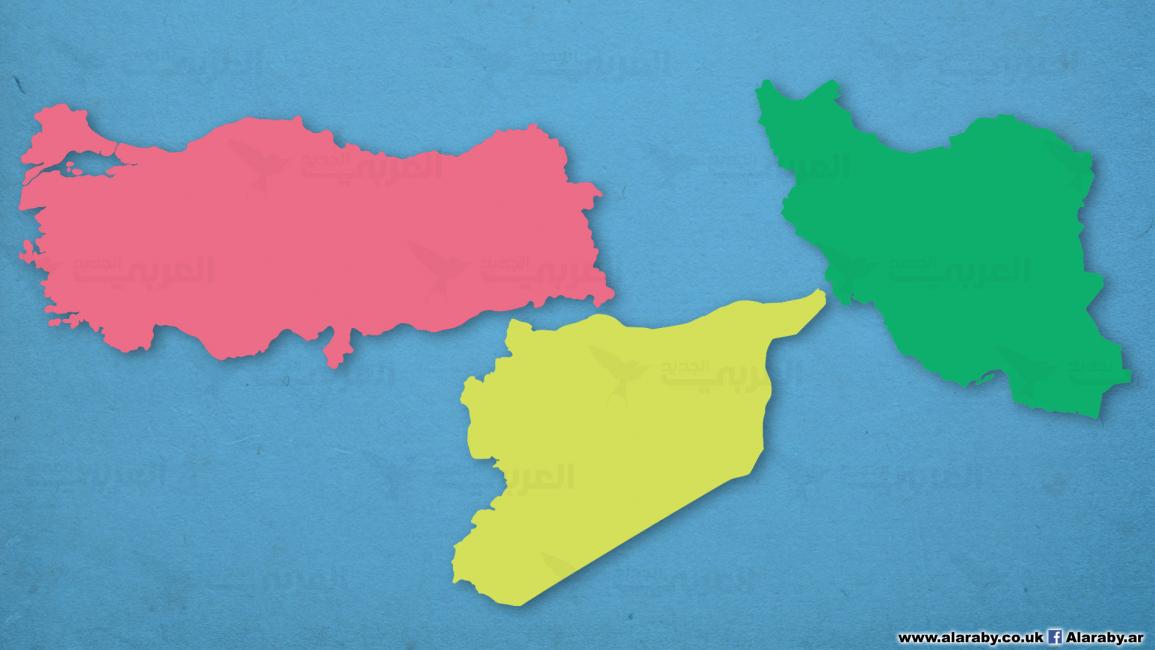عن مثلث سورية- تركيا- إيران
كلما تمعّن المرء في علاقات سورية الخارجية منذ الاستقلال وجد فيها ما يثير الدهشة والاهتمام. من ذلك مثلا أن سورية تكسر القاعدة الذهبية في السياسة الدولية عن عدم وجود تحالفات دائمة أو عداوات مقيمة، كما تؤكدها في الوقت نفسه. فمن جهةٍ، يرتبط النظام السوري بنظيره الإيراني بأحد أقوى تحالفات منطقة الشرق الأوسط وأكثرها استمراراً، رغم الفوارق الكبيرة التي تميّز نظامي البلدين (قومي عربي علماني في دمشق، هكذا يقدّم نفسَه في الخطاب أقلّه، يقابله نظام قومي فارسي ديني في طهران). من جهة أخرى، ترتبط سورية بتركيا بإحدى أكثر العلاقات اضطراباً وتقلّباً في الشرق الأوسط، رغم أن البناء الاجتماعي والتكوين الثقافي للدولة العميقة في البلدين يحيل إلى المدرسة القومية العلمانية ذاتها (قد تكون هذه الظاهرة من المفارقات الشائعة في الممارسة السياسية، حيث يكون التنافر على أشدّه بين أبناء المدرسة الفكرية والأيديولوجية الواحدة مقارنة بالمختلف منها). تثير العلاقتان، في هذه المرحلة، الكثير من اللغط والاهتمام، حيث تظهر مؤشّرات على تراجع في علاقة دمشق بطهران، من دون أن تصل إلى مرحلة فك التحالف، في مقابل تحسّن في علاقات دمشق بأنقرة، من دون أن تصل بالضرورة إلى مرحلة التعاون.
منذ اتفاقية لوزان عام 1923، والعلاقات بين نخب الحكم في دمشق وأنقرة تنوس بين الصراع والتعايش، ووصلت، في أحيان قليلة، إلى التعاون والتناغم. تمحورت الخلافات في البدايات بين الكيان السوري الناشئ والدولة التركية الحديثة حول ترسيم الحدود، حيث سلخت اتفاقية لوزان أقاليم عديدة كانت تتبع تاريخيا لولاية حلب العثمانية وتقطنها غالبية عربية وألحقتها بتركيا، ووصلت الخلافات إلى ذروتها بضمّ لواء إسكندرون عام 1938. بعد استقلال سورية، شهدت العلاقات مع تركيا أول أزمة كبرى عام 1957، حين اختار البلدان معسكريْن متعارضيْن خلال الحرب الباردة، واحتميا بهما. مع سقوط الاتحاد السوفييتي، فقدت سورية حليفها الأكبر على الساحة الدولية، واضطرّتها تركيا في أزمة 1998 إلى الاستسلام كليّاً أمام مطالبها، فتخلّت دمشق عن دعم حزب العمّال الكردستاني، وطردت زعيمه عبد الله أوجلان، كما أسقطت مطالبتها بلواء إسكندرون، وحصّة أكبر في مياه الفرات، وسمحت فوق ذلك لتركيا باختراق أراضيها بعمق خمسة كيلومترات لمطاردة عناصر حزب العمّال بموجب اتفاقية أضنة لعام 1999. على الأثر، تحسّنت علاقات دمشق بأنقرة التي باركت بدورها توريث السلطة في سورية من خلال مشاركة الرئيس أحمد نجدت سيزر في مراسم دفن الرئيس حافظ الأسد في يونيو/ حزيران 2000.
مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، وتحوّل اهتمام تركيا معه إلى المنطقة العربية، ورفض البرلمان التركي منح إذن للولايات المتحدة باستخدام أراضيه لغزو العراق، وتخوّف النظام السوري من أن يصبح هدفا تاليا في الحرب الأميركية على الإرهاب، حصل تقاربٌ كبيرٌ في علاقة سورية بتركيا، بلغ ذروته بقيام الأخيرة بدور مهم في تخفيف عزلة النظام السوري بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005، والتوسّط في مفاوضات السلام بين سورية وإسرائيل، عقب حرب تموز (2006)، وفشل مؤتمر أنابوليس للسلام في العام التالي، وصولاً إلى توقيع اتفاقية للتجارة الحرّة، وتشكيل مجلس وزاري على المستوى الاستراتيجي بين البلدين عام 2009، كما بلغت العلاقات الشخصية بين أردوغان والأسد مستوىً أثار قلقا في طهران.
ولكن التقارب السوري - التركي الذي ميّز العقد الأول من القرن 21 لم يستمرّ طويلاً، بفعل المتغيرات التي فجرتها ثورات الربيع العربي مع بداية العقد التالي، إذ سارعت تركيا وإيران الى الاستثمار في الثورات العربية لتعزيز نفوذ كل منهما، فاختارت تركيا دعم المعارضة السورية أملاً في إحداث تغيير لمصلحتها في دمشق، فيما سارعت إيران إلى استغلال حاجة النظام إليها لإلحاق سورية كليا بمشروعها الاقليمي. بعد عشر سنوات من الصراع، لا تركيا تمكّنت من تحقيق هدفها، ولا إيران نجحت في إلحاق سورية بها نتيجة مقاومة إقليمية ودولية شديدة لمشاريع الطرفين، لتبدأ مرحلة جديدة من المراجعات والتقلبات التي لن تذهب، على الأرجح، أبعد كثيراً من النمط الذي ساد سابقاً مع فارق أن سورية صارت هذه المرّة حُطاماً، هذا فيما السوريون مشغولون بتحديد جنس الملائكة.