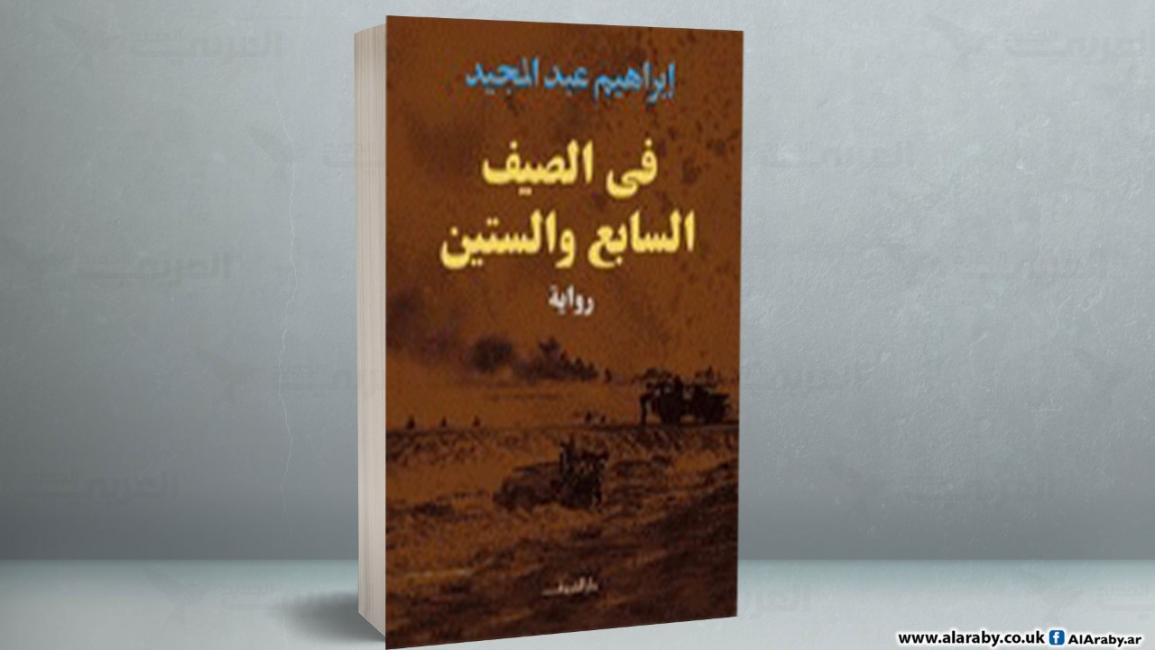حَدَثَ "في الصيف السابع والستين"
يخصّص المصري إبراهيم عبد المجيد (1946) كتابه "ما وراء الكتابة، تجربتي في الإبداع" (الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2012)، لحديثٍ متتابعٍ باستفاضةٍ عن عدة روايات له (أصدر 13 رواية حتى العام الحالي 2021)، وعن سيرته الثقافية والكتابية، غير أنه لا يأتي، إلا في سطريْن عابريْن، على روايته الأولى "في الصيف السابع والستين" (دار الثقافة الجديدة، القاهرة 1979). وهي التي أيضا نادرا ما يتحدّث عنها في مقابلاته الصحافية. قال عنها مرّة إنها تقوم على بناءٍ تسجيلي. وفي أخرى، إنه اعتمد فيها على تسجيل الأخبار السياسية، غير أنه، لاحقا، لم يعد يحبّ هذه الطريقة في الكتابة. وأوضح أنه، في هذه الرواية التي أنجزها في 1974، كان (وجيلُه أيضا) محمّلا بضغط النكسة، وأراد أن يناقش ما حدث .. وبذلك، لا تبدو العلاقة ودودةً بين صاحب "لا أحد ينام في الإسكندرية" وروايته الأولى، المنتسبةِ حكما إلى "الروايات الحزيرانية" العربية، وإنْ أعاد نشرَها في طبعتين تاليتين، بمعنى أنه لا يعتزّ كثيرا بها، ربما لأن أعماله التي تتابعت بعدها مضت إلى خياراتٍ جماليةٍ وتجريبيةٍ متنوعة، تجاوزت ما قد يعتبر "ارتباك البدايات"، وكرّست اسم إبراهيم عبد المجيد في متْن المدونة الروائية العربية الحديثة.
أما استدعاء "في الصيف السابع والستين" هنا فإنما لأننا، هذه الأيام، في غضون ذكرى الهزيمة المدوية في يونيو/ حزيران 1967، وقد أهدى عبد المجيد روايته هذه إلى "كل الذين عاشوا ذلك الصيف الذي لم ينته"، وهو حقا صيفٌ لم ينته بعد، طالما أن هزائم العرب تتوالى. أما الرواية نفسها، فإن استعانتها بتسجيل وقائع سياسيةٍ وبياناتٍ عسكريةٍ في مصر، في أثناء الأيام الستة للحرب، منَحتها سمْت الشهادة على تلك اللحظات التي تعلقت فيها الأنفس والأفئدة بانتصارٍ منتظر بداية، قبل أن تهبط الفجيعة بالخسران إياه. ولم يكن ذلك التسجيل الذي تواشَج مع مسار السرد، ومع الحوار المتقطع بين شخصيات العمل، مُفرطا، ولا نافرا، وإنما بدا عضويا في الحكي بشأن وقائع الحرب الجارية، وبشأن أسئلةٍ عن غياب الطيران المصري، وعن دور غائب، أو غير ظاهر، للسوفييت، وما تُحدثه هذه الوقائع من آثارٍ في نفوس هذه الشخصيات ووجدانها. والأمر هنا يتعلق بشبّانٍ مجنّدين في مركزٍ للدفاع المدني ينتظرون سلاحا لا يأتي، فيما مهمتهم أمنية وللحراسة والترقب، فليسوا في جبهة قتالٍ مباشر، ولكن واحدا منهم يقتلُه زميلٌ له خطأ، يوهمك القصّ بأن السبب عدم حفظ الضحية كلمة السر في الحراسة الليلية. وإذ يجمع الروائي هؤلاء الأفراد، وليس أحدٌ منهم بطلا مركزيا للرواية، في موقعٍ واحد، يبدو غير بعيد عن الجبهة، فإنما ليتيح هذا إضاءةً على مساحات الاختلافات بين أمزجتهم وتصوّراتهم السياسية، فثمّة بينهم الماركسي مثلا. ويجوس النص، في مقاطع غير قليلةٍ، على دواخلهم، وعلى أحلامهم، والأهم على شكوك بعضهم بصدق البيانات العسكرية الأولى عن ضربات أسراب الطيران المصري أهدافا للعدو الإسرائيلي، فيما الترقّب والأمل ماثلان، قبل أن يخطُب الرئيس ويعلن التنحّي، وقبل أن يُذاع بيان الانسحاب من خط القتال، ثم بيان وقف العمليات والالتزام به.
وإذا كان زمان الحكي والسرد "في الصيف السابع والستين" بين السادس من الشهر السادس إلى التاسع منه، إلا أن استعاداتٍ ومحكياتٍ تتناوب في إحالاتٍ ظاهرةٍ إلى زمن أسبق، سيما وأن "مونولوغات"، ترد في العمل بضمير المتكلم تحت عنوان "مناجاة"، فتيسّر لقارئ الرواية طوافا في أعماق الشخصيات، وماضيها، وتوتّراتها، ما يتيح للعمل إيحاءً بصلةٍ غير خافيةٍ بين وقائع وأحوالٍ مصرية قد تعدّ مقدّمات الهزيمة التي صارت، سيما وأن أجواءً في الرواية هنا، وكذا وقائع موصوفة، أحالت إلى اختناق الحرّيات، وانعدام وسائل للتعبير عن قلق ظاهر، على المستوى الفردي تعيينا.
تقرأ في الرواية، ذات البساطة الضافية، عن أجواء استعدادات الحرب، منها إن مصر "تعلن حالة التأهب وتحريك جيوشها"، وأن "محمد عبد الوهاب يقطع إجازته في لبنان، ويعود إلى القاهرة، ليكون في خدمة المعركة". وتقرأ في خواتيمها "انقطعت المارشات العسكرية، وجاء الصوت مبتورا يفضي بحقيقةٍ كريهة، لكنها لم تكن بذات طعم بالنسبة لهم. .. قال المذيع مهرولا، كأن حية لدغته: ساد الجبهة الهدوء ..". وتقرأ أيضا "يا خيبة هذا الوطن وخيبتنا".