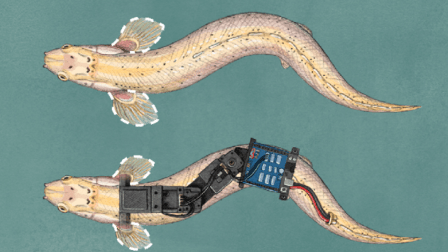تسجّل الجدة بكاميرا هاتفها صوراً عن الثورة (العربي الجديد)
يبدو أن المرأة لم يعُد بإمكانها أن تكتسب صفة جَدّة بمجرّد أن يولد لها أحفادٌ بيولوجيون. فقد قدّم جو قديح في مسرحيته الجديدة "أم الكلّ" نموذجاً جديداً للجدّة اللبنانية، بمواصفات مختلفة تماماً عن الصورة النمطية السائدة في أذهاننا عن الجدّات. فأصبح من متطلبّات الجدة أن تكون امرأة ثمانينيّة بمواصفات شابّة عشرينية. تجاعيدها لا تمثّل مشكلة، ولكن عليها أن تتمتع بمقوّمات تخوّلها عن جدارة التأهّل للقب ملكة جمال. كما أن عليها اكتساب مهارات خاصة في فن رماية الحجارة وتقنيات إشعال الدواليب وتكنولوجيا إضاءة الهواتف الذكية في التجمعات الشعبية. أما الشرط الأهم لتستحقّ أي جدّة لقب "أم الكلّ"؛ فهو أن تبتكر استعمالات جديدة للطنجرة التي لطالما حصرتها بين جدران مطبخها وفوق نيران فُرنها، فتتحوّل الطنجرة الباردة بيدها، وبمجرّد "القرقعة" على كعبها، إلى ماردٍ من الكرامة قادر على إشعال أكبر ثورة شعبية.
كانت الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة 14 فبراير/شباط. اخترنا في هذا التاريخ أن نتخلّى عن مشاريع "عيد الحبّ" التقليدية وقصدنا مسرح "الجميّزة" في بيروت لمتابعة عروض مسرحية جديدة، ولم يخطر في بالنا أبداً أننا كنّا نتجّه من حيث لا ندري إلى موعد غرامي مُدبَّر، سنقع فيه بحبّ امرأة ثمانينية أطلق عليها جو قديح لقب "أم الكلّ"، ليقدّم من خلالها نموذجاً لأي جدّة تتحدّى خريف عمرها بربيع الثورة.
بمكياج مُتقَن وأحمر شفاه صارخ وثياب شتوية مريحة، أطلّ جو قديح علينا بشخصيّة "أم الكلّ" التي لا تشبه أي جدّة قد نكون قد تعرّفنا إليها قبل 17 تشرين.
بقرقعات متتالية من طنجرتها، تؤذن "أم الكلّ" ببدء مغامرتها المسرحية. مغامرةٌ ستترك فيها هذه الجدّة الاستثنائية سنّارة حياكة الصوف، وتغزل من حكاياتها مع الثورة، كنزةً شتويّة بمقاس 10452 كيلومتراً مربّعاً، تتسع لكلّ أبنائها أينما وجدوا، فتشعرهم بدفء الوطنية، وتطعمهم طبقاً ثورياً يشبه بطعمه كثيراً أكل الجدّات الذي نحنّ إليه.
"أم الكلّ" معروفة بلقبها فقط ولا اسم لها لأنها ببساطة أمٌّ للكلّ. ورغم لائحةٍ طويلة من أمراض الشيخوخة التي أصابتها بمفعول زمنِ رجعي، ومع أنها كلّما أرادت أن تجلس على كرسيها، تضطرّ إلى أن تتضرّع إلى عدد يسيرٍ من القدّيسين وأن تترحّم على الأموات وأوّلهم والدتها، الست روزيت، غير أن هذه السيّدة المسنّة أصبحت مدمنةً على إبرة سحريّة، تضخّ الحياة من جديد في شرايينها اليابسة، كلّما تدفّق الشباب إلى الطرقات وملؤوا الساحات بهتافات الحياة.
هكذا، نرى "أم الكلّ" تتحدّى أمام أعيننا قوانين الفيزياء ومعادلات الزمن، فبدلاً من أن تندرج حكايات هذه الجدّة كما جرت العادة في خبايا الماضي، وحنين الذكريات، نجدها على العكس تماماً تسابق عقارب الساعة، تركض نحو المستقبل وهي ممسكة بيد أبنائها لتأخذهم معها الى الوطن الحلم.
وعلى خطى المعلّم المسرحي جلال خوري، يأخذنا جو قديح في عمله المونودرامي الجديد إلى فضاء مسرح وطني مختلف، يفتح ستارته ليفضح كلّ ما خفي خلف جدران السياسة، ويضع تحت الضوء المواطن اللبناني بكل تجليّات آلامه المزمنة فيعطيه دور بطولة مشتركة مع وطنٍ اسمه لبنان. وبتوليفة مسرحية ذكية، يتداخل في هذه المسرحية الفرد مع الوطن فيتبادلان الأدوار كحبيبين يرقصان التانغو معاً، على إيقاع صرخات الثورة. تارةً نرى "أم الكلّ" على الخشبة تروي حكاية البلد بصوتها، وطوراً تصبح هي بنفسها الوطن الذي تتحدّث عنه وتحلم به. فهواجس الجدّة هي نفسها هواجس كل لبناني مشغول بكرامته في بلد يغتال أحلام شبابه كل يوم.
هذه الجدّة لا تترحم على سنوات العمر الذي مضى ولا تحصي أيامها القليلة أو الكثيرة المتبقية. "أم الكلّ" لا تدفن رأسها في ألبوم ذكرياتها وإنما تسجّل بكاميرا هاتفها المحمول صوراً وفيديوهات نابضةً بالحياة من قلب ميادين الثورة.
ورغم السينوغرافيا البسيطة التي اعتمدها قديح في مسرحيته، من كرسي وطاولة صغيرة، إلا أن بطلته الثمانينية تأبى الاستسلام لسجن كرسيها، كما أنها ترفض أن تداوي أوجاعها بالوهم من خلال تنويمٍ تلفزيوني يجترّ الأوجه والاكاذيب نفسها. تتمرّد على روتين أيامها وتستعيض عن شاشة تلفزيونها بمستطيل آخر هو شبّاك بيتها الذي تحوّل إلى شاشة معزّزة بالواقع الحي، حيث يتدفّق الشباب أمام عينيها ويصنعون الحدث كل لحظة بشجاعتهم قبل سواعدهم.
اقــرأ أيضاً
يختلف جو قديح في هذه المسرحية عن كلّ أعماله السابقة، ليس فقط لأن "أبو الغضب" تقمّص دور امرأة ولوّن شفاهه بأحمر التمرّد والحياة، ولكن لأنه أيضاً غيّر صوت نصّه وكتب بنفس زخم العاطفة التي تحرّك النفوس لتنزل إلى الساحات وتطالب بالحريّة، فخطاب الوجع بالضحكة، تحدّث مع الأرزة وأمسك العلم وشدّه بحرارة إلى صدره. كانت المسرحية بمثابة إعلان حالة حب وطنية، فالكلّ أصبح على موعد غرامي منتظر في الثامنة من كل مساء عندما تقرع الطناجر إيذاناً بقرب اللقاء مع حبيب اسمه الوطن، حبيب ظننّا أن قصته انتهت لتعود وتولد من جديد.
كانت الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة 14 فبراير/شباط. اخترنا في هذا التاريخ أن نتخلّى عن مشاريع "عيد الحبّ" التقليدية وقصدنا مسرح "الجميّزة" في بيروت لمتابعة عروض مسرحية جديدة، ولم يخطر في بالنا أبداً أننا كنّا نتجّه من حيث لا ندري إلى موعد غرامي مُدبَّر، سنقع فيه بحبّ امرأة ثمانينية أطلق عليها جو قديح لقب "أم الكلّ"، ليقدّم من خلالها نموذجاً لأي جدّة تتحدّى خريف عمرها بربيع الثورة.
بمكياج مُتقَن وأحمر شفاه صارخ وثياب شتوية مريحة، أطلّ جو قديح علينا بشخصيّة "أم الكلّ" التي لا تشبه أي جدّة قد نكون قد تعرّفنا إليها قبل 17 تشرين.
بقرقعات متتالية من طنجرتها، تؤذن "أم الكلّ" ببدء مغامرتها المسرحية. مغامرةٌ ستترك فيها هذه الجدّة الاستثنائية سنّارة حياكة الصوف، وتغزل من حكاياتها مع الثورة، كنزةً شتويّة بمقاس 10452 كيلومتراً مربّعاً، تتسع لكلّ أبنائها أينما وجدوا، فتشعرهم بدفء الوطنية، وتطعمهم طبقاً ثورياً يشبه بطعمه كثيراً أكل الجدّات الذي نحنّ إليه.
"أم الكلّ" معروفة بلقبها فقط ولا اسم لها لأنها ببساطة أمٌّ للكلّ. ورغم لائحةٍ طويلة من أمراض الشيخوخة التي أصابتها بمفعول زمنِ رجعي، ومع أنها كلّما أرادت أن تجلس على كرسيها، تضطرّ إلى أن تتضرّع إلى عدد يسيرٍ من القدّيسين وأن تترحّم على الأموات وأوّلهم والدتها، الست روزيت، غير أن هذه السيّدة المسنّة أصبحت مدمنةً على إبرة سحريّة، تضخّ الحياة من جديد في شرايينها اليابسة، كلّما تدفّق الشباب إلى الطرقات وملؤوا الساحات بهتافات الحياة.
هكذا، نرى "أم الكلّ" تتحدّى أمام أعيننا قوانين الفيزياء ومعادلات الزمن، فبدلاً من أن تندرج حكايات هذه الجدّة كما جرت العادة في خبايا الماضي، وحنين الذكريات، نجدها على العكس تماماً تسابق عقارب الساعة، تركض نحو المستقبل وهي ممسكة بيد أبنائها لتأخذهم معها الى الوطن الحلم.
وعلى خطى المعلّم المسرحي جلال خوري، يأخذنا جو قديح في عمله المونودرامي الجديد إلى فضاء مسرح وطني مختلف، يفتح ستارته ليفضح كلّ ما خفي خلف جدران السياسة، ويضع تحت الضوء المواطن اللبناني بكل تجليّات آلامه المزمنة فيعطيه دور بطولة مشتركة مع وطنٍ اسمه لبنان. وبتوليفة مسرحية ذكية، يتداخل في هذه المسرحية الفرد مع الوطن فيتبادلان الأدوار كحبيبين يرقصان التانغو معاً، على إيقاع صرخات الثورة. تارةً نرى "أم الكلّ" على الخشبة تروي حكاية البلد بصوتها، وطوراً تصبح هي بنفسها الوطن الذي تتحدّث عنه وتحلم به. فهواجس الجدّة هي نفسها هواجس كل لبناني مشغول بكرامته في بلد يغتال أحلام شبابه كل يوم.
هذه الجدّة لا تترحم على سنوات العمر الذي مضى ولا تحصي أيامها القليلة أو الكثيرة المتبقية. "أم الكلّ" لا تدفن رأسها في ألبوم ذكرياتها وإنما تسجّل بكاميرا هاتفها المحمول صوراً وفيديوهات نابضةً بالحياة من قلب ميادين الثورة.
ورغم السينوغرافيا البسيطة التي اعتمدها قديح في مسرحيته، من كرسي وطاولة صغيرة، إلا أن بطلته الثمانينية تأبى الاستسلام لسجن كرسيها، كما أنها ترفض أن تداوي أوجاعها بالوهم من خلال تنويمٍ تلفزيوني يجترّ الأوجه والاكاذيب نفسها. تتمرّد على روتين أيامها وتستعيض عن شاشة تلفزيونها بمستطيل آخر هو شبّاك بيتها الذي تحوّل إلى شاشة معزّزة بالواقع الحي، حيث يتدفّق الشباب أمام عينيها ويصنعون الحدث كل لحظة بشجاعتهم قبل سواعدهم.
يختلف جو قديح في هذه المسرحية عن كلّ أعماله السابقة، ليس فقط لأن "أبو الغضب" تقمّص دور امرأة ولوّن شفاهه بأحمر التمرّد والحياة، ولكن لأنه أيضاً غيّر صوت نصّه وكتب بنفس زخم العاطفة التي تحرّك النفوس لتنزل إلى الساحات وتطالب بالحريّة، فخطاب الوجع بالضحكة، تحدّث مع الأرزة وأمسك العلم وشدّه بحرارة إلى صدره. كانت المسرحية بمثابة إعلان حالة حب وطنية، فالكلّ أصبح على موعد غرامي منتظر في الثامنة من كل مساء عندما تقرع الطناجر إيذاناً بقرب اللقاء مع حبيب اسمه الوطن، حبيب ظننّا أن قصته انتهت لتعود وتولد من جديد.