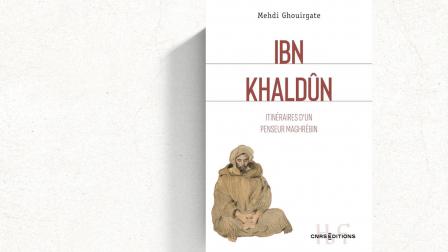أعترف أنني جئتُ إلى المغرب بسؤال مسبق، وفرضتُ على رحلتي مساراً عسى أن ألتقط عناصر الإجابة عليه. لكن، من حسن الحظ، سرعان ما تعرف الرحلة كيف تفلت من كل تخطيط مسبق.
كان سؤالي هو: ما الذي يفسّر التراكم المغربي الذي أُنجز في مجالات البحث الفكري والأدبي والفنّي على مدى العقود الأخيرة، بما لا يتوفّر عليه بلد عربي آخر، وهو ما تشهد عليه مدوّنة ثرية لعلّ أبرز معالمها كتابات مثل "الأيديولوجيا العربية المعاصرة" لعبد الله العروي، ومشروع "نقد العقل العربي" لعابد الجابري، و"الشخصانية الإسلامية" لعزيز لحبابي، و"الاسم العربي الجريح" لعبد الكبير الخطيبي، و"الزمان التاريخي" لسالم يفوت...
وتستمر هذه الحالة حين نرى الكمّ الهائل من الإصدارات والمشاركات البحثية في المؤتمرات ونشر المقالات في المجلات المحكّمة والصحافة الثقافية العربية، ناهيك عن حضور الأسماء المغربية في الجوائز العلمية والأدبي. من الفلسفة إلى التاريخ، ومن علم الاجتماع إلى الأنثروبولوجيا، مروراً بالدراسات الأدبية والمسرحية والسينمائية واللسانيات، يصعب ألّا يعترضنا أثر المغاربة، دون أن ننسى ما يغذّون به المكتبة العربية عبر قناة الترجمة.
وإذا كانت الأسئلة المسبقة مفيدة من حيث أنها تصنع انتباهاً ضرورياً لطالب الإشباعات المعرفية، فلا يخفى أنها أمر له خطورته منذ أن تتحوّل الرحلة إلى واقع ملموس، أي حين تتولّد عن اقتراحات مثيرة أخرى غير الأسئلة التي أتينا بها. فكثيراً ما كان الجاهز حاجباً يعقّم أسئلة أخرى كان يمكن أن تتبرعم عفو الخاطر.
إنها لعبة دقيقة على المترحّل أن يديرها وهو يوازن بين أهدافه التي أتى من أجلها وتلك اللمحات التي تغويه لاكتشاف ما وراءها. بالنسبة إليّ، كان ذهني ميدان تجاذب بين المغرب النظري الذي يقوم على تفسير كل شيء بمعادلات الجيوبوليتك، ومغرب واقعي أبدأ في تلمّسه مثل عميان أمثولة الفيل، بتعقيدات تضاريسه ومناخاته وتفاعلاته الكيميائية- البشرية التي لا تهدأ، واقتناص مفردات لفهم أسراره، تلك التي لا يسلّم السطحُ مفاتيحَها. وفي كل ذلك عليّ ألّا أسقط في منظور السائح، والذي تشعر أن كل شيء تقريباً في المغرب يعمل كي يسقطك فيه. وكيف لك بإفساح المجال إلى تذوّق "المغارب" المتراكبة في مكان واحد، فلا يفسد مذاقٌ عليك مذاقات أخرى؟
ستبدأ هذه المعادلة في إطلاق تناقضاتها منذ أن تكشف النقاشات أن الاعتقاد بهذه الحالة من التنشط الفكري المغربي لا يشاركك فيها جزء كبير من المغاربة. يستغربُ مني بعضهم هذا الاعتقاد أصلاً، لينفتح الحديث على إعاقات شتى يعاني منها المشهد الثقافي المغربي، من البنى الاجتماعية العميقة إلى تدبير السلطة للشأن العام. بعضٌ آخر، كان يستغرب أن تصدر عن تونسي بالذات، فهؤلاء يعتقدون من جانبهم بـ"ازدهار" تونسي. في هذا المستوى من الحديث، لنا أن نتأكّد من سلامة ما يذهب إليه الشطر الشعري الذي يقول: "كلّنا في الهم شرقٌ".
هذه النقاشات كانت عتبة أولى للسؤال المغربي، وها قد خَلخلت فرضياته وكَشفت أنه يتضمّن حكماً مسبقاً قد لا تكون له مسوّغات واقعية. لكن تظلّ هناك بوابات أخرى.
كنت أزمع خلال الرحلة المغربية، وضمن مخطّط ملاحقة عناصر الإجابة عن سؤالي، أن ألتقي مفكّرين ممّن قرأت لهم. وضعتُ على رأس القائمة: عبد الله العروي، فتلك رغبة فكرية بعيدة في نفسي. هنا، اصطدمت بجدار سميك من الغياب، لا حضور للرجل في أي مكان (واقعي)، لا رقم تليفون، لا عنوان بريدياً أو إلكترونياً، بدا لي مثل الجبلاوي في رواية "أولاد حارتنا". بات ذلك الصمت البارد أحد البوابات إلى السؤال عن الفكر المغربي، وفرضاً لو عبرته ستستلمك متاهة الأزقة التي إذا دخلتها فلست بضامن أن تجد طريق العودة.
من حسن الحظ، منحني "معرض الدار البيضاء للنشر والكتاب" فرصة معاينة مكثّفة لاختبار فرضيّتي، حين أَحضَر في مكان واحد بعض ما أبحث عنه، بحيث تحوّل "الحقل الفكري" (إذا تلاعبنا بمصطلح بيير بورديو) إلى فضاء شبه ملموس وقد تجسّد مكانياً، فالمعرض قد دعا ضمن ندواته وفعالياته أسماء فاعلة في المشهد الثقافي العربي؛ مثل عبد السلام بنعبد العالي وعبد الفتاح كيليطو وعبد الإله بلقزيز وسعيد ناشيد وبنسالم حميش. وكانت أعمال هؤلاء، مع آخرين لم يحضروا، قادحاً للسؤال الذي أتيت به معي.
يتيح المعرض أن نرى "مجتمع الثقافة" هذا على طبيعته، في نقاشاته وتصوّراته العفوية وتوتّراته ومجاملاته. لا شكّ أنني كنت محكوماً بخيارات تبجّل الأسماء التي أعرفها، لكن العين لا تخطئ كون المشهد أوسع، فالمغرب يعجُّ بالمهتمين بقضايا الفكر والمشتبكين معها سواء في أورقة الجامعات أو في مسالك الحياة اليومية.
يتمتّع المغرب اليوم بشبكة موسّعة من الباحثين تتوزّع على ميادين عدّة تتقاطع وتتباعد، تتجادل أو تتصامم. وإذا كنّا نلتفت إلى حضور هؤلاء الباحثين بأسئلة متنوّعة تمتح من الأطروحات التي يشتغلون عليها أو من هواجس معرفية عامة أو تنطلق من الانخراط في الحياة العامة، فإننا يمكن أن نلاحظ أيضاً أن الأسماء الكبيرة والتي هي محور المتابعة الرئيسي لدى هؤلاء، قلّما تحضر لمناقشة بعضها.
انطلاقاً من الزاوية التي أتاحها "معرض الدار البيضاء"، بتُّ أتساءل إن كان من الممكن استشراف مشهد الثقافة المغربية بعد سنوات، فأجده مفضياً إلى فسيفساء غنية من الباحثين الناشطين اليوم بعيداً عن أبوية هذا الاسم أو ذاك، وهو المسار الطبيعي في غابة المعرفة المتضخّمة.
لنسلّم بصعوبة التقاط هذه الصورة خارج حدث مثل معرض الكتاب، فعلى مستوى النشر لا ينعكس من هذا الحراك إلا قليله في منظومة النشر في المغرب وفي صحافته الثقافية. يكتب معظم المغاربة من هؤلاء الباحثين في دوريات مشرقية، ولهذا تفسيراته الاقتصادية قبل الثقافية، ولكن ألن يكون له انعكاسات على مستوى "مغربية" التفكير والطرح بالتدريج؟ يمكننا أن نبقى على ضفّة الجانب الإيجابي من المسألة وحده، حيث تُسقط مساهمات الباحثين تلك القناعة القديمة بعزلة المغرب داخل الثقافة العربية. لكن لا ضير أن نتخيّل مغرباً فيه مجلّات علمية ودور نشر تستثمر رأس المال المعرفي الذي يتوفّر بقربها.
ليس المعرض سوى فضاء مغلق في النهاية، ليس مكانياً فحسب، فبرنامجه يخضع بالتأكيد إلى خيارات، مهما كان انفتاحها، خاضعة لرؤية "المنظومة". ومن المؤكّد أن عناصر الإجابة التي أبحث عنها مبعثرة في مطارح أخرى. لا ننسى مثلاً أن جزءاً كبير من "الحقل الفكري" يقع في الرباط، ذات الثقل الجامعي الأهم في المغرب، كما لا يزال جزء كبير من الثقافة غير مندمج في تظاهرة مثل معرض الكتاب، من ذلك فنون الشارع التي تبدو بارزة للعيان في الدار البيضاء ربما أكثر من أي مدينة عربية أخرى، وقد أصبحت رسومات الغرافيتي فيها تشبه البشرة الثانية للمدينة.
لن نبتعد كثيراً عن مبنى المعرض، وهو الذي يقع في وسط المدينة على عكس معظم المعارض، وهو يستفيد من ذلك بكونه مزدحماً طول النهار تقريباً على مدى أيامه، فبالقرب منه أماكن تكاد لا تفرغ أبرزها مسجد الحسن الثاني، بمعماره الإبهاري وصومعته العملاقة، وقد تحوّل رغم حداثة بنائه إلى المعلم الرئيسي في المدينة، ولعله بات يُخفي الكثير مما في الدار البيضاء. أليس ذلك على غرار هندسة "الحقل الفكري"؟
على عكس هذا الشعور بصعوبة أن تمتدّ الرؤية في المغرب دون تعطيلات الظاهر المبذول بعناية لإخفاء الباطن العميق، سنجد وراء المسجد العملاق "الكورنيش" المطل على الأطلسي (المعرض لا يطلّ على المحيط مثل مدينته، فهو مشرقي الميول مع بعض المذاقات؛ إسبانية وفرنسية بالخصوص). يبدو وكأنه ينطق بفخر محدّثاً عن سيطرته على أمواج البحر وإن علت، لكن هل تفعل ذلك "كازا" بحقّ؟ هل تسيطر على الأمواج البشرية؟
ثمّة سؤال آخر اعتقدتُ واهماً ببساطته: كم يبلغ تعداد مدينة الدار البيضاء؟ طرحتُه أوّل مرة دون تفكير، وانتظرت إجابة نهائية بسيطة، ولمّا لم أظفر بإجابة، من سائق التاكسي إلى مثّقفين التقيتهم، تحوَّل غياب الإجابة إلى سؤال جديد. بالأحرى، أصبح إشكالية مرحة: لا أحد يتساءل كم يسكن في هذه المدينة، بل هو سؤال بات بلا معنى بالنسبة إلى كثيرين يعايشونها، فهي تتضخّم كلّ يوم. لم أكن أرى أن هذا السؤال العابر بعيد عن أسئلة الفكر، فهو يقول حقيقةً ما عن المدينة، وعن البلاد التي لم تجعلها عاصمةً على مدى تاريخها رغم أنها أكبر مدنها.
تحتكّ، في كازا، الأحياء ذات المعمار الكولونيالي بالمباني الحديثة، وكل ذلك غير بعيد عن المدينة العتيقة، وأحياء الصفيح التي تتناثر في أماكن عدة لكنها غالباً محجوبة عن العين الخارجية بمبان أخرى بُنيت كي تكون في الواجهة. هذه التجاوُرات هي ربما الخط الرئيسي في ملامح وجه الدار البيضاء، وكأنها تفضّل أن تكون متناقضاتها متلامسة، فإذا كانت معظم المدن تفرّق بين مناطق للأحياء الراقية وأخرى تسكنها الطبقات الأدنى، فإننا كثيراً ما لا نجد خطاً فاصلاً في كازا، فلا تفصل سوى أمتار قليلة بين عمارات فخمة وبيوت مهترئة، وقبل ذلك تتداخل الأساليب المعمارية، متناغمة أحياناً ومتنافرة بشكل حاد في مواضع أخرى.
هذا التعايش، نجد أثره على مستويات أخرى؛ أنماط التفكير، الكلام، اللباس، وسائل النقل، أسماء الشوارع، وغيرها. تشعر دائماً أن أزمنة كثيرة تتقاطع. سيكون مريحاً لنا دائماً أن نختزل هذا التعايش في صراع التراث والحداثة، أليس هذان هما العنوانان الأكثر بروزاً حين نتصفّح مدوّنة الفكر المغربي؟ ألا تكون هذه "المعركة" الحية عامل تنشيط للعقل المغربي؟ تلك أسئلة أخرى لا تزال تتولّد من بعضها، لكنني أعرف الآن أن المغرب يحب أن يحتفظ بأسراره وارء الأبواب.