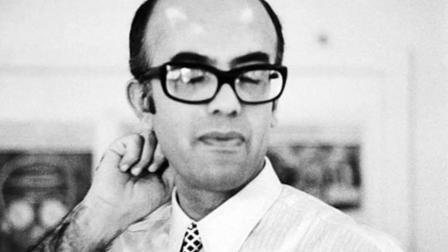في عام 1930 سيقوم الكاتب والشاعر والصحافي المصري الشهير إبراهيم عبد القادر المازني برحلة إلى مكة من أجل أداء العمرة، في وفد متكون من عدد من الوجهاء و"الأفندية والبكوات".
هذا الكاتب الساخر، الذي يعتبر إلى جانب طه حسين ومحمود العقاد، أحد أهم أدباء مصر في الخمسين سنة الأولى من القرن العشرين، سيجد نفسه أمام الكثير من المواقف والالتقاطات والتفاصيل، التي سيدونها في رحلته وسيصدرها تحت عنوان "رحلة إلى الحجاز"، وذلك قبيل اكتشاف النفط، حيث كانت الموارد المالية شحيحة في منطقة الخليج وفي السعودية، وكان الحج يشكل اقتصادا حقيقيا بالنسبة لبلاد الحرمين الشريفين.
ولذلك فأهمية هذه الرحلة تأتي من هنا، أي من كونها تؤرخ للمنطقة، قبل أن يأتي البترول ويقلبها رأسا على عقب، بفعل ما أحدثته الثورة النفطية من انقلاب كبير على حياة الناس وفي كل جميع المستويات.
في الطريق إلى ينبع
يكتب المازني عن بداية الرحلة نحو بلاد الحرمين، متوجها عبر البحر إلى ميناء ينبع، عن ظروف الرحلة وما رافقها، وعن الحياة على ظهر تلك السفينة، يقول "رأيت نفسي أتساءل — وأنا أصافح ربان السفينة وأستفسر منه عن الجو وما ينتظر أن يكون، والبحر وهل يُرجى أن يكون لينًا: (ماذا يُرجى لهذه الأمة العربية التي سنشهد بعد أيام احتفالها بمبايعة ملكها؟ هل تكر على العالم بنهضة جديدة؟ أو دَعِ الكَرَّ فقد تكون مسافة ما بينها وبين العالم أطول من أن تعين عليه أو تجعل له محلًّا، وسل: هل في وسعها أن تشق طريقها إلى منزلة من منازل الحياة العزيزة؟).
ومن عجائب النفس الإنسانية أنها تتَّسع لهذا الازدواج: هذا الربان أمامي أجاذبه أطراف الحديث وأنتقل معه من جِدٍّ إلى هزل، وأعرفه بهذا وذاك من إخواني. وتتَّسع حلقة الكلام وترحُب دائرته وتكثُر شعابه، ويذهب هو يصف لي ميناءَيْ ينبع وجُدَّة، وكيف تكثر في مدخليهما الصخور، وأنا منصت مرهِف الآذان لكل حرف، ولساني يجري بالكلام مجاوبًا أو ملاحظًا أو مسائلًا، وإذا بخاطر آخر يشغل من النفس الحَيِّزَ الأكبر ويدور فيها ويأبى إلا أن أُعنَى به وألتفت إليه".
ونلمس في رحلة المازني استعراضا واضحا لمهاراته اللغوية وقدرته على الإجادة في الوصف، ودربته التي اكتسبها من خلال مزاولته الطويلة للعمل الصحافي، بالإضافة إلى التضمينات الواضحة التي تمتح من مخزون ثقافته الواسعة وتعدده اللساني، حيث كان يتقن اللغة الإنكليزية ويجيدها إجادة تامة، وقد نفعه ذلك، وهو على ظهر السفينة التي كان جل "كباتنتها" إنكليز، يقول "ولعل للقلب في أثناء ذلك التفاتة أخرى إلى الأهل والإخوان، وإلى ما خلَّف المرء وراءه من معاهد حياته، وأغرب من هذا أن تكون الالتفاتة عمومها كالخصوص فهي لفتة شاملة محيطة، ولكل شخص ولكل حادثة حظ نسبي من البروز، ولكل ذكرى محلها ولكل عهد مكانه، بلا بخس ولا وكس.
على أن هذا ليس موضع الإفاضة في قدرة النفس على الاشتغال بأكثر من أمر واحد والانصراف إلى كل شأن كأنها متخلية له، فلنرجع إلى ما كنا فيه.
لم أُجِبْ على سؤالي وإن كان التفكير فيه قد شغلني طول الطريق؛ لأن كل ما أعرفه عن العرب في حاضرهم مستفاد ممَّا قرأت أو سمعت، ولم أَرَ موجبًا للتعجيل بالجزم وليس بيني وبين المعاينة إلا أيام.
غير أن هذا لم يُعفِنِي من إلحاح هذا الخاطر الذي ظلت النفس تواجهني به وترفعه قبل عيني على صور شتى؛ فمرة يكون السؤال كما أوردته، وتارة يكون: (هل في الأمة العربية مادة صالحة لما تتطلبه الحياة في العصر الحاضر من الكفاح المر؟)، وطورًا يهتف الأمل: (إن هذه الأمة تغالب طبيعة بلادها الماحقة، وتصارع أهوال الصحراء، فلِمَ لا تستطيع أن تكافح المصاعب التي تحفها بها الأحوال العارضة؟).
وربما جنحت النفس إلى اليأس كلما تصورت بُعْدَ ما بين العرب وغيرهم من شعوب الأرض المتحضرة، وتعذر اللحاق بهذه الشعوب التي أغذت السير قرونًا وهم يحدون الإبل ويقتتلون كما كانوا يفعلون في الجاهلية. بل كان اليأس يخامرني كلما تخيلت الصحراء الساحقة التي يصارعونها، وكنت أقول لنفسي: (هل يتاح لأمة واحدة أن تنهض مرتين وأن يكون لها في التاريخ مدنيتان عالميتان؟ ألَا تستنفد النهضة الأولى قواها وتعتصر حيويتها ولا تبقي منها إلا ما يَبقى من ألياف القصب الجافة بعد مصه أو اعتصاره؟).
وهكذا إلى غير نهاية! فما لقينا من البحر ما يصرفني عن التفكير أو يعدل بخواطر النفس إلى مجرًى آخر. ولقد كنا في السفينة وكأننا في بيوتنا لا على الماء، وكانت السفينة تفرق البحر وكأنها لا تمسه، فلا موج ولا اهتزاز ولا دوار، حتى لقد اشتقت أن يطغى بنا قليلًا ليردنا إلى التهيُّب، غير أن البحر خيَّبَ أملي فيه".
معرفة الأحوال
يفصح المازني في أول وهلة عن أهمية رحلته، لأنها تضعه في عمق الامتداد المشرقي. وهو لذلك يعبر عن فرحة مضاعفة، أكثر من أي حبور برحلة مماثلة إلى الغرب، فهو يرى أن الغرب بدأ يأتي إلى مصر وغيرها من الدول العربية، بل لا يأتيها على راية سلم، بل يأتي غازيا في أكثر الحالات، لذلك لا فضول نحو اكتشاف الغازي.
يكتب "وسرني على الخصوص أن السفر إلى الحجاز لا إلى الغرب؛ ذلك أن الغرب يزور مصر، ولو شئت لقلت إنه يغزوها، فلسنا نحتاج أن نزوره، أما الحجاز فأمره مختلف جدًّا، ولَنحن خلقاء أن نجعل علمنا بالشرق العربي أعمق، وصلتنا به أوثق، وارتباطنا به أمتن.
وما أحسبني أبالغ حين أقول إن مستقبل الشرق واحد وإن تفاوتت خُطى أبنائه. ومن الجهل أن نشيح بوجوهنا عنه، ومن الخرق أن نتجاهله، ومن البلادة أن ننسى أننا مرتبطون به وإن خفيت الخيوط، ومن الغفلة أن نتوهم أن الرحيل لا يكون نافعًا إلا إلى الغرب، وأنه لا فائدة تُكتَسب من زيارة الشرق والاطلاع على أحواله".
الرسو في الميناء
يحافظ المازني على خفة الدم نفسها وحس الفكاهة طيلة الرحلة، مع مماحكاته لرفاقه، حتى لتشعر بأنه رجل ساخر من كل شيء، وطيلة الوقت "في الساعة السادسة من صباح السبت (4 يناير/ كانون الثاني) أيقظني أحد الزملاء وأبلغني بأن الشاطئ قد ظهر، فقلت له وأنا أتميز غيظًا إني لا أحفل بالشواطئ — ولو كانت شواطئ الجنة — في الساعة السادسة صباحًا، فذهب عني وأغمضت عيني، ولكن غيره جاء ثم غيره، فأيقنت أن الحماسة التي أوقدها ظهور الشاطئ لن تدع لي جفنًا يغفى، فقمت متثائبًا متثاقلًا ووقفت متكئًا على الحاجز فلم أرَ شيئًا فالتفتُّ إلى أول من أيقظني وقلت بلهجة المعاتب: (أين هذا الشاطئ الذي بدا لك يا سيدي؟).
فقال: (هذا. ألا تراه؟ غريب! إني أستطيع أن أشير إلى المكان الذي سترسو أمامه الباخرة. لا بد أن يكون هذا).
ومرت الساعات ونحن نروح ونجيء وهو في مكانه لا يتحول عنه ولا تتعب رجلاه، وبدت ينبع ملفوفة في الضباب، حتى جبال رضوى التي تظهر من ورائها خلناها ضبابًا من اختلاط السحب برؤوسها، فاختلفنا وتراهَنَّا، وشرعت السفينة تدور لتدخل المرفأ، فقربنا جدًّا من الساحل وشاء الحظ الساخر أن يكون المكان الذي أشار إليه صاحبنا وأصر على أن الباخرة سترسو عنده، هو المقبرة".
إنكليزي يؤذن
قراءة المازني متعة حقيقية وإفادة من زوادته اللغوية، ومن سلاسة سرده، يكتب مثلا، عن سماعه للأذان على ظهر السفينة من طرف كابتن إنكليزي "استيقظت بعد ظهر يوم على صياح عجيب، لا هو صياح ولا هو استغاثة، لأن فيه انتظامًا ولأن في الصوت تنغيمًا، فاستويت قاعدًا وأرهفت أذنيَّ فخيل إليَّ أن الألفاظ عربية ولكن اللهجة غريبة، ثم تبينت لفظين هما: (الله أكبر!)، ولكن اللسان الذي يعلو بهما كان أعوج ملتويًا، فعجبت ثم تذكرت أنها إحدى سفن (البوستة الخديوية)، وهي شركة إنكليزية تسير بواخرها بين السويس والسودان جيئة وذهوبًا، وتنقل الحجاج — فيما تنقل — إلى ينبع وجدة. وقد رأينا بعضهم في الباخرة على غطاء مخزن البضاعة حيث يفرشون السجاجيد ويكدسون أمتعتهم ويحشرون أنفسهم بينها تحت سماء الله، وهذا هو مكان الدرجة الثالثة.
وقد قلت لنفسي لما سمعت هذا الصوت: إن الإنكليز قوم يتوخون أن يتكيفوا على مقتضى الظروف ووفق ما تتطلبه الأحوال، وهذا الذي سمعته أذان أي دعوة إلى الصلاة، وليس مما يتنافى مع الشذوذ الإنكليزي أن تكون الشركة قد عينت للأذان في الباخرة واحدًا من هؤلاء (الكباتن) الذين لا أدري ماذا يصنعون جميعًا في سفينة صغيرة كهذه.
وسرني وأضحكني أن المؤذن (كبتن) إنكليزي، وقلت: أشرك إخواني في ما يفيده العلم بذلك من المتعة. فعدوت إلى سطح الباخرة حيث كنَّا نجتمع فالتقيت بواحد أقبلت عليه أفضي إليه بخبر هذه البدعة السكسونية. فضحك، ولكن مني، ثم أشفق أن يعرف زملائي زلتي فيركبني الثقلاء منهم بالسخرية، وأومأ فإذا تحت أنفي جماعة من العرب يصلون، وإذا صوت الإمام كصوت المؤذن فيه ذلك الالتواء الذي خدعني.
في حضرة الأمير وسلام النجديين
وبعد لَأْيٍ ما بلغنا غرفة الاستقبال. وكان الأمير واقفًا في الصدر وحوله الكبراء والجند، والناس يتقدمون إليه ويصافحونه، فإذا كان من بينهم عظيم أو وجيه وضع — أي الوجيه — يده على كتفي الأمير وجذبه وقبَّل أنفه لأن الأنف أبرز شيء في الوجه، وقد وقف الأمير كما رأيناه، مقدمًا أنفه لمن شاء ومتلقيًا عليها قُبَلَ المهنئين ولثمات الداعين، فلما جاء دورنا ودِدت لو أنه كان أمامه كرسي! إذن لفزت أنا أيضًا بتقبيل أنفه ولجرّبت ذلك وعرفت سببه وتقصيت سره، ولكني كما تعرف، فاكتفيت بأن تقدمت إليه في تؤدة ووقار، ويسراي تمسح لحيتي تنبيهًا إليها ولفتًا لشيبها، ويمناي تمتد إلى يده وتقبض عليها.
والحق أقول: إن سلام النجديين لا يعجبني لأنه بارد لا حرارة فيه ولا رُوح، والواحد منهم — أميرًا كان أو غير أمير — يمد إليك كفًّا مفتوحة كأنها قطعة من الجبن الطري لا عظم فيها ولا أعصاب لها، فإذا تناولتها وقبضت عليها لم يبادلك ذلك بل ترك كفه لك تصنع بها ما تشاء، ثم يسحبها في فتور وضعف، فتخجل وتبرد الحرارة التي تناولت بها يده، ويجمد الدم في عروقك.
وانصرفنا عن الأمير بعد السلام عليه إلى غرفة أخرى ذهبوا بنا إليها، وهناك سقونا عصير الليمون، ثم ما لبثنا أن دعينا إلى الأمير فدخلنا وجلسنا وهنَّأناه مرة أخرى، وأديرت علينا القهوة النجدية، وأمرها عجيب؛ ذلك أنها خليط من البن والمري والحبهان ولا أدري ماذا أيضًا، وطعم البن يختفي بين هذه الأخلاط الحريفة، ويجيئونك بها في إبريق كبير من النحاس، يحمله الخادم في يسراه، وفي يمناه الفناجين الكبيرة بعضها في بعض، فيصب من الإبريق مقدار رشفة في الفنجانة ويقدمها لك فتقلب الفنجانة على فمك وتهزها لينحدر ما فيها بسرعة، فإذا راقتك القهوة مددت يدك بالفنجانة في صمت فيصب لك رشفة أخرى وهكذا، وإلا هززت الفنجانة فينصرف عنك.
وقد كنت وأنا في مجلس الأمير متعبًا وكان رأسي أحسه ثقيلًا، وخفت أن أنام أنا أو أهوِّم، فقلت أُنبِّه نفسي بالقهوة؛ فرجوت من الخادم أن يملأ لي الفنجانة فإن هذه الرشفات الضئيلة لا تصنع شيئًا، ولكنه آثر عادته فذهب يصب لي رشفة بعد أخرى وأنا أناديه بعد كل واحدة وأرده إليَّ، ولا أناوله الفنجانة مخافة أن يذهب عني فلا يعود. فلما تكرر ذلك أربع مرات خطف الخادم الفنجانة وصاح وهو يمضي عني ضاحكًا (يا رجل!). فقمت وراءه وأنا أقول: (ما هذا الكلام الفارغ؟! أريد قهوة حقيقية لا لونًا في الفنجانة! تعال هنا!).
فأسرع إليَّ واحد من الحاشية يسألني ما الخبر.
قلت: (الخبر أني أريد أن أشرب قهوة حقيقية، وهذا الرجل يضحك عليَّ ويقدم لي دهانًا في قعر الفنجانة لا يسيل ولا يصل إلى حلقي منه شيء، هذا هو الخبر. ثم هذا لساني (وأخرجته) بذمتك هل ترى عليه أثرًا للقهوة؟!).
فقال الرجل: (لا عليك. تعالَ يا هذا، أترع له الفنجانة).
وقد كان.
وكَفُّوا بعد ذلك عن مخادعتي بلون القهوة وصاروا يجيئونني بها في كل مكان قهوة حقيقية لا شك فيها ولا في مقدارها ولا في طعمها ولا أثرها، ولكنها سرقت النوم من جفوني ففهمت لماذا يكتفون منها برشفة" (رحلة إلى الحجاز/ المازني).
.....
"وعدنا إلى دار الضيافة لنستريح فاتفق أن لقيت في الطريق واحدًا لم أشك في أنه نجدي وكان فوق نجديته قصيرًا، فأقبلتُ عليه وقلت هذه فرصة، وقلت: (كيف حالك؟ إن شاء الله خير).
وأهويت على كتفه فجذبتها على نحو ما رأيتهم يفعلون ومططت شفتي استعدادًا لتقبيل أنفه، ولكني لم أحسن قياس الأبعاد وعمل الحساب اللازم، وجاءت الجذبة أسرع وأشد مما ينبغي فوقع فمي على فمه واصطدم الأنفان.
فلما أفاق من دهشته، قلت له على سبيل الاعتذار وأنا أتلمظ وأمصمص بشفتي: (لا مؤاخذة! لقد أردت أن أقبل أنفك، ولكن التدريب ينقصني. على كل حال الخيرة في الواقع. السلام عليكم). وذهبت أعدو ولحقت بإخواني وهم يهمون بالعودة إليَّ وقد توهموا لبلاهتهم أننا اشتبكنا في مصارعة".