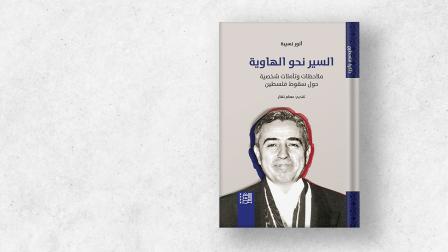القراءة عادة طارئة على الإنسان، فهو لم يكن يكتب حتى يقرأ، إلا إذا كان يقرأ تحوّلات الطبيعة وملامح الوجوه، ويحزر نوايا البشر والحيوانات. مع الكتابة أصبح مغرمًا بالكلمات والحروف، ليس بحد ذاتها بل في ما تنقله إليه من معرفة، وما تثيره في داخله من خيال وتجليات، ومشاعر الحب والبغضاء، وبما يصف به الأصدقاء والأعداء.
ما أعرفه أن الذي لم يقرأ عندما كان صغيرًا، لن يعتاد القراءة في الكبر. ولو أنه قرأ أخبار الأحداث اليومية، وما يصادفه من الحكم والنوادر والطرائف، وبعض القصص والروايات المسلية، وقد يهتم بكتب تزعم أنها تجد حلولاً لمشاكله، أو كيف ينمي عقله، ويكسب الأصدقاء، أو كتابة الرسائل الغرامية، وتعليم لغة ما في خمسة أيام، أو إرشادات عن معاملة الزوجة وتربية الأطفال... يبدو أن هناك كتبا لكل شيء.
مع انتشار الإنترنت أصبح هناك مواقع تعلّم صناعة المتفجرات والقتل والاحتيال والسطو على خصوصيات الناس. لم تعد المعرفة محتكرة، ومنها تلك المعرفة التي تبرّر كل شيء، حتى الخيانة، وتتستر عليها، واختراق الرقابة والأسرار الصناعية والحربية التي لها علاقة بالأمن القومي.
كان الهرب من العالم الواقعي أحد أسباب تعلقنا بالقراءة
قد تمدنا القراءة بالمعلومات والأفكار، ما ينتج معرفة، للأسف لا تعلّم الأخلاق، مهما استحوذت علينا قصص مكارم الأخلاق، وما تأمرنا به الأديان. هذه لا تعلمنا إياها الكتب، لكنها تنبهنا إلى حاجاتنا الروحية، والتحلي بالخصال الحميدة. الأخلاق تعني التغلب على ما زرع فينا بغفلة عنا، بالوراثة أو البيئة، والظروف القاسية، والغرائز والشهوات، واللهاث وراء المنافع، والطموح الأعمى إلى السلطة والتسلط، هذه لا يمكن التغلب عليها إلا بالعقل والمنطق، وطبعًا بالاستعانة بالإرادة. ومن الخطر أنه أحياناً يمكن الانسياق إليها بالعقل، فالمنطق مثلما يأخذنا إلى الحق، يذهب بنا إلى الباطل.
لن نعرف بالضبط لماذا نقرأ، ربما لو تذكرنا كيف بدأنا القراءة، لأدركنا وذلك حسب جيلي، أن هذه الغواية شابها سحر الغلاف الملوّن، وآزرتها رسومات القصص البريئة. كان تعلقنا بها كهواية في الطفولة بدأت مع سلاسل كامل الكيلاني، والمكتبة الخضراء، والترجمات المبسطة لكتب المغامرات، مثل الفرسان الثلاثة، والكونت دي مونت كريستو، وسجين زندا، وايفانهو.
المرحلة التالية كانت مع المصري حلمي مراد ومنشوراته “كتابي" و"مطبوعات كتابي". نحن مدينون لهذه السلاسل التي أشرعت لنا النوافذ على الأدب العالمي، فقرأنا بشكل مبكر لستيفان تسفايغ وبلزاك وفلوبير وبروست وجيد وطاغور وتورجنيف وروسو... و"دكتور جيفاكو" لباسترناك، وكان قد فاز بجائزة نوبل حديثًا. في الوقت نفسه قرأنا الروائيين المصريين يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس، كما تعرفنا إلى نجيب محفوظ وكانت رحلتنا الطويلة معه. كنا نقرأ كل ما يقع تحت أيدينا من المؤلفات والمترجمات المصرية واللبنانية، ولم نوفر الروايات البوليسية.
لم يكن هذا الاندفاع نحو القراءة إلا لإدراكنا أن بحرًا لا ينضب من المعرفة انكشف أمامنا، يضج بالمتعة. أصبح عالمنا أكبر، وبلا حدود. في الستينات والسبعينات من القرن الماضي أصبحنا على تماس مع ما يصدر حديثا في العالم عن طريق دور النشر اللبنانية والمصرية. لم نعد أسرى جدران عالم صغير، بعدما حلقنا بعيدًا في الماضي، وفي الوقت نفسه نعيش الحاضر بنكهة عالمية. عرفنا بلادًا قد لا نزورها، وربما لن نراها أبدًآ، وقرأنا ثقافات نجهل شعوبها، وتعرفنا على البشر من جميع الأنواع؛ العظماء والأشقياء والأتقياء واللصوص والسفهاء والحكماء العقلاء والمجانين والمنحطين... وتلمسنا من خلال الكلمات مشاعر الحب بأنواعه: العذري المخلص والوفي والماجن. والمشاعر الحافلة بالعواطف الجميلة، وتلك التي تغلب عليها الغيرة والحسد والكراهية.
قلّبنا صفحات الكتب بأمان، من دون الخوض في الحياة، وكأننا امتلكنا سلاحًا. عندما واجهنا الحياة، بدا جيلنا أعزل حتى من الكتب، ما الذي منحتنا إياه هذه المعرفة؟ لن نقلل من قيمتها، منحتنا ما لا يمكن للعائلة والمدرسة والجامعة منحنا إياه، وهو تأهيلنا لتفهم غرابة الحياة، ما دمنا لا نهمل الدوافع والأسباب، وأن نناضل ولو كنا مهزومين، وأن هناك ما يجب فعله دائماً، ألا نيأس، وأن نفهم الناس وجلائل الأعمال وأحطها... وأن كل شيء يمكن أن يحدث، وأن النفوس النبيلة مهما جار عليها الزمن لا تخنع لأحد. هل هذا ما جعل جيلنا يخسر الكثير؟ نعم، القضايا الكبيرة خسائرها كبيرة.
بدا لنا في بعض الأحيان، أن أحد أسباب تعلقنا بالقراءة، الهرب من العالم الواقعي إلى عالم من الأحلام والأوهام، مع الوقت أدركنا أنها كانت تساعدنا على تحمّل الوجود في هذا العالم، لولاها لكانت الحياة باردة وأشد قسوة.
* روائي من سورية