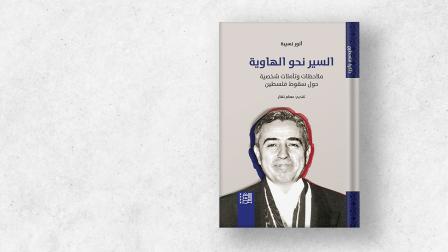لم يخالج فولتير الشكّ في أنه "لا يوجد إلّا منهج أخلاقي واحد، مثلما لا يوجد إلّا علم هندسي واحد". كان هذا في زمن التنوير، الذي رفع راية القيم العليا: الحق، الخير، الجمال، التي هيمنت على عصور متتالية، على الرغم من الطغيان المهيمن أيضًا، مع هذا كان في استمرارها على قيد الوجود انتصارٌ للعقل، كذلك الثورات لم تتقيّد بها ولا بما وعدت به، فسفك الدماء لم يأخذ بها، وإن استظلّت برايتها.
مع ظهور النازية والفاشية، وسيطرة الرأسمالية المتوحّشة، وتقاسمها العالم مع شيوعية الستار الحديدي والغولاغ، وما أثارته من نزاعات وتهديدات وصراعات في بلدان العالم الثالث، خلّفت كمًّا مروّعًا من الكوارث الإنسانية، أدّت إلى انحسار القيم الكبرى لعدم قدرتها على التصدّي، إن لم يكن الصمود، فالحروب العالمية، وانتشار الانقلابات، وجرائم السلطات التي تخطّت المجازر إلى الإبادة، ما تجاوز براءة عصر التنوير، إلى همجية سافرة، وضعت القيم في مأزق؛ ما الحق، ما دام لا حقوق للشعوب؟ أو ماذا بوسع الخير أو الجمال فعله إزاء أيديولوجيات أصبحت أديانًا تسوغ إعدام طبقات اجتماعية، أو أعراق، وحملة دين معين. والأخطر أنها باتت شموليات محصَّنة بأيديولوجيات، تتسارع في الانتشار، قد تفنى لكنها لا تموت ولا تتوارى، تداعت في القرن الحالي إلى دكتاتوريات رثّة، من فرط انحطاطها لا تحتاج إلى تغطية أيديولوجية، لا أكثر من شعارات من هراء، إلّا إذا اعتبرنا النهب والقتل والتعذيب أيديولوجية تصلح لعودتها المظفّرة إلى عالم تسيطر عليه القوة المطلقة.
انعكست مآسي القرن الماضي في الفكر والفن إلى انتشار عدمية، تبرّر كل شيء، نزعت القداسة عن قيم لم تعد مطلقة، وما تولّد عنها من ثوابت يقينية، ما دام مصدرها إنسانيًّا بحتًا، وليس إلهيًا أو دينيًا، لم يتزعزع الإيمان بها فقط، بل وشكّكت بالعقل صانع معجزات التقدُّم والحروب والاستعمار والرخاء.
أصبح الاعتقاد بالقيم الكبرى يفتقر إلى حامل لها
لا مندوحة من الاعتراف بأنّ القيم مصدرها الإنسان، لكن يجب الاعتراف، بأنّ مصدر الخير والشر هو الإنسان أيضًا، وربما في النظر إلى القيم على أنها منارات في الظلام تضيء عالمًا موحشًا، بما ترسمه من مساحات يتلاقى على أديمها البشر، يقدّم لها سندًا أخلاقيًا متينًا، لا فراغًا، يزجها في عصر من اللامعنى، يبيح تدمير الذات والعالم.
أصبح الاعتقاد بالقيم الكبرى يفتقر إلى حامل لها، وكأن الزمن عفّ عنها، ولا يؤهّلها بناء عالم جديد، متحرّر من ماضي أمجاد الانتصارات والرذائل والمحن، ما ذهب بالبشر إلى توقّع عالم غامض من الاحتمالات، لا يبشّر بخلاص، قدر ما يوحي بمخاوف، أصبحت بيئية ونووية. صار يُخشى من وقوع العلم في قبضة الأوغاد، فالعلم لا يفكّر، الإنسان هو الذي يفكّر، والجشع الذي يستهدف اجتياح العالم، يمنعه عن التفكير، عندئذ لن نخطئ أنّ العصر اللاإنساني بات على الأبواب.
تفتّق القرن الجديد عن أفكار دعائية لديها جاذبية برّاقة، تحاكي ما تأتي به موضة التقلبات، لا تعمّر أكثر من موسم، وربما شهر أو أيام، كما تقليعات الثياب، هذا إذا لاقت صدى، ولم تتكدّس في المستودعات. إن زج البشر في صرعات الأضواء، بدلًا من أمان واستقرار يتيحان للإبداع إمكانات ومجالات تساعد على تخليص العالم ممّا أهمله طويلًا: الفقر والجوع والمرض، وتقليص البون الشاسع المتضخّم بين الأغنياء والفقراء، فسوف يعاني البشر من فترات انتقالية، يراوح فيها بلا انتهاء، ليست دليلًا على الحيوية بقدر ما هي دليل على العجز.
ليست القيم ملابس تُبدَّل من فترة لأُخرى، بلا سبب إلا لتُخلع ويُرتدى غيرها. إنها تتجذر لتؤتي مفعولها ونتائجها، إنها بمعنى ما مكسب للبشرية ساهمت فيه على مدى قرون الأديان والفلسفات والعادات والتقاليد والأخطاء والزلات والخبرات الإنسانية، إنها خزّان البشرية، لا تُعيق عن التقدّم بقدر ما تساعد عليه، وما الشوط الذي قطعته الإنسانية، إلّا مادة تتعلّم منه دروسًا، يُحافظ عليها كي لا تتكرّر.
هل الأجدى، التفكير في قيم على المدى القصير وقيم على المدى الطويل، ما يحيلنا إلى قيم ثابتة وقيم متطوّرة؟ ربما في الاعتراف بأن القيم يجب أن تأخذ بالاعتبار تبدل الزمان وتغير الظروف، مصدر إثراء لها. فمثلًا، بالعودة إلى الجَمال، يمكن الحديث عن استخلاص مفاهيم عديدة، نابعة منه، أو تصب فيه، تماشي العصر، ولا تقصيه عنها، تتجاور من دون إلغاء، يغني أحدها الآخر. سلسلة متشابكة، تسمح بالتوالد وتعدُّد النظر، فالجمال ليس واحدًا، ولا موحَّدًا. مثلما يسمح الحق بالقانون وما يتولّد عنه، فما بالنا بالخير المضاد للشر بجميع أنواعه، هل ينبغي اقتصاره على شرور السحر، ولا يتعداها إلى الأسلحة النووية والكيماوية، والتهجير القسري، والإعدام...؟
في القول إن البشر بحاجة إلى تجديد الإيمان بالقيم الكبرى: الحق، الخير، الجمال، ما يفنّد التغاضي عنها، وعدم خسرانها بدعوى سذاجتها.
* روائي من سورية