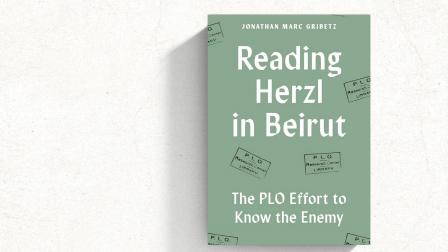ينطلق الكاتب السوري ربيع مرشد (1975) في روايته "سبردج: مذكّرات مستشرق"، الصادرة مؤخّراً عن "دار ممدوح عدوان"، من البيئة التي تَكوَّن فيها... من مدينته السويداء السورية أو من حيثُ "البلاد التي يتكلّم أهلُها لغة الوجع" وفق تعبيره. أرضٌ فقيرةٌ بائسة الموارد، تتّكئ على مطر السماء، إذ لا نهر فيها ولا ينابيع، لا زراعة متطوّرة، ولا صناعة ولو خفيفة. إلّا أنّ ما يُميّز الحديث عن البيئة المحلّية - بوصفها موضوعة اشتغال روائي عند مرشد - قدرتها على تضييع الحدود في المكان بين السحري والواقع، ذلك لما تحمله بطبيعتها من موروثات وسِير شعبية وحكايات، هي الشكلُ الأوّلي للرواية الحديثة.
يكتب صاحب "الكائن الخاسر ظلَّه" (عنوان مجموعته القصصية الأولى) عن البيئة، فيصون حكاياتِها وقيمَها من النسيان، وهو المؤمن على لسان بطل روايته يوسف (أو المستشرق الأميركي جوزيف) أنّ "الخلود هو الذاكرة"، وأنّ "اجتماع الكلمات في كتاب قد يغيّر تاريخاً أو يُسقط عرشاً". وصحيحٌ أنّ روايةَ مرشد مُغرقة في محلّيتها، إلّا أنّ هذا الإخلاص هو ما ارتقى بها إنسانيّاً. فلا يخفى الجهد الذي بذله الكاتب في الاطّلاع على المَراجع التي عاد إليها، وما أضاف من خياله حتى تبلورت الحكاية بلغةٍ سليمةٍ عالية.
سبردج هو اسم المرأة التي تحكي الرواية قصّتها، وهي حبيبة جابر، لكنّها زوجة ملحم؛ الباشا الإقطاعي الذي يشتغل جابر مرابعاً في أرضه. من هنا البداية، من حكاية حبٍّ كما كلّ حكاية حبّ، لم يُقدَّر لها أن تكتمل على الأرض فانتثرت روحُها حبراً في كتاب. تُغنّي سبردج بعد موتِ ابنها البكر، فيستنكر عليها ملحم زوجها: "أتغنّين يا سبردج، ألا تخافين الله؟! تراب سعدو لم ينشف بعد... يا أم سعدو!"، "نعم يا ملحم، أغنّي… يذهب الأحباب ولا يبقى سوى الغناء"، "أما زلتِ تحبّينه؟"، "إلى أن تُدفن عيناي تحت التراب".
يُفسح الراوي العليم لنفسِه موضعاً لسرد فصل الرواية الأخير
بعد موت ابنها الثاني، تخرس سبردج عن الكلام، ولا تستعيد النُّطق إلّا بعد ثلاث سنوات، حين حلّ ضيفٌ غريبٌ على دار زوجها، وحدست أنه رسولٌ من طرف حبيبها الذي حُرمت منه، فخرجت من خرسها فقط لتسأله: "هل هو بخير". وحين علمت أنّ ابنتها أحبّت الغريبَ، نسفت وصايا مجتمعها وشجّعتها على أن تهرب معه، كي لا تُعيد البنتُ حكاية أمّها.
كانت سبردج قد سألتْ جابر يوم جاء يخطبها: "هل من نبعٍ تحت دارك؟"، فأجابها مؤكّداً ومضيفاً: "أقسمه نصفين، واحد دمٌ والثاني دمع!"، وعدَها جابر بنبع الحبّ، ووعدها بأنه لن يهجرها إلّا بالموت، وغاب. أسلمه سيّده ملحم إلى العثمانيّين ليقتادوه إلى السفر برلك، لكنه لم يمُت ولم يبلَ حبّه لسبردج، فقد نجا ولجأ إلى مصر حيث اشتغل راعي خيولٍ عند ضابطٍ إنكليزي، لكنّ الحب ظلّ يشلّ عقله: "يهزّ علف الخيول فينتثر رُبعه، وتتعرّق يداه، ونظراته نظراتُ طائر تَعِبٍ يبحث عن شجرة في صحراء القفر".
جابر ليس بطل الرواية الأوحد، فبسلاسة وسبكٍ مُحكم، تسير الرواية على أربعة محاور، يتناوب السرد فيها بين يوسف المستشرق، وجورية زوجته، (وهي ابنة ملحم وسبردج)، وجابر العاشق، وموسى الصديق: "كان واحدهما للآخر نفساً تغازل ذاتاً، وذاتاً تهيم بعين وعيناً تتقد بروح"، ولعلّ هذه العبارة تعريفٌ للصداقة من منظور الكاتب.
قدم المستشرق جوزيف، أو يوسف الأميركي، إلى الجبل ظاهراً في مهمّةٍ حُكومية، وأبطنَ رغبته المؤرّقة في استكمال حكاية سبردج "لتصبح صالحةً للتأريخ"، فأبوه جابر لم يروِ له سوى نصفها. ولا تتفكّك خيوطُ الحكايات إلّا في أوانها، حين يُفسح الراوي العليم لنفسه موضعاً قصيراً يسدُّ ما تبقّى من ثغرات الحكاية في فصلها الأخير. وفيها نثرات من التاريخ منذ أيام محمد علي في مصر، إلى مفازات السفر برلك، والثورة العربية الكبرى، ورايتها التي رُفعت أمام دار الحكومة في دمشق قبل يومٍ من وصول فيصل بن الحسين إليها.
يملك مرشد لغتَه، يسرد برشاقة، وإن شابها قليلٌ من شعرية الوصف الذي بدا في مواضع قليلةٍ مبالغاً فيه. يسير القارئ في "سبردج" كأنّه يُصغي إلى صوتٍ عذب، موسيقاه متضمّنة فيه بلا آلات، وقد يطلع طبلٌ يهدر ثم يهدأ مع مراحل ترويض جابر للحصان الحَرون، كمشهدٍ لا يُنسَى في الرواية، أو يسمع صفيراً ناشزاً مع مشهد الجرذان التي تعاونت على جرّ البَيض المسلوق من مهجع المساجين إلى جُحورها.
رواية تدخل العقل بمنطقيّة حبكتها، والقلب من باب قصّة الحبّ؛ الحبّ بوصفه قيمةً إنسانيةً، كما تستفزّ الوجدان بقيم الشهامة والصداقة والوفاء بالوعد والشجاعة، بأن يغامر الصديق بحياته من أجل الوفاء بوعد، أو لإيصال أمانةٍ حلفَ ألّا يثنيه عن إيصالها إلّا الموت، وبِرّ بوعده وهو الذي لم يعد عليه رقيب... وبالأخوّة كقيمة، إذ لا تدمع عينُ جورية إلّا حين يأتي ذِكرُ أخويها القَتيلَين. هذه الفكرة التي كم أصبحنا نمرّ عليها عابرين، فتأتي روايةٌ لتعيدنا إليها.
عذوبة السرد وحدها ما يكبح إيلام الأحداث في الرواية، سرد يملأ القارئ جمالياً وإن روى له سيرة الألم، فيرى نفسه هنا أو هناك شبيهاً بإحدى شخصياتها، أو يتمنّى لو أنّ في حياته حكايةً تشبهها، أو لو أنها إحدى ذكريّاته الشخصية.
بكلمات أخيرة، اقتباسُ كافكا الذي استهلّ به الكاتبُ روايته: "الأشياء التي نحبّ معرّضةٌ للفقدان دوماً، لكنّ الحبّ سيعود دوماً بشكلٍ مختلف"، لم يكُن مجرّد اقتباس عرضي تُوقَّع به الصفحة الأولى وحسب، إنّما ظلّ حاضراً على امتداد الحدث، فكرةً واحدةً صلبة قامتْ عليها الرواية بأسرها.
* كاتبة من سورية