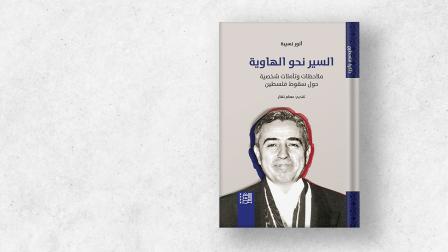لوحة للفنانة الأميركية أنابيل لي واشنطن (Getty)
في الرابع والعشرين من شهر مايو/ أيار عام 2003، قرر "الحاكم المدني" الأميركي بول بريمر، السفير السابق، وسليل الشركات الاستشارية الأميركية - من إحداها شركة يرأسها السياسي الثعلبي ووزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر - حل الجيش العراقي.
وعنى ذلك عمليًا، تسريح عناصر جيش قوامه أربعمائة ألف عسكري، وقيل وقتها إن بريمر نفسه سينشئ جيشًا آخر من قوام الجيش المنحل، ويكون تعداده مائة ألف. ذاك الخبر الذي تصدّر غير ما منبر إعلامي واستدعى تعليقات محللين سياسيين واستراتيجيين ينبتون كما الفطر فجأة، ويكونون جاهزين غب الطلب الإعلامي. التعليق يدور في فلك "مع وضد"، أما الخطوات التنفيذية بالتسريح وفقًا للرتبة العسكرية، والحرمان من مكافآت نهاية الخدمة، وغيرها من الأمور والتفاصيل، فستشكّل بمجموعها مدونّة هائلة من الوثائق. أين الوثائق؟ أهي مفهرسة؟ هل من الممكن الاستناد إليها لكتابة التاريخ؟
حُلَّ الجيش العراقي بأمر من المحتل الأميركي، وخلال سنين تالية ظهرت جماعات عسكرية وتنظيمات متفرقة، فقيرة في الانضباط، غنية بالطائفية، قليلة التمركز حول ما هو "وطني"، معجبة بالهويات الضيقة التي تعلي من شأن كل ما هو عرقي/ مذهبي "صافٍ" درءًا للدولة.
البلد الذي لوّح له العم سام بالديمقراطية، على إيقاع تلويح وزير الخارجية الأميركي وقتها كولن باول، بأنبوب زجاجي في جلسة أممية من النوع الطارئ، باعتباره دليلا ماديا على "أسلحة الدمار الشامل"، لم يرَ إلا ديمقراطية من النوع الفاخر: مفخخات وقتل على الهوية، وتقافز محموم للتعصب والمذهبية، وتألق وقح لشهية الانتقام، وغيرها من الأمور الشريرة التي أبدعها الإنسان. وصل الشر إلى ذروته عام 2006، الذي شهد أكبر عدد من الضحايا العراقيين.
في المقلب الثاني، ثمة ثقافة وتدوين يعكس بشكلٍ جزئي ما جرى. لا مجال لقول كل شيء؛ نتف وأجزاء فحسب، فحيال زلزال مماثل، تتشظى الثقافة ما بين الإخبار والتوثيق وصولًا إلى رواية الأمور من ناحية أخرى، ناحية الناس. وفي مقام الحديث عن الجيش، ثمة قصيدة للشاعر العراقي خزعل الماجدي: "كم مرّة نؤسس جيشاً؟/ وكم مرّةً نعرّضه للهزائم؟/ كم مرّة نستعمله ضدّ أهل البلاد؟/ كم مرّة نحلّه؟/ كم مرّة نربطه؟/ جيوش... جيوش/ كلّ تاريخنا جيوش... أو بقايا جيوش". تغري القصيدة بتحليل اجتماعي تاريخي، أكثر من أي شيء آخر. بضع جمل فحسب، وإذ بها تعزف على وترٍ عربي نعرفه عن ظهر قلب: الدولة - الأمة، ووصفنا لها: الدولة القومية. نعرفها تلك الدول العربية، لن نقول أسماءها، لن ننظر في الخريطة. وقد نشيح بوجوهنا أصلًا، إذ إن الارتباط بين نشوء الدول وتأسيس جيوشها، ارتباط وثيق كما لا يخفى. لكنه كان يخفى على ما يبدو، ثم ظهر مثل صفعة مدوية: حُلّ الجيش، فاختفت الدولة.
ليس المقام هنا، لمديح الجيوش، بل للتأمّل، كما يفعل باحث لامع مختص بالجيوش، وينزّه نتائج بحثه من جيش لآخر؛ بعد السؤال عن الجيش العراقي وزيارة "قصته"، يستطيع السؤال عن الجيش السوري مثلًا، ثم عن الجيش المصري مثلًا آخر. وقد يوسّع دائرة النظر، لينظر في الجيش الأميركي، الذي "كفّ" أو "تعفّف" على ما يبدو، عن التنزّه خارج حدوده، نزهةً من النوع العراقي، وابتكر نزهات أخرى. ثمة جيش آخر، جيش احتلال يسمي نفسه جيش الدفاع، و"يتميّز" أفراده بانضباط من نوع خاص: انضباط المجرمين.
مفارقات على مدّ النظر، تلوح عند التنزه من جيش إلى آخر، والتأمّل في نشوئه، تأسيسه، مساره، مآله. ومن وراء ذلك، صورة الدولة أو الإمبراطورية: صلبة صلدة، مفككة مهتزّة، إلى آخر المفردات. ومن أجل التنزه في مشوار الجيوش، لا بدّ من وثائق من كل نوع: مدونة، غير مدونة. شفهية. مصورة. مسجلة. أوراق رسمية وأخرى سرية. أمور لا يجب تدوينها؛ دسائس ومؤامرات ومكائد. أمور لا بدّ من تدوينها؛ عدد الجنود، عدّة الجنود، صحة الجنود، انضباط الجنود، رتبة الجنود إلى آخر السبحة.
من أجل التنزه في مشوار الجيوش، لا بدّ من وثائق. أين الوثائق؟ أهي مفهرسة أم لا؟ هل من الممكن الاستناد إليها لكتابة التاريخ؟ أي تاريخ؟ الرسمي طبعًا، لكن فقط في أوّل الأمر. ومن بعد أوّله، يصير للوثائق بريقٌ من نوع خاص: ما الذي لا تقوله؟ ما الذي تصمت عنه؟ إذ قد يكون الباحث مشغولًا بأمور أخرى. أمور تحفّز التفكير، وتجلو طبقات مختلفة للتاريخ الرسمي. كذا تكون النتيجة، الانحراف عن السائد، وإعادة النظر، وبدء السير على دربٍ جديد تقول نقاشًا من نوع مختلف. نقاش يثير الجدل، يعطي النقد مكانةً عالية في التفكير وفي العمل أيضًا، والأهم أنه يوسّع زاوية النظر. كذا تكون النتيجة من بعد قراءة كتاب ضيف هذا العدد، المؤرخ المصري خالد فهمي: "كل رجال الباشا".