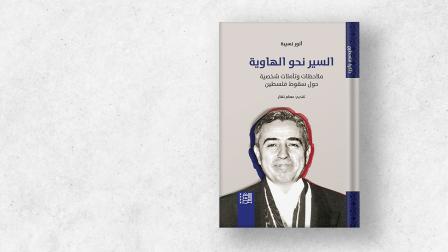ولكنَّ الكتاب، في حقيقة أمره، حجرُ أساس للفصل بين الديني والسياسي في هذه التجربة الرائدة، ليكونَ بذلك أوَّل من دشن هذا المبدأ في الفكر الإسلامي الحديث برمته. وتتألف هذه الرسالة، من ديباجة ذَكر فيها الشيخ مصادره وأهمها "مُعين الحكّام" للطرابلسي (1080-1153)، و"الأحكام" لشهاب الدين القرافي (1228-1285)، وفيه قدَّم تعريفاً أصيلاً للسياسة الشرعية.
وخصص الفصل الأول لبيان مشروعية السياسة باباً من الأحكام الفقهية، مستنتجاً أنها نوعان: "سياسة عادلة تستند إلى الشرع، وظالمة تتعارض معه". وفي الفصل الثاني قارن الفقيه الحنفي، بين صلاحيات الوالي وصلاحيات القاضي، وفصَّل القول في الاختصاصات الواسعة التي يجب أن يَتمتع بها الولاة دون القضاة، مثل: سماع الشهادة، وتحليف الشهود واستدعائهم، ومراعاة شواهد الحال، وتعجيل حبس المتهم وتعزيره. وهي أمورٌ لا تدخل في صلاحيات القاضي.
وتناول المؤلف في الفصل الثالث، الدعاوى بالتهم وقسّم فيه المُدعى عليهم إلى ثلاثة أقسام: متهم ليس من أهل التهم ولا تجوز عقوبته اتفاقاً، بل على الحاكم أن يؤدِّب من رماه بذلك، صيانةً له عن تسلط السفهاء. ومتهم مشهور بالفجور، ينظر في أمره. والأخير متهمٌ مجهول الحال، يحبس حتى ينكشف حاله. فيما خصص الفصل الأخير للحسبة كوظيفة اقتصادية.
وهكذا، سعى المؤلف من خلال عرضه التدريجي (ديباجة، مقدمة، فصولٌ أربعة وخاتمة)، إلى ضربٍ من التشريع المقاصدي لنفوذ أصحاب السلطة المركزية، حتى يقلص سلطانَ علماء الدين، فلا يكونوا حجر عثرةٍ أمام مراقبة المجتمع ومحاربة الفساد فيه.
ولئن اقتبس الشيخ كل المعلومات من كتب سابقيه مثل ابن تيمية (1262-1328)، وابن قيم الجوزية (1292- 1349)، فإنه أعاد تأويلها على ضوء بدايات حضور الفرنسي والإنكليزي في ديار الإسلام، وهو حضور يهدف إلى فرض الرأسمالية في أنماط الإنتاج بالولايات العثمانية. فهو حين رأى، بحسه الواقعي، أنَّ تلك التحولات، وإن كانت بطيئة، طاولت المجتمع التونسي، انبرى يُشرِّع لها وللسلطة المركزية حتى تلعب دوراً رئيساً في استيعابها. ومن مظاهر تلك التغيرات احتدام التفاوت الاجتماعي، والتباين الجهوي، وتطور التبادل التجاري، وما يتبعه من استشراء المخالفات.
وقد كان التعامل مع هذه الظواهر، طيلة القرون الوسطى، يتمُّ عبر سلطة المجلس الشرعي، الذي كان يطيل إجراءات النظر في النوازل، بسبب تعقد الإثبات الجنائي، مراعاةً لمبدأ "تُدرأ الحدود بالشبهات"، فضلاً عن تعطيل العقوبات عند غياب الدليل، واعتماد وسائل تحقيق بدائية في تأكيد الجناية أو نفيها مثل الفِراسة والإقرار اللفظي والقرائن الحالية. فنادى الشيخ بتجاوزها جميعاً، محدثاً قطيعة في الممارسات القضائية، يسند فيها الدور الأكبر للدولة وأجهزتها وشرطتها، لا لرجال الدين ومُساعديهم.
ولا ينبغي لهذه الاعتبارات الفقهية، أن تحجب عنا الرهانات المعرفية التي حملتها هذه الرسالة. وتكمن أولاً في توسيع مفهوم السياسة، التي يجب أن تشمل كل القرارات والإجراءات التي قد تتخذها الدولة المركزية لمراقبة المجتمع وتسييره، دون الرجوع إلى القضاء الشرعي-الديني، واعتبار هذه الخيارات، مع ذلك، "شرعية"، لأنها تراعي مصلحة الأمة وتحققها على الوجه الأنجع. وتكمن ثانياً في بلورة البدايات الأولى لقانون جنائي وضعي، تبنيه الدولة، بما لها من صلاحية دفع الضرر وجلب المنفعة. وأخيراً، يسمح هذا التنظير بصياغة قوانين سياسية وقضائية، تتطور من داخل المؤسسة الدينية، (وهي في حالتنا جامع الزيتونة وهيئاته العلمية). يجري الإصلاح المؤسساتي من داخل المنظومة الفكرية، بالاستناد إلى المقولات الفقهية والأصولية، ولا يسقط اقتباساً من الغرب أو فرضاً بقوة القهر.
على أنَّ أكثر ما يلفت في هذه الرسالة، مناداة بيرم الأول بالتوسعة على الحُكام في السياسات، مع التأكيد أنَّ تَحَرُّرهم من سلطة الشرع لا يُخالف الشرع، بل بالعكس ينضوي في مبادئه ويحقق مقاصدَهُ. ويدعم رأيه هذا بذكر عديد الأعمال التي قام بها الصحابة لمطلق المصلحة، مع أنَّ الرسول لم يقم بها، ويخلص إلى مطالبة الحُكام بضرورة تطوير سياساتهم، بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة، وهذا من إرهاصات الفصل بين دائرتَي السلطة والدين.