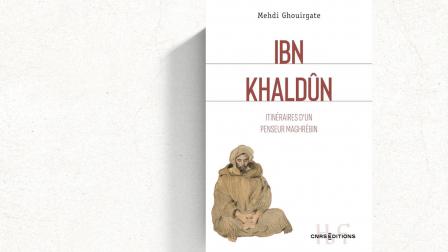ظاهر كتاب "الإسلام وأصول الحُكم" بحثٌ تاريخي، أنجزه القاضي علي عبد الرازق (1888-1966)، بعد أن أتاحت له وظيفته، في المحاكم الشرعية المصرية، الاطلاعَ على سير العدالة ومصادر قوانينها. فخَلُص إلى أن القضاء الإسلامي ما هو إلا مؤسسة بشرية، لا قَداسة فيها. ثم قاده استنتاجُه إلى التحقّق من مدى دينية الأساس الذي قام عليه القضاء، وهو نظام الخلافة، فغاص في الأدبيات السلطانية، وكُتب السيرة ودواوين الفقه وعلم الكلام والحِسبة.
توصَّل عبد الرازق إلى إعادة بناء المراحل التاريخية لتشكّل الخلافة وامتدادها طيلة ثلاثة عشر قرناً، ملاحظاً أنَّ هذا النظام الذي رسم كيفيات الحكم وإدارة الدولة، طيلة العهود الأموية والعباسية والعثمانية، لا أصلَ دينيَّ له، لا في القرآن ولا في الأحاديث القطعيَّة.
وبالاعتماد على هذين المصدريْن، وقد استعادهما مناقشةً وتأويلاً، بَيَّن عبد الرازق أنَّ ما أضفى صفة القداسة على الخِلافة إنما هو تنظير الفقهاء اللاحق، ومبالغات كُتَّاب السلطان، وقد سعى بعضهم إلى الحفاظ على امتيازاته، ونقل بعضهم الآخر التمثلات الساسانية الفارسية التي كانت تحيط الملوك بهالة أسطورية.
وللبرهنة على هذه الأطروحة الجَريئة، رغم تعقّد أدلتها، قَسَّم المفكّر المصري كتابَه، وهو في مائة صفحة، إلى ثلاثة أبوابٍ كبرى: اهتمَّ في الجزء الأول منه بعلاقة الخلافة بالإسلام نصوصاً (قرابة الأربعين صفحة)، واعتنى في الثاني بشكل الحكومة في الإسلام (40 صفحة أخرى)، وخصّص الباب الأخير لدراسة الخلافة والحكومة في التاريخ، أي كما مورست في الواقع الزمني (20 صفحة الأخيرة).
وقد استقصى، من خلال هذه الأبواب وفصولها الفرعية، العواملَ التاريخية والثقافية لنشأة مبادئ السياسة في الإسلام مثل: الخلافة، الإمامة، المُلك، الحُكم والدولة... وما رافق تلك النشأة من إضفاءٍ بعديٍّ لشرعية دينية على ممارساتٍ، كانت في أصلها مجرّد أجوبة مرتجلة، لغياب النبوة.
صدر الكتاب سنة 1925، أي بعد سنتيْن من تفكك الخلافة العثمانية، فكان بمثابة تحليقٍ لطائر المنيرفا، الذي ذكرَ هيغل أنه لا يأخذُ في الطيران إلا عند الغروب، إذ لم يتصدَّ عبد الرازق إلى جذور الخلافة إلا بعد أفول السلطنة العثمانية التي كانت رمزها الأخير، فكان بحثه حفرياتٍ معرفيَّة، حَسب التحديد الفوكوي، جَلَّى فيه طبقات هذه المؤسسة ومفاهيمها، بعد أن أطلق عليها كمال أتاتورك رصاصة الرحمة. كما كانت تحاليله تشريعاً بعديّاً لهذا السقوط، ربما هدفَ إلى طمأنة جمهور المسلمين أنَّ ما ظنوه ركنَ الدين الأعظم (الخلافة)، لم يكن سوى نظام بشريٍّ، نشأ رداً على صدمة غياب النبوّة من التاريخ، ومن ضرورة إنفاذ الحُكم، حتى "لا يَظَلَّ الناس فَوضَى لا سَرَاةَ لَهم".
فكان أن رُمي هذا المؤلِّف بخَرْق إجماع الأمة، وسَحَبَ منه الأزهر شهادَة العالِمية. كما جوبه بنقدٍ لاذعٍ، وَجَّهَه إليه علماء الأمة وقتَها في معركة ثقافية منقطعة النظير، فردَّ عليه رشيد رضا، حامل لواء الإسلام السياسي، ورَدَّت عليه هيئة كبار العلماء في مصر المكوّنة من أربعة وعشرين فرداً، وناقشه علّامتا تونس: محمد الخضر حسين، والطاهر بن عاشور.
أثبت عبد الرازق غياب أي دليل على قدسية تنظيم الدولة في الإسلام، مبيّناً أنَّ الله قد ترك الحرية للمسلمين في إقامة الهيكل الذي يختارون، شريطة أن تتحقق المقاصد الكليَّة كالعدل والحرية، فَغرس بذلك أولى بذور العلمانية التي تُخرج الدين من حقل الشأن السياسي، وتجعل السلطة رهاناً دنيوياً بالأساس، لا يخضع سوى لسلطان العقل وإن تاهَ بَين متاهات الجمهوريات والمَلكيَّات.
* "صدر قديماً"، زاوية جديدة في القسم الثقافي لموقع وجريدة "العربي الجديد"، تختص بتقديم قراءات في كتب قديمة صدرت باللغة العربية وما زالت تنبض بالراهنية.