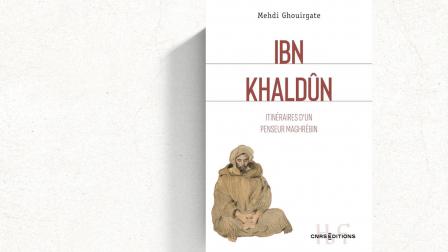في منعطف حاسم بين مرحلتيْ التقليد الأدبي والتجديد، تأكّدت ضرورة إنشاء علم مبتكر، كفيل باقتفاء مظاهر الجمالية المستحدثة في النصوص، تلك التي تجلّت في إيقاع القصائد الحرّة، ووجدانية الروايات الرومانسية وكثافة الحوارات المسرحية، سياسيّها واجتماعيّها، وغيرها من مظاهر الإبداع في أجناس الكلام التي استجدّت إثرَ اتصال العرب بالآداب العالمية.
حينها، أدرك نَقَدةُ الكلام أنَّ البلاغة، جهازاً مفهومياً لاستنطاق "مواطِن الجودة والميزة"، لم تعد قادرة على الإحاطة بسَرَحات الخيال وانعتاق القلم حين يخوض في رمزية إبداع مغايرة، انبثقت من متغيّرات العالم الجديد بعد أن دكّته حربٌ كونية أولى، وأشرف وقتها على ثانية أفظع وأعتى.
انقلبت موضوعات الأدب رأساً على عقبٍ، وقطع أصحابه مع "البكاء والاستبكاء ووصف الراحلة"، وتناول أغراض الشعر بعد أن حصرها قُدامة بن جعفر في تمجيد الفضائل الخمس: العقل والشجاعة والنجدة والحلم والكرم. كما قطع الأسلوب مع المجازات الباردة كتشبيه المحيا بالقمر، والبديعيات المُتكلّفة.
كان من أوائل من فطن إلى هذا المنعطف وعبَّر عنه بوضوح أستاذ الأدب القديم أحمد الشايب (1896-1976)، الذي ولد وعاش في مصر. فبعد إنهاء التعليم العام، التحق بمدرسة "دار العلوم" في القاهرة، ليبدأ حياته العملية سنة 1919 كمدرّس ابتدائية، وانتقل إلى الإسكندرية يدرّس اللغة العربية حتى 1929، وبعدها إلى "كلية الآداب" بـ"جامعة فؤاد الأول"، حيث تدرّج في عمله إلى أن أصبح وكيلاً للكلية وأستاذ كرسي الأدب العربي حتى رحيله.
كما كان الشايب يمارس الشعرَ ويعرف مضائقه، فقد أنشد لثورة 1919، وصاغ قصائد نشرت في الصحـف، ومنها "إليك يا والدي". كما أجاد في فن التراجم الأدبية حيث حبَّر سيرة شاعر الحكمة زهير بن أبي سلمى، وأخرى لعلي بن أبي طالب، وللشريف الرضي، وجرير والأخطل، والبهاء زهير، ولأستاذه محمد عبده. كما خصّص كتباً للنقد الجمالي، منها: "أصول النقد الأدبي" (1940)، و"تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني الهجري" (1945)، و"تاريخ النقائض في الشعر العربي" (1946).
وتظلّ أهم مؤلفاته بلا منازعٍ كتاب: "الأسلوب، دراسة بلاغية وتحليلية لأصول الأساليب الأدبية" (1939)، الذي شكّل تحوّلاً فعلياً في درس الظاهرة الأدبية. فقد قسّم هذا الكتاب إلى خمسة أقسام: خصّص الأول منها لعرض مقدّمات عامة، أشبه بتأريخ متدرّجٍ للبلاغة، هذا العلم الذي "لم ينضج ولم يحترق"، مؤكداً الضرورة القصوى لإنشاء علم بلاغي جديد.
ويركز ثاني الفصول على التعريف بالأسلوب حسب المناهج الغربية، وحسب كتب النقد التراثية، ويخلص في الفصليْن المواليَيْن إلى علاقة الأسلوب بالموضوع الأدبي المصوَّر، ثم علاقته بالكاتِب المنشئ، ودرس في الأخير خصائص الأسلوب وسماته التمييزية التي تضفي على نصٍ ما هويّتَه الجمالية.
في هذا الكتاب، يبني الناقد المصري نظريته على ما ساد وقتها من الفلسفات التحليلية، التي انصبّت على تحليل أجناس الخطاب وخاصياته الجوهرية، التي تميّز ما هو أصيلٌ في الأدب عمّا هو مغايرٌ له، جرياً على تقسيمات الفلاسفة الإنكليز ولا سيما برتراند راسل (1872-1970)، لوظائف الكلام إلى إشارة وإثارة: أي بين الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي، باعتبار أنَّ الأول يُبنى على المعارف الذهنية، ويستعمل لغة العقل التي تُعنى باستقصاء الأفكار من أجل خدمة المعرفة وإنارة العقول.
ولذلك يجري التوسّل بألفاظ وعباراتٍ واضحة دقيقة، محدّدة معانيها، لا تحتمل التأويل. كما يستخدم هذا الخطاب العلمي المعادلات الحسابية ذات الطابع المجرّد، الذي يأبى التكرار والغموض.
في مقابل ذلك، يقوم الأسلوب الأدبي على الانفعال المشبوب وتصوير العاطفة الجياشة. ونرى في هذا التحديد تأثير الرومانسية العربية التي قادها أدباء المهجر وحركة أبولّو وقتها. فهو خطابٌ يتوسّل بلغة العاطفة ويُعنى بقوة الانفعال، يهيج المشاعر ويؤثّر في القلوب ليَعطفها على القيم، ولذلك كانت الألفاظ فيه فخمةً، تراعي جمالية النغم وتناسب الإيقاع. وهي إلى ذلك عبارات توغل في الخيال وتتزيّن ببدائع الصنعة، حيث تُخرج المعنى الواحد في صور بيانية متباينة.
قاد هذا التمييز بين وظيفتَيْ الإشارة والإثارة إلى دور جديد، أسنده الشايب إلى البلاغة حتى تصير بحثاً عن طريقة في الكتابة تراعي من جهة أولى الفكر بما هو معنى عقلي تدلّ عليه العبارة، ومن جهة ثانية العاطفة بما هي ضامن للبعد الوجداني في النص، وإلا استحال الأدب علماً أو تأريخاً، مع تأكيد خصوصية وسائل التعبير فيه، تلك التي تضمن نقل الفِكَرِ من الضمير إلى الخطاب.
ولذلك خَصّص المؤلف الجزء ما قبل الأخير للأسلوب باعتباره طريقة الكاتب أو الشاعر في اختيار الألفاظ وتأليف الكلام، وهو ما يتّفق مع تعريف الأسلوب، عند الغربيّين، بكونه "الإنسانَ ذاته" وقد عبَّر "عن قطعةٍ من قلبه".
كما تتضح خواص الاختيار اللفظي من خلال التمييز الصارم بين لغة النثر ولغة الشعر، والثيمات التي تناسب طبيعة كل واحدٍ منهما، إذ لكل فنٍ موضوعاتٌ تقتضي أسلوباً معيّناً يتماشى مع وظيفته: فالنثر يميل للإفادة، في حين يميل الشعر إلى التأثير.
كان كتاب "الأسلوب" بمثابة إعلان وفاة للبلاغة القديمة، سجّل فيه الشايب عَطالَة مفاهيم هذا الفن عن إدراك الخصائص الأدبية للأجناس المستحدثة، كالرواية والملحمة والمسرح والقصيدة الجديدة. ولذلك دعا إلى إحيائها عبر بثّ روح الأسلوبية الغربيَّة، واستخدام مختلف مناهجها الإحصائيَّة والسردية والتخييلية. وهكذا فتح المجال واسعاً لبعث الروح في جهاز مفهومي مترهّلٍ، ورفده بمناهج الجمالية الحديثة، ليكون كتابه أول لبنة في نقل المقاربة الأدبية من الذاتية إلى الموضوعية.