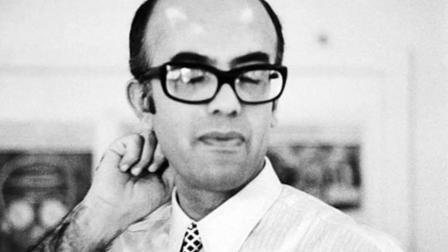أدخِلتُ مع الأطفال إلى الفناء الخلفي من الدار، كان الخروج ممنوعاً علينا حتى ينتهي الأمر، لكنني خالفت القانون ومددتُ رأسي. ثلاثة رجال يجرون الكبش، في يد أحدهم تلمع سكين ضخمة، شمس الصباح تغطّي ورق الدالية وبقايا الماء على سطول الورد، الكبش يعاند، لكن زنود الرجال تطرحه أرضًا، وضع القصاب السكين على عنقه، وأمسك به الباقون؛ باسم الله.. الله أكبر. لا أنسى ما حييت صرخة الحيوان المذبوح، كانت تجمع أوجاع العالم، صرخة ما زالت محفورة في عقلي إلى اليوم، كلّما تذكرتها أتلمس عنقي وتنتابني قشعريرة المحكوم بالإعدام.
محلات اللحم "الحلال" تملأ باريس، ثمّة سباق على بيع اللحم المذبوح حسب الطريقة الإسلامية، هو الأكثر رواجًا كما يبدو، كلما مررت أمام "مجزرة إسلامية"، أرى النبي إبراهيم وتتناهى إليّ صرخة خروف ذُبح بالنيابة عن ابنه إسماعيل، وبجانب كلمة "حلال"، أرى سكاكين تنظيم داعش، لكن ما العلاقة بين جريمة الذبح وبين أن يمارَس هذا الفعل لتأمين القوت البشري؟
كثيراً ما كان الذبح رديفًا للاحتفال والكرم عند العرب، من عادات البدو بذبح الشاة للضيف إلى عيد الأضحى، مع أن للبشرية تاريخًا حافلًا بإعدام الناس ذبحًا. سبق وأن اخترع الطبيب الفرنسي "غيلوتين" المقصلة، وأرَّخها بعبارته الدعائية : "مع آلتي هذه، بلحظة واحدة سأقطع رأسك، ولن تعاني". حصدت آلته مئات آلاف الأرواح، وكانت لعبةَ "روبيسبيير"، رمز المقاومة الفرنسية ضدّ الملكية، فبعد أن أعدم بها ملوك القرن الثامن عشر، استمرّ بإصدار أحكام الإعدام على "خائني الثورة"، الذين لم يكونوا في الحقيقة سوى أعدائه الشخصيين. ثمّ اقتربت المقصلة من رقاب أعضاء البرلمان الفرنسي، بل من رقبة "غيلوتين" نفسه. حينها أمسك الجميع رأس "روبيسبيير" وأدخلوه في الآلة الرهيبة.
في أوروبا تكثر تماثيل رؤوس الفلاسفة والشعراء والمجرمين أيضًا، ثمّة تمثال من الشمع لرأس "روبيسبيير" في متحف مدام "توسو" في لندن، بالمقابل نرى تمثال رأس "نفرتيتي" في متحف برلين، ذلك الرأس الذي أصبح رمزًا حضاريًا لألمانيا كما هو لمصر. لكن الزائر السوري، الذي شوّهت الحرب ذائقته، يتذكّر، حين يرى هذه التماثيل، تلك الرؤوس المعلّقة في ساحات مدينة الرقّة أو قرب الفرقة17، التي قطعها "داعش".
على مرّ العصور، بقي الرأس رمزًا للجمال أحيانًا، وللفجيعة أحيانًا أخرى، لكن ثمّة أمثلة قليلة للتماثيل التي تمتزج فيها أعلى درجات الوحشية بأكثر الفنون إدهاشًا، كما في قصّة "ميدوزا". ففي الأساطير اليونانية كانت "ميدوزا" بنتًا جميلة، مارست الجنس في معبد "أثينا" خِلافاً للتعاليم، فانتقمت منها الآلهة بأن جعلت ضفائرها ثعابين، ثم قطعت رأسها وأهدته إلى "أثينا".
تسود المدنَ التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" ما يمكننا أن نسمّيه بـ "سوريالية الجريمة". ليست هذه السوريالية إلا استكمالاً لمسيرة تاريخية بدأت برأس "الحسين" الذي وُضع في "متحف الثأر" قبل أكثر من ألفٍ ومائة عام، لتبقى عبارة: "يا سياف.. اضرب عنقه"، شعارًا للخلفاء والولاة خلال الدولة الأموية وما بعدها، لا سيما الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي ابتدأ ولايته على العراق بخطبته الدموية الشهيرة "إني لأرى رؤوسًا أينعت وقد حان قطافها، وإني لصاحبها".
لم يسبق أن مارس أحد في التاريخ عملية الذبح الداعشية باستثناء الخوارج، فقد جاء في المرويات التاريخية أنهم ذبحوا الصحابي، عبد الله بن خباب، كما تذبح الخراف، وقد يكون للأمر صلة بالمرجعيات التاريخية لـ"داعش"، فكلاهما يتقاطعان في محاربة الجميع وتطبيق أقسى طرق القتل، لذلك لم يكن غريبًا أن يبدأوا مسيرتهم المرعبة بتحطيم رأس المعري، فذلك الرأس الرمز لـ "إمامة العقل" مناوئ ندٌّ لـ"ثقافة الذبح"، لكن الجريمة الكبرى التي ارتكبها "داعش" كانت بتدريب الأطفال على قطع رؤوس الدمى، تمهيداً لتحويلهم إلى آلات ذبَّاحة في المستقبل. فعلى الطفل أن يقطع رأس اللعبة ويضعه فوق جثتها محاكاة لأفعال "الدولة". الذبح إذاً لا يقتصر على الواقع بل يتعداه إلى المخيلة والمحاكاة، التي كانت مهد الفن منذ آلاف السنين، هكذا أتذكر ذلك الكبش الذي رأيته في طفولتي، وإذا كانت صرخته لم تفارقني حتى اليوم، كيف سيفارق أطفال سورية والعراق ما يرونه من ذبح البشر؟