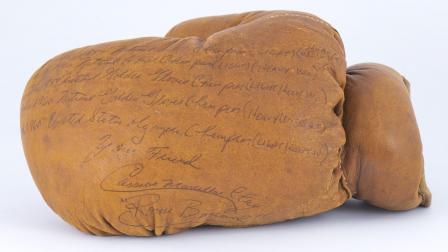لوحة للفنان بهرام حاجو
لم أتمكن من مشاهدة الفيديو الذي انتشر أخيراً حول قيام عناصر من الأمن السوري بتعذيب صبي حتى الموت، لأنهم عثروا على تسجيل لأغنية القاشوش في هاتفه، لكنني سمعت وقرأت الكثير من التعليقات والتحليلات حوله. ومنذ يومين فقط، عبر أمامي شريط يظهر فيه شاب من بلد عربي مجاور، يهدّد ثلاثة أطفال بسكين يشهرها في وجههم، بأنه سيقطع رؤوسهم وأيديهم. الأمثلة عن التعذيب حتى الموت، والتهديد بالقتل، والقتل، صارت كثيرة، ولا يمكن حصرها، تحتاج إلى مراكز توثيقية وجهود مؤسساتية جماعية.
لو كان أيا منّا مكان عائلة هذا الصبي الذي مات تحت التعذيب، أو لو أن الصبي ذاته كان قد نجا من الموت، فإنه يجب ألا يدهشنا تحوّله إلى قاتل فيما بعد، وهذه ليست دعوة إلى القتل والانتقام، بقدر ما هي عرض لفكرة مجانية القتل. حين لا يُعاقب القاتل، يصبح القتل وسيلة عادية للعيش، وينتصر قانون الغابة.
حين يتأكد هؤلاء الذين يعيشون ضحايا للعنف اليومي، والقتل العشوائي، من نجاة القاتل من العقاب، كيف يمكن توقّع ردودهم في مرحلة النجاة، إن نجوا؟ إذ، كما يقُتلون عشوائياً، ويموتون مصادفة، نتيجة تواجدهم في مكان ما، في لحظة ما، تحت نيران طرف ما، سواء الذين يموتون في بيوتهم، قصفاً بالبراميل، أو الذين يموتون في بيوتهم، بقذائف عشوائية، كما هم ضحايا عشوائيون، يمكن أن ينجوا مصادفة أيضاً.
كيف سيتعامل الناجون مع فكرة غياب العقاب. تلك الفكرة التي نشأت عليها البشرية، منذ العقاب الأوّل لآدم وحواء، ثم عبر تأسيس فكرة الجنة والنار، لتبدو حالتا العقاب والثواب، بمثابة ثوابت ذهنية، أدّت إلى نشوء أعمال مهمّة في الأدب العالمي، تركز على العقاب وتجلياته بصور عديدة، حتى تصل إلى مناقشة العقاب أو غيابه، كصيغ عدمية أحياناً.
فمن الجريمة والعقاب لدى ديستويفسكي، حيث العقاب ذاتي، وإلى المحكمة لدى كافكا، حيث تماهي المحكوم عليه مع حاكميه، ضمن اختيار لا شعوري للمحاكمة، كثيرة هي الأعمال الأدبية التي ركّزت على مفهوم العدالة، وإحقاق الحق، عبر العقاب.
بين الصيغ الدينية للعلاقة مع العقاب السماوي، وفكرة العدالة التي لهث خلفها العالم، وأنتجت مرضاً إبداعيًا هو: دونكيشوت سرفانتس المولع بتحقيق العدالة. تبدو اليوم فكرة العدالة، لا في خطر فقط، بل تبدو واهمة.
اقرأ أيضاً: الإسلام مظلوم من أهله
قد تكون البذرة الأولى لدى الإنسان، هي الرغبة في محو الآخر، إلا أن الأديان والإيديولوجيات الوضعية والثقافة ركّزت جميعاً على تخليص الإنسان من صورة الوحش الأوّل البدائي، وهذّبت الرغبة في القتل، ووضعت قوانين صارمة، وصلت إلى القتل كردّ على القتل ذاته.
القاتل يُقتل، في جميع الشرائع. لكن الحضارة الإنسانية، ارتقت لاحقاً، إلى نبذ ثقافة المعاملة بالمثل، وخرجت من مرحلة حمورابي: العين بالعين. لتراجع الكثير من الدول قوانينها المتعلقة بقتل القاتل، فراجت ثقافة جديدة، راحت تهذب انفعالات البشر، وتدخلهم في مرحلة أخلاقية وإنسانية أعلى، عبر نبذ فكرة الانتقام والمعاملة بالمثل، وتكريس ثقافة التسامح.
أي أن البشرية تدرجت طويلاً، من العقاب بالمثل، إلى التسامح، إلى العقاب الذاتي، عبر المراجعة الأخلاقية والإنسانية، لتشهد اليوم منعطفاً خطيراً، في استعادة الوجه السابق لكل هذه التطورات: القتل للقتل، أو التلذذ بالقتل، أو عبثية القتل، أن يقتل أحدهم أي شخص، لمجرد أن جوراً وقع عليه، أو أن يقتل من باب اللهو والتلذذ بعذاب ضحيته.
في غياب العدالة، يصبح الجميع مرشّحين للقتل: الشخص الذي فقد بيته وعائلته وأسباب وجوده، الذي عمل وكافح ليؤسس بيتاً وعائلة، ثم جاءت قذيفة أو برميل أو صاروخ، قضت على أسباب عيشه، يتحوّل بسهولة ، ضمن غياب فكرة العدالة والمحاكمة، إلى قاتل عشوائي، ينتقم من أي أحد قبالته، مهما كانت براءته، لأن البراءة لم تعد موجودة. طالما أنت في وضع دائم لاحتمال أن تُقتل.
غياب العقاب العادل، المُؤسس على القانون، سيُطلق الوحش الكامن في الإنسان، ذلك الوحش البدئي، الذي اشتغلت عليه الإنسانية طويلاً، لتهذبه وتقننه بشرائع وقوانين، شكّلت العقد الاجتماعي، وبالتالي الأمان المجتمعي.
بغياب العدالة، سيكون الجيل القادم مرشّحاً ليكون وحشاً يلتهم ما أمامه، وستبدو كل جهود العالم المدني المتحضر الداعي إلى ضبط الانفعال وتكريس ثقافة الحوار والتسامح، مجرد أقوال مأثورة، نحفظها في صفحات باردة من كتب محفوظة في الرفوف، جامدة لا نستخدمها ولا نطبّقها، كونها وصفات خيالية، لا تنسجم مع الواقع، مجرد شعارات فارغة نستعملها في خطابات رسمية، بينما في الخطاب الموازي، الخفي، الحقيقي: نطلق النار على الآخر. كل هذا سببه القتل الأوّل، القتل الممهّد لقتل لاحق، لقتل يتسلسل، من قتل لقتل، عبر تكريس الثأر الفردي، والتلذذ بالقتل لمجرد القتل، ثم تكريس الوحش بدلاً من الإنسان، أي وحشنة الإنسان الذي اشتغلت الحضارة على أنسنته. كم سنحتاج من سنوات قادمة وجهود وتمارين لإعادة الإنسان إلى موقعه في الحضارة، وانتزاع خلل أن القاتل نجا ذات يوم من العقاب، لنعود ونكرّس البديهيات التي نشأنا عليها، والتي باتت لتكون مجرد أقوال شائعة، فتصبح قاعدة: في النهاية لا يصح إلاّ الصح، مجرد كليشيه لغوية، لأن ما يحصل كلّ يوم في سورية، ومنذ خمس سنوات على الأقل، على العلن، يقول إن شريعة الغاب هي التي تحكم العالم، وإنه من السهل أن يقتل أحدنا الآخر، طالما أن القاتل الأوّل الكبير، أفلت من العقاب.
لو كان أيا منّا مكان عائلة هذا الصبي الذي مات تحت التعذيب، أو لو أن الصبي ذاته كان قد نجا من الموت، فإنه يجب ألا يدهشنا تحوّله إلى قاتل فيما بعد، وهذه ليست دعوة إلى القتل والانتقام، بقدر ما هي عرض لفكرة مجانية القتل. حين لا يُعاقب القاتل، يصبح القتل وسيلة عادية للعيش، وينتصر قانون الغابة.
حين يتأكد هؤلاء الذين يعيشون ضحايا للعنف اليومي، والقتل العشوائي، من نجاة القاتل من العقاب، كيف يمكن توقّع ردودهم في مرحلة النجاة، إن نجوا؟ إذ، كما يقُتلون عشوائياً، ويموتون مصادفة، نتيجة تواجدهم في مكان ما، في لحظة ما، تحت نيران طرف ما، سواء الذين يموتون في بيوتهم، قصفاً بالبراميل، أو الذين يموتون في بيوتهم، بقذائف عشوائية، كما هم ضحايا عشوائيون، يمكن أن ينجوا مصادفة أيضاً.
كيف سيتعامل الناجون مع فكرة غياب العقاب. تلك الفكرة التي نشأت عليها البشرية، منذ العقاب الأوّل لآدم وحواء، ثم عبر تأسيس فكرة الجنة والنار، لتبدو حالتا العقاب والثواب، بمثابة ثوابت ذهنية، أدّت إلى نشوء أعمال مهمّة في الأدب العالمي، تركز على العقاب وتجلياته بصور عديدة، حتى تصل إلى مناقشة العقاب أو غيابه، كصيغ عدمية أحياناً.
فمن الجريمة والعقاب لدى ديستويفسكي، حيث العقاب ذاتي، وإلى المحكمة لدى كافكا، حيث تماهي المحكوم عليه مع حاكميه، ضمن اختيار لا شعوري للمحاكمة، كثيرة هي الأعمال الأدبية التي ركّزت على مفهوم العدالة، وإحقاق الحق، عبر العقاب.
بين الصيغ الدينية للعلاقة مع العقاب السماوي، وفكرة العدالة التي لهث خلفها العالم، وأنتجت مرضاً إبداعيًا هو: دونكيشوت سرفانتس المولع بتحقيق العدالة. تبدو اليوم فكرة العدالة، لا في خطر فقط، بل تبدو واهمة.
اقرأ أيضاً: الإسلام مظلوم من أهله
قد تكون البذرة الأولى لدى الإنسان، هي الرغبة في محو الآخر، إلا أن الأديان والإيديولوجيات الوضعية والثقافة ركّزت جميعاً على تخليص الإنسان من صورة الوحش الأوّل البدائي، وهذّبت الرغبة في القتل، ووضعت قوانين صارمة، وصلت إلى القتل كردّ على القتل ذاته.
القاتل يُقتل، في جميع الشرائع. لكن الحضارة الإنسانية، ارتقت لاحقاً، إلى نبذ ثقافة المعاملة بالمثل، وخرجت من مرحلة حمورابي: العين بالعين. لتراجع الكثير من الدول قوانينها المتعلقة بقتل القاتل، فراجت ثقافة جديدة، راحت تهذب انفعالات البشر، وتدخلهم في مرحلة أخلاقية وإنسانية أعلى، عبر نبذ فكرة الانتقام والمعاملة بالمثل، وتكريس ثقافة التسامح.
أي أن البشرية تدرجت طويلاً، من العقاب بالمثل، إلى التسامح، إلى العقاب الذاتي، عبر المراجعة الأخلاقية والإنسانية، لتشهد اليوم منعطفاً خطيراً، في استعادة الوجه السابق لكل هذه التطورات: القتل للقتل، أو التلذذ بالقتل، أو عبثية القتل، أن يقتل أحدهم أي شخص، لمجرد أن جوراً وقع عليه، أو أن يقتل من باب اللهو والتلذذ بعذاب ضحيته.
في غياب العدالة، يصبح الجميع مرشّحين للقتل: الشخص الذي فقد بيته وعائلته وأسباب وجوده، الذي عمل وكافح ليؤسس بيتاً وعائلة، ثم جاءت قذيفة أو برميل أو صاروخ، قضت على أسباب عيشه، يتحوّل بسهولة ، ضمن غياب فكرة العدالة والمحاكمة، إلى قاتل عشوائي، ينتقم من أي أحد قبالته، مهما كانت براءته، لأن البراءة لم تعد موجودة. طالما أنت في وضع دائم لاحتمال أن تُقتل.
غياب العقاب العادل، المُؤسس على القانون، سيُطلق الوحش الكامن في الإنسان، ذلك الوحش البدئي، الذي اشتغلت عليه الإنسانية طويلاً، لتهذبه وتقننه بشرائع وقوانين، شكّلت العقد الاجتماعي، وبالتالي الأمان المجتمعي.
بغياب العدالة، سيكون الجيل القادم مرشّحاً ليكون وحشاً يلتهم ما أمامه، وستبدو كل جهود العالم المدني المتحضر الداعي إلى ضبط الانفعال وتكريس ثقافة الحوار والتسامح، مجرد أقوال مأثورة، نحفظها في صفحات باردة من كتب محفوظة في الرفوف، جامدة لا نستخدمها ولا نطبّقها، كونها وصفات خيالية، لا تنسجم مع الواقع، مجرد شعارات فارغة نستعملها في خطابات رسمية، بينما في الخطاب الموازي، الخفي، الحقيقي: نطلق النار على الآخر. كل هذا سببه القتل الأوّل، القتل الممهّد لقتل لاحق، لقتل يتسلسل، من قتل لقتل، عبر تكريس الثأر الفردي، والتلذذ بالقتل لمجرد القتل، ثم تكريس الوحش بدلاً من الإنسان، أي وحشنة الإنسان الذي اشتغلت الحضارة على أنسنته. كم سنحتاج من سنوات قادمة وجهود وتمارين لإعادة الإنسان إلى موقعه في الحضارة، وانتزاع خلل أن القاتل نجا ذات يوم من العقاب، لنعود ونكرّس البديهيات التي نشأنا عليها، والتي باتت لتكون مجرد أقوال شائعة، فتصبح قاعدة: في النهاية لا يصح إلاّ الصح، مجرد كليشيه لغوية، لأن ما يحصل كلّ يوم في سورية، ومنذ خمس سنوات على الأقل، على العلن، يقول إن شريعة الغاب هي التي تحكم العالم، وإنه من السهل أن يقتل أحدنا الآخر، طالما أن القاتل الأوّل الكبير، أفلت من العقاب.