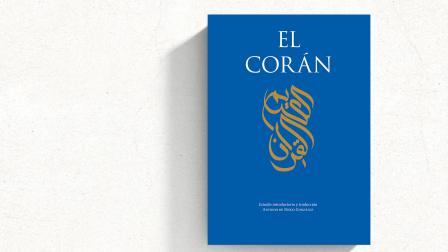أحياناً يرتسمُ أناسٌ كثيرون محشورون في قاعاتٍ طويلة كما في لوحة واقعية بالألوان الزيتية، وأحياناً يظهرون في صور غامضة، نصف مرسومة، كأنما رسمتها ريشة رسام صيني أو ياباني بألوان مائية. نصفُ بيت هنا، نصف بيت هناك، نصف شارع، أو نصف نهار أحياناً. لا شيء يكتمل. حتى وجوه الناس وأفعالهم تظهر في مجموعات تتحدث، تتهامس، تتحرك أو تنأى، أوتتلاشى.
لا أعرف أين انتهى كل هذا. يبدو أن الطفولة تعيش على نصف كتاب أو تنام على نصف سرير. على الحافة دائماً، على حافة الكلام وحافة الصور. لا تعرف الحكايات المكتملة، أو هي لا تسعى إليها؛ تكتفي باللمحات.
تلك كانت بغداد العباسية التي سحبونا إليها من تحت أشجار اللوز في جنين، وتلك هي المدارس الشبيهة بقصور تجار البندقية، مدارس يهودية بمئات الغرف، وتلك هي العائلات الفلسطينية الذاهلة؛ فلاحون وملاك أراضٍ وتجار وباعة وأعيان وبداة، في محشر لم يكن أحد يتخيل أنه سيلجه في يوم من الأيام حيّاً، من دون المرور بالتراب والنسيان، وأصوات المطر المتساقط على جفون الموتى في الظلمة الأبدية.
كان هناك بيت دائماً
علامتي الأولى في هذا الأفق هي ذكرياتُ الذين لا يذكرهم أحد، أهلي، أصدقائي، من رأيتُ عن بعد أو قرب حين كنتُ أصغي في عزلتي طيلة سنوات؛ العودة إلى وعر جبل الكرمل في ذاكرة أمي وبين شعاب أحاديث أبي وأخواتي، العودة إلى البداية.
أخذتني العواصمُ مجدداً إلى نفسي أيضاً كما كانت تفعل دائماً. أعادتني ساحاتها وتماثيلها الحجرية ودرجاتها ونوافيرها وظلال أزقتها إلى ذلك الطفل الصامت حين كان يصغي في بيوت البصرة القديمة، أو يطلّ على أسواقها ويتجول بين غابات نخيلها، أعادتني إلى حكايات أمي، الأم التي لاتتوقف عن الحديث أناء الليل وأطراف النهار عن أيام البلاد العزيزة.
هناك سنواتٌ يَعلق فيها الفتى الجوالُ في الفراغ، لا أرضَ يقف عليها، لا جدارَ يستند إليه، ولا ظلَّ سدرٍ يكفيه ضربَ الأطناب والأعواد. سنواتٌ تجيء فجأة بلا سبب مفهوم، أشبه بعاصفة تقتلع أشجار الماضي دفعة واحدة، وتنثر صور الحاضر وأوراقه. كانت هذه عاصفة غزو أصاب الكويت ذات صباح. عاصفة تمسك بكَ كأنك وحدكَ المقصود بكل هذا؛ بالجيوش والإذاعات والصحف والضجيج. تجد نفسك فجأة بلا مستقر، بلا متاعٍ ولا مالٍ ولا مكتبةٍ ولا زمن. لا بيتَ تعود إليه مساءً بعد أن تمضي نهارك جائلاً. وتتذكر كلمات غالب هلسا "في القصص القديم يتجول الإنسان طويلاً ولا يجد قوت يومه، ولكنه كان يعود إلى بيته؛ كان هناك بيتٌ دائماً"، فتقول؛ ولكننا خرجنا من أقاصيصنا يا غالب، وأغلقت دوننا أبوابَها.
في الرابعة من العمر أو أكثر
في الرابعة من العمر أو أكثر، ولدتُ فجأة سائراً في الوعر بجانب امرأة مجهولة. السماءُ فوقنا سوداءُ تتلاحق في فضائها جمراتٌ حمراء، هناك عالياً بلا صوت. تلك هي رحلتي الليلية مع أمي كما عرفتُ في ما بعد، من مكان مجهول إلى مكان مجهول أيضاً، وبينهما كائنان يتحركان، يواصلان الحركة من دون الوصول إلى مكان.
حتى الآن لم أعرف شيئاً محدداً؛ هل وصلنا أم لا؟ ويخيل إلي أن ذلك الليلُ ظلَّ ممتداً حتى هذه اللحظة. لم يتوقف الطفلُ، ولا توقفت المرأة عن المسير. كلُّ شيء يقع بين مكانين غامضين لا ملامح لهما. وستقول أمي في مابعد، نعم أنا من كانت تسير معك في تلك الليلة، ليلة خروجنا من أم الزينات بعد أن احتلها اليهود في 15 أيار 1948.
رصاصة واحدة
احتشد الناسُ، ونحن معهم، لرؤية الملك المتوّج وهو يمرّ فرحاً ملوّحاً بيدهِ. كان الموكبُ يمرّ بعيداً في شارع رئيس نطلُّ عليه من زقاق. هذا الشارع ذاته سيشهد ذات صباح مرورَ سيارة عسكرية مسرعة، وجندي أصلع يلوح ببندقيته في مقعدها الخلفي؛ هي الثورة على الملكية كما قيل آنذاك، وهي صورُ القادة العسكريين يتداولها الناسُ مطبوعة على عجلٍ على ورق خشن، وهي تجمعاتنا في الزقاق أمام أبواب البيت الكبير لنناقش ما يحدث.
ويقرأ علينا زميلٌ في الصفوف المتقدمة قصيدة عن العودة إلى الوطن ودفن الموتى، ويتدخل ابن اللاجيء الغجري فينصحنا بأن لا نخوض في غمار ما يحدث حولنا، لأن البحر من وراءنا والعدو من أمامنا، فيرد عليه زميلنا المتقدم: لا أرى إلا جداراً وراءنا وجداراً أمامنا.
ويسأل أحدنا زائراً قادماً من بغداد لتوه، ونحن نسير على امتداد شارع مشجر يحاذي شط العرب: كيف نعمل من أجل فلسطين؟ فيجيب الزائر متروياً: هناك الآن حركة تدعونا إلى أن نعمل شيئاً.. ما رأيكم؟ رصاصة واحدة في فلسطين تساوي آلاف الخطابات خارجها.
صياح البط البرّي
أسلاكٌ شائكة، لفاتٌ هائلة الارتفاع يفوق ارتفاعُها مدى نظري، قائمة وشائكة وباردة كما لو أنها حدثتْ بالأمس. لم تعد الحكاياتُ تتقطع، ولا الناس يختفون ببساطة مثلما حدث بالأمس بين صخور الكرمل تحت السماء السوداء والجمر المتلاحق، ومثلما حدث مع الذين تهامسوا وعبروا في غرف المدارس اليهودية في بغداد. ها هنا معسكرٌ مهجور لجيش بريطاني لملم بقاياه ومضى، معسكرٌ في أعماق الصحراء جنوب البصرة تحيط به لفّاتُ الأسلاك من كل الجهات. أينما وليتَ وجهكَ فثمة هذا الحاجز الشائك دونكَ ودون البراري البعيدة.
يتجوّل اللاجئون بين مهاجع هذا المعسكر الذي سكنوه أو سكن فيهم. يتشاجرون حين تُوزع أكياسُ الطحين والسكر، يتضاحكون حين يمرُّ غجري بائسٌ مكحول العينين، يتسامرون ليلاً في العراء بجوار أضواء خافتة، أو يصخبون في المقهى الوحيد تحت أنظار رجل أسمر ضخم غارق في عرقه دائماً، متأففٍ يملأ كرسياً عالياً، وأمامه صينية يلقي فيها كل خارج بدرهم ملكي أو درهمين.
من تلك الأيام تتعلق أيامٌ شتائية بأطرافِ الذاكرة؛ أناسٌ ينتشرون في كل الجهات، بعضهم يتجمع حول أخشابٍ تطقطق والنارُ تسري فيها ومن حولها، بعضهم يتناثر في أماكن نائية، لا تصلني أصواتهم، ولكن يظلُّ معي صياحُ البط البرّي وأسرابه البيضاء تعبر السماء فوقنا، ومشهدُ صياد محظوظ وقعت بطة بيضاء في فخه، ضخمة أمسكها من جناحيها بكلتا يديه. تنتفض البطة ومنقارها ينفتح مرتعباً ويملأ عالمنا الصغير بالصراخ. نتجمع حول الصياد وهذا الكائن الأبيض الذي لم ندرك بعد هويته وقومه ووطنه. الكائن الأسير في ذلك اليوم البعيد يظل أسيراً حتى هذه اللحظة.
* شاعر وروائي فلسطيني من مواليد حيفا 1944