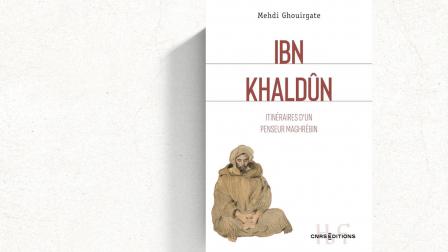سواء بحياته القصيرة أو بنصوصه، ينتمي الهنغاري أتيلا يوسف (1905 ـ 1937) إلى حلقة الشعراء الملعونين الحميمة، حيث يتربّع لوركا وريلكه وأبولينير، وطبعاً بودلير ورامبو. فأعماله الشعرية المبكرة تضارع بإشراقاتها أعمال إخوته في اللعنة. وسوداويتها هي على صورة فصول حياته المأساوية.
لذلك، يشكّل صدور مختارات واسعة من قصائده حديثاً عن "دار زمن الكرز" الباريسية حدثاً شعرياً، في نظرنا، وفرصةً للتعريف بهذا العملاق الذي ما يزال مجهولاً حتى اليوم، وبالتالي لم ينل حقه من الاهتمام والدراسة.
مأساة يوسف بدأت منذ الطفولة، مع ولادته داخل عائلة فقيرة جداً، وفقدانه في سن الثالثة والده، الذي غادر المنزل من دون رجعة، تاركاً زوجته وأولاده الثلاثة يتخبّطون في البؤس؛ ما سيدفع الطفل أتيلا إلى الهروب بدوره والعمل راعياً للخنازير، ثم بائع جرائد، فبائع ليموناضة، فنادلاً في مقهى. وخلال تلك الفترة، سيوضع مرّتين تحت وصاية عائلة غير عائلته، حيث يختبر قسوة "أن نكون شخصاً آخر، بما أنه يصعب علينا كثيراً أن نكون ذاتنا". تجربة ستطبع شخصيته وتلعب دوراً في توجّهه لاحقاً نحو الكتابة.
خلال سنوات المراهقة، يعايش يوسف ظروف الحرب العالمية الأولى الصعبة، قبل أن يخسر أمّه، عام 1919، التي ستتسلّط ذكراها عليه حتى وفاته، ويكتب حولها أجمل قصائده. ولا عجب إذاً أن يكون قد حاول الانتحار مرّتين قبل أن تصدر مجموعته الشعرية الأولى "شحّاذ الجمال" عام 1922. لكن بسبب قصيدة "المسيح الثائر" سيُحاكَم بتهمة "التجديف"، قبل أن يُطرد من الجامعة على يد أستاذه بسبب قصيدة "قلبٌ نقي" التي صدرت في مجموعته الثانية.
ومع أن مجموعته الثالثة "هذا ليس صراخي" (1925) ستلفت انتباه بعض النقّاد، إلا أن شعوراً بالفشل سيتسلّط عليه من جرّاء علاقاته العاطفية العاصفة، وعدم تفهّم رفاقه الشيوعيون موقفه التحرّري ـ الفوضوي. لكن هذا لن يمنعه من السفر إلى فيينا، ثم إلى باريس، حيث سيكتشف السوريالية والماركسية العلمية.
 ولدى عودته إلى بودابست، سيُصدر خمس مجموعات شعرية بين عامَي 1929 و1936، قبل أن ينتهي في مصحّ للأمراض العقلية. وفور خروجه من المصحّ، سيؤسّس صحيفة بروليتارية تجلب له متاعب كثيرة مع الشرطة. وبعد قصة حبّ محكومة بالفشل مع محللته النفسية فلورا ك. التي ستوحي له بقصائد رهيبة في جمالها، سيضع حداً لحياته برمي نفسه تحت عجلات قطار، وكان في الثانية والثلاثين من عمره.
ولدى عودته إلى بودابست، سيُصدر خمس مجموعات شعرية بين عامَي 1929 و1936، قبل أن ينتهي في مصحّ للأمراض العقلية. وفور خروجه من المصحّ، سيؤسّس صحيفة بروليتارية تجلب له متاعب كثيرة مع الشرطة. وبعد قصة حبّ محكومة بالفشل مع محللته النفسية فلورا ك. التي ستوحي له بقصائد رهيبة في جمالها، سيضع حداً لحياته برمي نفسه تحت عجلات قطار، وكان في الثانية والثلاثين من عمره.
مثل معظم الشعراء الهنغاريين، لم ينظر يوسف إلى الشعر خارج ظرفه الاجتماعي والواقعي. على قمة اللغة وعلى قمة الواجب دائماً، كان يصوغ رؤاه من دون اللجوء إلى حذلقات بلاغية، بواسطة مفردات بسيطة وصورية. مثل بعض قصائد لويس أراغون وبول إيلوار، قصيدته بروليتارية في جوهرها فقط، وبالتالي لا تنقصها الدوافع الجمالية والبُعد الميتافيزيقي والنفَس الغنائي. ولذلك، يصعب تفسير الإهمال الجائر الذي تعرّض له خلال حياته، وبعد وفاته، رغم اهتمام شعراء كبار بنصوصه، مثل تريستان تزارا وإيلوار وأوجين غييفيك وألان بوسكيه، وترجمتهم عدداً منها إلى الفرنسية.
بالنسبة إلى التأثيرات التي خضع يوسف لها، يمكننا استحضار جيل مجلة "غرب" الهنغارية، والشعر الفرنسي، والتعبيرية الألمانية، وأيضاً التيار المستقبلي الذي نشط في بلده عبر مجلة "اليوم" الطلائعية، من دون إهمال شعوره العميق بالانتماء إلى عائلة البؤساء، وقناعاته الثورية التي تشهد عليها قصائد مثل "اشتراكيون" و"المنفعة للرأسماليين" و"عمّال".
لكن شخصية يوسف لا تسمح بسجنها داخل تحديدات سهلة، نظراً إلى حيويتها العميقة وتناقضاتها الكثيرة. بروليتاري وابن المدينة، إنه أيضاً ابن الريف والطبيعة، التي تحضر في نصوصه رقيقةً، وفي الوقت ذاته، معذّبة وفي حالة كفاحٍ، مثل العاملين في أرجائها.
شاعرٌ مجدِّد استقى مادة صوره من الحياة الحديثة، مارس في الوقت نفسه أشكال النظم الشعري الثابتة بمهارة فريدة. شاعرٌ ملتزِم نشط في الفضاء العام، كان أيضاً شاعر الحميمية الذي التفت برقّة إلى أكثر ظواهر الحياة وضاعةً، وإلى أوسع أفقٍ ممكن، فتحاور مع النمل كما تحاور مع النجوم، وارتبط بعلاقة حميمة مع الكون حيث "كل شيء يمسّني". ورغم كآبته العميقة، كان يعيش أحياناً حالات إثارة وسعادة كبيرتين.
من هنا اهتمامه بالتحليل النفسي الذي أمل من خلاله أن يتخلّص من اكتئابه الذي سيدفعه في النهاية تحت عجلات قطار، علماً أنه تنبّأ بهذه النهاية في قصيدتين تستحضران صورة شخص ممدّد على سكة الحديد بينما يعلو من بعيد صوت قطار يقترب.
يبقى أن نشير إلى أن مفهوم يوسف للشعر يتبنّى جميع تناقضاته ويبررها. ففي حوار أجراه أحد الصحافيين معه قبل وفاته، قال: "السبب الجوهري لحاجتنا إلى الشاعر هو بلا شك قدرته على العثور على شكلٍ لواقعٍ متناقض". وبالتالي، هدف القصيدة، بحسبه، ليس الجمال بل الحقيقة، أي بلوغ حصيلة لجوانب متناقضة من واقعٍ واحد، داخل واقعٍ جديد. واقع هو عبارة عن "كلٍّ صافٍ لا يتجزّأ".