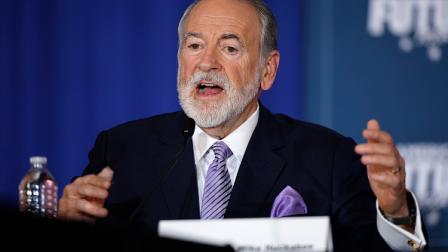منذ سنوات وأزمة لبنان شبه منسية في واشنطن. يمرّ ذكرها بصور عابرة بين الفينة والأخرى. إما عندما يزور أحد المسؤولين الأميركيين بيروت لضبط التوازنات والتأكيد على الفيتوات المعروفة، وإما عندما تفرض الإدارة عقوبات على جهات ومسؤولين لبنانيين، أو حين تقع أحداث كبيرة مثل انفجار المرفأ في أغسطس/ آب الماضي. لا مبادرات ولا وساطات ولا مساهمات تُذكر، سوى تقديم مساعدة عسكرية متواضعة للجيش اللبناني.
في الإحاطة الصحافية اليومية، نادراً ما تأتي وزارة الخارجية على سيرة الأزمة اللبنانية. وعند السؤال، تكتفي بردود ضبابية من نوع "إننا نتابع الوضع" عن قرب، أو بتكرار المعزوفة ذاتها بأنه "على لبنان تشكيل حكومة بسرعة، ترضي اللبنانيين، وتحارب الفساد، وتجري الإصلاحات المطلوبة" لحلّ مشكلته. التعامل بلغة الوعظ مع أزمة بهذه الخطورة زاد من ترسيخ الاعتقاد بأنّ لبنان بات بمثابة "الملحق" في المنطقة. تعقيدات وضعه صارت مرتبطة بالنووي الإيراني، والانفراج في أزمته مرهون بنجاح مفاوضات فيينا، ولو على حسابه.
حسب هذا الربط، كان من المفترض أن تشهد عقدة لبنان بعض الحلحلة في ضوء "التقدم" الواعد، ولو الأولي، الذي حققته هذه المفاوضات. لكن حصل العكس، حيث ازداد استعصاؤها على الحلّ، مما استدعى مجيء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، في محاولة وصفت بأنها الأخيرة لفتح ثغرة في جدار الأزمة، غير المتوقع نجاحه فيها.
من التفسيرات أنّ اللعبة أعمق وأكثر تعقيداً من مثل هذا الربط المبسّط. بل هي على نقيضه. فحسب ورقة بحثية صادرة عن مركز "كارنيغي للدراسات" بواشنطن، يعود التصعيد في الأزمة اللبنانية إلى الصراع المحتدم طردياً مع تقدم المفاوضات، بين فريقين، واحد يعمل لاستبقاء النفوذ الإيراني، وآخر لاستبداله بنفوذ سوري يكون نسخة منقحة عن وصاية دمشق التي استمرّت 30 سنة على لبنان.
تنطلق الورقة من التغيير في سياسة بعض البلدان العربية التي انفتحت على النظام السوري، سواء بإعادة فتح السفارات في دمشق أو بتجديد قنوات الاتصال، مع "تزايد الإشارات العربية على إرجاع سورية إلى الجامعة العربية". وفي التقدير، أنّ هذا التغيير جاء في وقت "تحتاج فيه دمشق إلى إعادة الإعمار المكلف بين 200 و400 مليار دولار"، وأنّ هذه الحاجة لا بدّ وأن ترتبط بمطلب "تخفيف العلاقة مع طهران". وإذا كان من الصحيح أنّ مثل هذا التحول "ليس بالأمر السهل"، إلا أنّ بإمكان سورية "أن تعوّل على مساندة موسكو" لتحقيق هذه النقلة، خصوصاً وأن روسيا "تبدو حريصة على تثبيت سورية ضمن الإجماع العربي".
ومن العقبات، حسب هذا التحليل، أنّ النظام السوري "قد يطلب في المقابل استعادة نفوذه في لبنان"، ليس من خلال عودة قواته إلى الأراضي اللبنانية، لكن "عبر رفع درجة التعاون مع الجيش اللبناني وأجهزة المخابرات". ولترجمة هذا التعاون وشرعنته، يمكن الاستناد إلى "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق" الموقعة بين البلدين عام 1991، كما إلى "اتفاقية الأمن والدفاع اللبنانية – السورية" لعام 1991 أيضاً، مع ما يترتب على ذلك من "نتائج بعيدة المدى".
وفي الاعتقاد أنّ مثل هذه المقايضة ممكنة في ضوء "التآكل ولو البطيء في سيطرة "حزب الله" ونفوذه في لبنان"، كما في ضوء "التعب" من الأزمة اللبنانية. ومن هنا، حسب هذه القراءة، "بروز خط الصدع أخيراً بين حلفاء سورية وحلفاء إيران في لبنان"، والذي انعكس في "هجوم النائب إيلي الفرزلي، حليف سورية، على صهر رئيس الجمهورية، رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، كما في التباين الذي ظهر بين رئيس مجلس النواب، رئيس "حركة أمل" نبيه بري، و"حزب الله"، حول العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يقف الحزب إلى جانبه وجانب صهره باسيل، "في وقت يتطلع فيه (أي الحزب) إلى فيينا، علّ مفاوضاتها تنتهي إلى "صفقة تعزز وضعه في الداخل اللبناني".
مثل هذا التحوّل قد تكون حساباته سهلة على الورق، وليس بالضرورة على الأرض. فكّ أو حتى تخفيف العلاقات بين سورية وإيران مسألة صعبة. وحتى لو صحّت في التصميم، فقد لا تنجح في التطبيق، ذلك أنّ "سورية قد تعمل على جني المكاسب من هكذا ترتيب، من غير أن تتخلى سوى عن القليل من روابطها مع إيران"، لكن في كلّ الأحوال، يبقى من الواضح أنّ لبنان متروك ليغرق بالمزيد من الاهتراء والتآكل تحت ستار أنه ميؤوس منه، بحيث يصبح بالنهاية رقماً خاسراً في معادلات وترتيبات إقليمية، بقطع النظر عمّا قد ترسو عليه، من غير استبعاد أن تكون مفتوحة على تغيير الخرائط والتخوم.