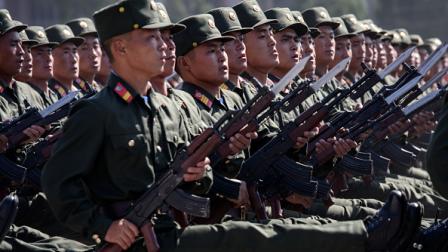كان؛ ولا زال، الاتّفاق على وقف إطلاق النّار في مخيّم عين الحلوة هشًّا حتّى كتابة هذه المادّة، إذ لا يعرف سكان المخيّم ومحيطه في أيّة لحظةٍ يشتعل فتيل الاشتباكات المسلّحة مجدّدًا. رغم ذلك؛ عاد بعض ساكني أحيائه المعقدة بتركيبة سكّانها السياسية والعقائدية، كي يتفقدوا بيوتهم، وهم في أغلب الأحيان متشردون، أو لا يملكون خيارًا سوى العودة إلى البيوت المدمّرة أو المحترقة، فليس لديهم إمكانيةٌ مالية لإيجاد مأوىً بديلٍ. هذا ما ينقله سكّان الأحياء القريبة من تموضع القوى المُشتبكة في الشارع الفوقاني للمخيّم، واصفين إيّاها بـ "مثلّث برمودا"، الذي ينطبق عليه القول "الداخل إليه مفقودٌ والخارج منه مولودٌ".
في الوقت الضائع من حياة آلاف الأهالي ضمن هذه البقعة الجغرافية المعزولة؛ التي لا تتجاوز كيلومتراً واحداً، لم تستطع قوى الاشتباك إخفاء استعداداتها العسكرية، كإعداد السواتر الترابية، والتواجد في أزقة المخيّم ومؤسّساته، وداخل مدارس الأونروا وبيوته غير الصالحة للسكن، وهو ما دفع الأهالي إلى التسليم بحدوث معركةٍ مقبلةٍ، انطلاقًا من استعصاء تنفيذ شروط وقف إطلاق النار، التي يفترض بها أنّ تؤدّي إلى تسليم المطلوبين المتورطين باغتيال قائد جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، أبو أشرف العرموشي.
لم تخلُ أيّام الهدنة من حوادثَ وإشكالاتٍ فرديةٍ تثير قلق الأهالي؛ العائدين على مضضٍ، خوفًا من تطوّر الإشكال وعودة المعارك، كما لا تخلو يوميّات المخيّم من أحداث قتلٍ وطعنٍ، غالبًا ما تصفها الفصائل بـ "إشكالاتٍ فرديةٍ أو عائليةٍ"، لكنها تعكس الواقع الذي تحوّل إليه المخيّم، إذ أصبح بؤرةً للتوتر وساحةً لتصفية الحسابات ولحرب العصابات، كان آخرها الحادث الذي فجّر مواجهةً شرسةً بين حركة فتح والجماعات السلفية، بعد محاولة الفتحاوي محمد الزبيدات اغتيال أحد المطلوبين بتهم الإرهاب، انتقامًا لمقتل شقيقه على أيدي سلفيين قبل أشهرٍ، أعقبه اغتيال العرموشي، ثم تطوّر الحادث إلى مواجهةٍ بالأسلحة الثقيلة، طالت محيط المخيّم الواقع في مدينة صيدا، وأصابت نقطةً للجيش اللبناني.
بدا المخيم بذلك فاقدًا لكيانه المعنوي، الذي مثّلَ منذ ستينيات القرن الماضي مدرسةً ثوريّةً، كانت قبلةً لطلاب الحرية في لبنان والعالم
فرض تطوّر الحدث التكهن بسيناريوهات عدّةٍ، ربط معظمها بين الحدث والتطوّرات الإقليمية والدولية، وتضمنت فرضيات عديدةٍ، مثل احتمال انتقال المعارك إلى خارج المخيم، وأعادت ملف السلاح الفلسطيني في لبنان إلى واجهة البحث، كذلك تطرقت السيناريوهات إلى حيثيات الانقسام الفلسطيني، وصراع النفوذ والسيطرة على أكبر مخيمات لبنان، الواقع عند بوّابة الجنوب.
لكن تعاملت هذه القراءات؛ على اختلافاتها، مع بركان مخيّم عين الحلوة على أنّه مستجدٌّ أمنيٌ في الواقع اللبناني، ولم تلحظ التراكم التاريخي والاجتماعي للمخيّمات، وأوضاع فقرائها ولاجئيها، وواقع المخيّمات المأساوي، التي ستؤدّي بمحصلتها إلى النتيجة التي يخشاها اللاجئون ويتوقعونها في الوقت ذاته، ألا وهي تدمير المخيّم، ونسف حقوق أهله التاريخية، وعلى رأسها حقّ العودة.
يستدعي ما حدث في عاصمة الشتات، والذي بات أشدّ تعقيدًا من أن تنزع الحلول الأمنية المؤقّتة فتيل انفجاره، قراءةً لبنانيةً مختلفةً لكلّ المخيّمات، وتعاطيًا إنسانيًا وقانونيًا مع اللجوء الفلسطيني، بعد سبعة عقودٍ ونيّف من وجود مخيّمات الفلسطينيين على أرض لبنان. إذ اقتصر التعامل الرسمي اللبناني مع المخيمات على اعتبارها جزرًا أمنيةً فقط، ومع اللجوء على أنّه ملفٌ أمنيٌ وحسب، وهنا لا بدّ من مراجعة التراكم الاجتماعي، الذي أدّى إلى انفجار مخيّم عين الحلوة، والمحتمل امتداده ليطاول مخيّماتٍ أخرى، كانت قد شكّلت جيوب نزاعٍ في مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية، وكذلك في مراحل الأزمات، كنموذج مخيم نهر البارد، حين دخلته جماعاتٌ إرهابيةٌ عابرةٌ للحدود وللجنسيات في عام 2007، استنزفت تلك الفصول المخيّمات، وأدّت إلى هجراتٍ متتاليةٍ للاجئيها، من الشباب خصوصًا، بعد أن باتوا منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي بين فكّي اتّفاق الطائف من جهةٍ، الذي وضع حدّاً للحرب الأهلية، وأقصى حقوق اللاجئين كلّيًا، بما فيها حقوقهم المدنية والإنسانية، ومن جهة أخرى اتّفاق أوسلو، الذي تركهم لمصيرهم المجهول.
بدا المخيم بذلك فاقدًا لكيانه المعنوي، الذي مثّلَ منذ ستينيات القرن الماضي مدرسةً ثوريّةً، كانت قبلةً لطلاب الحرية في لبنان والعالم، فسياسة عزل اللاجئين الفلسطينيين ضمن معازل/ غيتو أمنيةٍ، وحرمانهم من حقّ العمل، والضمان الاجتماعي، وحقّ التملك، بما فيه تملك مسكنٍ، فضلاً عن إقصائهم من الحياة العامة، قد أبقى كلّ ذلك فلسطينيي لبنان رهائن لصيغة لبنان الطائفية، في ممارسةٍ تتناقض مع شرعية حقوق الإنسان، ما أدّى إلى إغراقهم في التهميش والفقر المدقع، وسهّل في ما بعد تجنيد الجماعات السلفية لعددٍ من الشباب الفلسطيني، عبر استثمارها في بطالتهم ويأسهم، حين أغدقت على شبابٍ في سن السادسة عشرة؛ وما فوق، الاغراءات المالية، ووفرت لهم السكن، وحياة الرفاهية، ومكنتهم من ارتياد الأماكن التي يرتادها برجوازيّو المدينة.
يستدعي ما حدث؛ ويحدث، في مخيم عين الحلوة قراءةً فلسطينيةً شفّافةً أيضًا، متحررةً من الفساد والانتفاعية، حتّى لو أتت متأخرةً، إذ تستطيع الفصائل الفلسطينية أن تعيد مراجعة أداءها؛ على أقلّ تقديرٍ، في ظلّ صعوبة/ استحالة تحقيق؛ في المدى القريب، إرادةً وطنيةً فلسطينيةً جامعةً، تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة من قضيته، والتي يقع اللجوء في جوهرها. إذ ثمة أطرافٌ تستفيد من بقاء وضع اللاجئين على حاله، كي يبقى فلسطينيو المخيّمات رهائنٌ لتجّار ومروّجي المخدرات، التي دمّرت شريحةً من شبابهم وشاباتهم، ورهائن لمافيا مولّدات الكهرباء أيضًا، التي تتقاسم غنائم المناطق، وتجبي الفواتير بالدولار الأميركي، كذلك فإنّهم رهائن عددٍ من المنظّمات غير الحكومية، والجمعيات التي؛ في معظمها، تستدرج أموالاً طائلةً من الخارج، على حساب شقاء اللاجئين.
أيضًا؛ اللاجئون رهائن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث لا غوثٌ ولا تشغيلٌ، فالأونروا تشكو الإفلاس، وتحاول التنصّل من واجباتها، في ما تتلقى ميزانيتها السنوية من الدول المانحة، ويحتاج أهالي المخيمات إلى انتظار بيروقراطية نظامها في ما يخصّ الطبابة والخدمات، أو وساطةً من أحد النافذين في الفصائل، لترميم منزلٍ قابلٍ للانهيار، فطلبات ترميم المنازل في المخيمات؛ ذات البنى التحتية المتهالكة، تنام في أدراج موظفي الأونروا أشهرًا، ولا يفرج عن بعضها إلاّ ما ندر، ولم يكن ينقص هذه المأساة إلاّ مضاعفتها بمأساةٍ أكبر، إذ دمّرت معركة مخيّم عين الحلوة الأخيرة سبعمائة منزلٍ ومحلٍ صغيرٍ، كانت تساعد الأهالي على العيش بالكفاف اليومي، أو دونه. فهل يصبح أقصى طموح أهالي المخيّم، العودة إلى حالة البؤس التي كانوا عليها قبل المعركة الأخيرة؟ وهل يعاد إعمار ما دمّرته المعركة الأخيرة؟ ومتى يبدأ مسلسل إعادة إعمار المخيّم؟ ومن يخلّص رهائن عين الحلوة من سجنهم الكبير؟