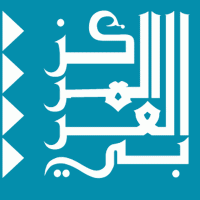24 أكتوبر 2024
احتجاجات السودان.. أسبابها، سياقاتها والمواقف الدولية
احتجاج في الخرطوم ضد الحكومة (6/1/2019/فرانس برس)
تستمر الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والتي سقط فيها حتى الآن 37 قتيلًا برصاص قوات الأمن، بحسب منظمة العفو الدولية، من دون ظهور مؤشراتٍ على نهايتها، أو تجاوب السلطات مع مطالبها. وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات، فإن النظام يحتفظ بسيطرةٍ كاملةٍ على مناطق العاصمة، ونجح حتى الآن في الحيلولة دون تشكّل تظاهرات كبرى، من خلال التدخل المسبق أو المباشر لقمعها. من جهة أخرى، بدأت الاحتجاجات تتحول من مرحلة "العفوية" إلى مرحلةٍ فيها قدر من التنظيم؛ إذ حاول "تجمع النقابات المهنية" (غير الرسمي)، والذي أعلن عن قيامه بعد اندلاع الاحتجاجات (يشمل الأطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين وأساتذة الجامعات والصحافيين وغيرهم)، تنظيم مسيرة إلى القصر الجمهوري، في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2019، لتسليم رسالةٍ يطالب فيها الرئيس بالاستقالة، إلا أن القوات الأمنية فرّقت المسيرة. ويبدو أن قيادةً سريةً بدأت تنسّق الاحتجاجات التي تفجرت عفويًا في الأقاليم وامتدت إلى الخرطوم في أقل من 24 ساعة، وذلك بخلاف انتفاضات السودان السابقة، والتي كانت تنطلق من العاصمة، ثم تتوزّع في الأقاليم.
الأسباب المباشرة للاحتجاجات
شكلت المصاعب الاقتصادية، وتحديدًا قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، السبب الرئيسَ لتفجّر الاحتجاجات في مدينة عطبرة التي تقع إلى الشمال الشرقي، على بعد 310 كيلومترات من العاصمة. وهي مدينةٌ عماليةٌ يعمل غالبية أهلها في السكك الحديدية. وقد أعادت الاحتجاجات إلى الأذهان ظروف انتفاضة نيسان/ أبريل 1985، التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري (1969- 1985)، حين أعلن حزمةً من القرارات؛ تنفيذًا لتوصيات البنك الدولي في التقشف ورفع الدعم عن الخبز والمحروقات.
وتعود الأزمة الحالية التي يواجهها النظام إلى سلسلةٍ من الإجراءات بدأت في نهاية عام
2017، بعد إصدار أول ميزانية لما سميت "حكومة الوفاق الوطني" التي رأسها نائب الرئيس، الفريق أول بكري حسن صالح، وكان وزير ماليتها أيضًا من الجيش، أي إنه من دون أي خبرةٍ في الاقتصاد. وما إن أُعلِنت الميزانية، حتى بدأت قيمة العُملة تتدهور بسرعة. ولم يساعد القرار الأميركي رفعَ معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على السودان، مطلع عام 2017، في تحسين الأوضاع. وكانت ردة فعل الحكومة اتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ للحد من المعروض النقدي في الأسواق، أملًا في الحدّ من تجارة العُملة غير الرسمية. ولكن هذه السياسة تسببت في مصاعب كبيرة للمواطنين، فوق ما كانوا يعانونه من غلاء الأسعار وعدم وفاء الدخل بالحاجات الضرورية؛ إذ أضيفت إلى معاناة الوقوف في طوابير الخبز والوقود، مشكلة الازدحام في المصارف من أجل الحصول على النقود، والتي بلغت ذروتها أيام عيد الأضحى في العام المنصرم (2018)، عندما واجه كثيرون مشكلةً في سحب إيداعاتهم أو تسلّم رواتبهم، حتى بدا البلد كأنه يواجه شللًا كاملًا، وبدا النظام غير مكترثٍ لذلك؛ إذ كان همّه منصبًا على تعديل الدستور، حتى يسمح للبشير بولايةٍ أخرى ابتداء من عام 2020.
وقد زاد الاحتقان مع خيبة الأمل في إمكان أن يُثمر الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس البشير مطلع عام 2014 عن نتائج إيجابية؛ إذ رفض النظام تقديم أي تنازلاتٍ حقيقيةٍ في جلسات الحوار، أو حتى الاستجابة لمطلب المعارضة بتأجيل انتخابات 2015، إلى حين التوافق في دستورٍ جديدٍ وإجراءاتٍ انتخابيةٍ نزيهة. بل إن بعض أهم المشاركين في الحوار تم اعتقالهم، كما حدث مع رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي.
في ظل هذا الوضع، لم يكن الأمر يحتاج إلى أكثر من شرارة لتفجير الاحتجاجات. وقد حاول الرئيس البشير تلافي مزيدٍ من التدهور، عندما قام بتعيين رئيس جديد للوزراء في أيلول/ سبتمبر 2018، ولكن الحكومة الجديدة احتفظت بمعظم وزرائها السابقين، ولم تستطع وقف تدهور سعر العملة أو توفير المواد والسلع الأساسية، بل إنها ذهبت إلى رفع أسعار الخبز، والتلميح إلى رفع أسعار المحروقات؛ ما أدى إلى تفجّر الأوضاع.
تماسك النظام
أحدث اندلاع التظاهرات واستمرارها وضعًا جديدًا، زادت فيه ثقة المعارضة بنفسها وبقدرتها على تحدّي النظام للمرة الأولى منذ عام 1990. كما بدا النظام معزولًا إلى حد بعيد؛ إذ امتنعت وحداتٌ من الجيش عن قمع التظاهرات في عدد من المدن، وأعلنت مليشيات الجنجويد (التي استثمر فيها النظام لقمع تمرّد إقليم دارفور ابتداء من عام 2003) عدم المشاركة في التصدّي للاحتجاجات. وكان النظام قد خسر قطاعاتٍ واسعةً من مناصريه، وفيهم بعض القيادات الحزبية المهمة، بسبب استئثار الرئيس ودائرته الضيقة بالسلطة، وتوجيه جل سياساته إلى خدمة هذا الاستئثار.
ومع ذلك، ظل النظام متماسكًا، فلم تقع انشقاقاتٌ في الجيش، وهو قاعدة حكم البشير الرئيسة.
وقد يعود ذلك جزئيًا إلى طبيعة الخطاب الذي استخدمه بعض المتحدّثين باسم الاحتجاجات، عندما هدّدوا بـ "اجتثاث" الإسلاميين ومعاقبتهم، بغض النظر عما إذا كانوا من أنصار النظام أو ممن انشقوا عنه، وصدور مطالبات بـ "تطهير" مؤسسات الدولة، خصوصًا العسكرية، من معظم كوادرها التي عينها النظام الحالي. بل إن بعضهم "شنق" دمية على أحد الجسور، في تهديدٍ رمزيٍّ واضح بإمكان حصول انتقامات في حال سقط النظام.
وقد لوحظ انتشار عناصر مدنية بأزياء عسكرية كانت تساهم في قمع التظاهرات. ويُعتقد أن هذه المجموعات جزء مما تسمى "الشرطة الشعبية"، وهي تشكيلاتٌ من أنصار النظام الذين كانوا يؤدّون مهماتٍ تشبه مهمات "لجان الأمر بالمعروف" في السعودية. في الوقت نفسه، صعّد النظام من سياساته القمعية، واستخدامه القبضة الحديدية ضد المتظاهرين، ومن ذلك الاعتقالات واقتحام المنازل وإطلاق الرصاص الحي.
الخوف من المجهول
يعكس التوزان بين تصاعد الاحتجاجات من جهة، وفاعلية إجراءات القمع التي استخدمها النظام، إضافة إلى الخوف من المجهول من جهة أخرى، حالة انسداد الأفق القائمة حاليًا. وعلى الرغم من أن الاحتجاجات جرّدت النظام مما تبقى له من شرعية، وأفقدته معظم قاعدة دعمه الجماهيري، فإن الخوف، خصوصا في أوساط الطبقة الوسطى المدينية، من "الفوضى" وانعدام الأمن، في حال انهيار النظام من دون التوصل إلى توافقٍ بشأن البديل، كبح من الاندفاع نحو التغيير. وقد تبنّى النظام أخيرا خطاب التحذير من الفوضى، والمقارنة باليمن وليبيا وسورية، مع أن هذا الاحتمال يبدو ضئيلًا؛ بسبب عدم وجود قوى إقليمية مستعدة للدخول في صراع أهلي في حال وقوعه، وبسبب وجود مؤسسات وأحزاب سياسية عريقة في السودان، قادرة على الدخول في حوارٍ فيما بينها. لقد جرّب السودان التعدّدية والانتخابات التنافسية عدة مرات، وكانت التجربة الديمقراطية دائمًا تنتهي بانقلابٍ عسكري. ووقعت الحروب الأهلية في ظل الانقلابات العسكرية، وليس في ظل الديمقراطية.
وكان النظام استخدم سلاح التخويف من الفوضى والعنف، بالتوازي مع القمع العنيف، لإحباط انتفاضةٍ سابقةٍ اندلعت في أيلول/ سبتمبر 2013، وذلك بترويج أن مجموعاتٍ تنتمي إلى مليشيات التمرّد المسلح هي مَن يقود التظاهرات، ويمارس أعمال الحرق والنهب التي صاحبتها. وهو، في الانتفاضة الحالية، يحاول اتباع الإستراتيجية ذاتها، ولكن بنجاحٍ أقل، على ما يبدو، هذه المرة.
توافق دولي بشأن دعم النظام
من المفارقات أن يحظى النظام بدعمٍ معتدلٍ من كل القوى الإقليمية والدولية المتصارعة، فلن تحارب أي دولةٍ من أجله. ولكن لا يبدو أن أي دولةٍ تدعم الانتفاضة الشعبية؛ إذ تخشى
السعودية والإمارات من سقوط النظام الذي يقاتل إلى جانبهما في اليمن، والمعروف أن السودان من الدول القليلة التي وافقت على طلبٍ سعوديٍّ بإرسال قوات برية إلى اليمن، للمشاركة في القتال ضد التمرّد الحوثي. ثمّ إن دول الثورة المضادة، ومنها مصر، تخشى نجاح أي ثورةٍ شعبيةٍ جديدةٍ في المنطقة تعيد الروح إلى ثورات الربيع العربي. من جهة أخرى، يحظى النظام السوداني بدعم تركيٍّ واضح؛ نتيجة العلاقات القوية التي أنشأها مع أنقرة، وخصوصا خلال السنوات القليلة الماضية. كما أن قطر لا تدعم أي عملٍ يقود إلى إسقاط النظام الذي رفض الانضمام إلى الحصار، على الرغم من الضغط السعودي. ويبدو أن محور روسيا - إيران يؤيده أيضًا، سيما بعد زيارة الرئيس السوداني أخيرا لدمشق؛ حيث كان أول زعيم عربي يزور سورية منذ اندلاع الثورة فيها، ما فتح الباب لحملة "تطبيع" مع النظام السوري، تقودُها الإمارات.
يُضاف إلى ذلك أن النظام يتمتع بعلاقاتٍ قويةٍ مع الصين التي وقفت إلى جانبه منذ وصوله إلى السلطة في حزيران/ يونيو 1989، حتى في ظل العزلة الدولية التي فرضتها عليه الولايات المتحدة والدول الإقليمية المتحالفة معها. وكان الدعم الصيني محوريًا في تمكين النظام من دعم الحركات المسلحة التي أسقطت النظامين الأثيوبي والتشادي في عام 1991، في وقتٍ كان السودان يعيش عزلةً كبرى، بسبب موقفه من حرب الخليج عام 1991، واتهامه برعاية الإرهاب. كذلك فإن الصين (بالاشتراك مع ماليزيا) أدّت دورًا محوريًا في جهود استخراج النفط السوداني في نهاية التسعينيات، في سابقةٍ عالميةٍ هي الأولى من نوعها، تقوم فيها شركاتٌ غير غربية باستخراج النفط ومعالجته وتسويقه، وقد سمح ذلك بتعزيز قبضة النظام على السلطة، بسبب الموارد المالية التي حصل عليها من عمليات تصدير النفط. كما تأتي الاحتجاجات في وقتٍ لا تبدو فيه واشنطن متحمسةً لأي موجةٍ جديدةٍ من التغييرات في المنطقة، في وقت تحسنت فيه علاقاتها بالنظام في الخرطوم، بعد حل أكثر القضايا التي دفعتها إلى عزلهن وفرض عقوباتٍ عليه، وفي مقدمتها قضايا دعم الإرهاب ومشكلة الجنوب الذي انفصل عام 2011.
خاتمة
يدعم النظام الدولي والإقليمي نظام الرئيس عمر البشير على نحو غير فاعل؛ فالدول التي تدعمه لم تسانده اقتصاديًا خلال الأزمة الحالية، ولن تتدخل مباشرة. ولذلك يبقى العامل الرئيس هو التوازنات الداخلية التي سوف تحسم الصراع، فقد انهار نظام الرئيس الأسبق، جعفر النميري، عندما كان في ضيافة البيت الأبيض. ويتوقف الأمر على موقف الجيش، وعلى إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية يتنازل فيها البشير عن السلطة، وتتشكل بموجبها حكومة وحدةٍ وطنية (تشارك فيها قوى المعارضة)، تدير البلاد إلى مرحلةٍ انتقالية، تُعِدّ خلالها لحوار وطنيٍّ ودستورٍ جديد وانتخاباتٍ تمهد الطريق نحو تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد، غير أن كل الدلائل تشير إلى أن هذه الشروط لم تتوفر بعد، لضمان الوصول إلى هذه النتيجة، وتجنيب البلاد مزيدًا من العنف والفوضى.
الأسباب المباشرة للاحتجاجات
شكلت المصاعب الاقتصادية، وتحديدًا قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، السبب الرئيسَ لتفجّر الاحتجاجات في مدينة عطبرة التي تقع إلى الشمال الشرقي، على بعد 310 كيلومترات من العاصمة. وهي مدينةٌ عماليةٌ يعمل غالبية أهلها في السكك الحديدية. وقد أعادت الاحتجاجات إلى الأذهان ظروف انتفاضة نيسان/ أبريل 1985، التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري (1969- 1985)، حين أعلن حزمةً من القرارات؛ تنفيذًا لتوصيات البنك الدولي في التقشف ورفع الدعم عن الخبز والمحروقات.
وتعود الأزمة الحالية التي يواجهها النظام إلى سلسلةٍ من الإجراءات بدأت في نهاية عام
وقد زاد الاحتقان مع خيبة الأمل في إمكان أن يُثمر الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس البشير مطلع عام 2014 عن نتائج إيجابية؛ إذ رفض النظام تقديم أي تنازلاتٍ حقيقيةٍ في جلسات الحوار، أو حتى الاستجابة لمطلب المعارضة بتأجيل انتخابات 2015، إلى حين التوافق في دستورٍ جديدٍ وإجراءاتٍ انتخابيةٍ نزيهة. بل إن بعض أهم المشاركين في الحوار تم اعتقالهم، كما حدث مع رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي.
في ظل هذا الوضع، لم يكن الأمر يحتاج إلى أكثر من شرارة لتفجير الاحتجاجات. وقد حاول الرئيس البشير تلافي مزيدٍ من التدهور، عندما قام بتعيين رئيس جديد للوزراء في أيلول/ سبتمبر 2018، ولكن الحكومة الجديدة احتفظت بمعظم وزرائها السابقين، ولم تستطع وقف تدهور سعر العملة أو توفير المواد والسلع الأساسية، بل إنها ذهبت إلى رفع أسعار الخبز، والتلميح إلى رفع أسعار المحروقات؛ ما أدى إلى تفجّر الأوضاع.
تماسك النظام
أحدث اندلاع التظاهرات واستمرارها وضعًا جديدًا، زادت فيه ثقة المعارضة بنفسها وبقدرتها على تحدّي النظام للمرة الأولى منذ عام 1990. كما بدا النظام معزولًا إلى حد بعيد؛ إذ امتنعت وحداتٌ من الجيش عن قمع التظاهرات في عدد من المدن، وأعلنت مليشيات الجنجويد (التي استثمر فيها النظام لقمع تمرّد إقليم دارفور ابتداء من عام 2003) عدم المشاركة في التصدّي للاحتجاجات. وكان النظام قد خسر قطاعاتٍ واسعةً من مناصريه، وفيهم بعض القيادات الحزبية المهمة، بسبب استئثار الرئيس ودائرته الضيقة بالسلطة، وتوجيه جل سياساته إلى خدمة هذا الاستئثار.
ومع ذلك، ظل النظام متماسكًا، فلم تقع انشقاقاتٌ في الجيش، وهو قاعدة حكم البشير الرئيسة.
وقد لوحظ انتشار عناصر مدنية بأزياء عسكرية كانت تساهم في قمع التظاهرات. ويُعتقد أن هذه المجموعات جزء مما تسمى "الشرطة الشعبية"، وهي تشكيلاتٌ من أنصار النظام الذين كانوا يؤدّون مهماتٍ تشبه مهمات "لجان الأمر بالمعروف" في السعودية. في الوقت نفسه، صعّد النظام من سياساته القمعية، واستخدامه القبضة الحديدية ضد المتظاهرين، ومن ذلك الاعتقالات واقتحام المنازل وإطلاق الرصاص الحي.
الخوف من المجهول
يعكس التوزان بين تصاعد الاحتجاجات من جهة، وفاعلية إجراءات القمع التي استخدمها النظام، إضافة إلى الخوف من المجهول من جهة أخرى، حالة انسداد الأفق القائمة حاليًا. وعلى الرغم من أن الاحتجاجات جرّدت النظام مما تبقى له من شرعية، وأفقدته معظم قاعدة دعمه الجماهيري، فإن الخوف، خصوصا في أوساط الطبقة الوسطى المدينية، من "الفوضى" وانعدام الأمن، في حال انهيار النظام من دون التوصل إلى توافقٍ بشأن البديل، كبح من الاندفاع نحو التغيير. وقد تبنّى النظام أخيرا خطاب التحذير من الفوضى، والمقارنة باليمن وليبيا وسورية، مع أن هذا الاحتمال يبدو ضئيلًا؛ بسبب عدم وجود قوى إقليمية مستعدة للدخول في صراع أهلي في حال وقوعه، وبسبب وجود مؤسسات وأحزاب سياسية عريقة في السودان، قادرة على الدخول في حوارٍ فيما بينها. لقد جرّب السودان التعدّدية والانتخابات التنافسية عدة مرات، وكانت التجربة الديمقراطية دائمًا تنتهي بانقلابٍ عسكري. ووقعت الحروب الأهلية في ظل الانقلابات العسكرية، وليس في ظل الديمقراطية.
وكان النظام استخدم سلاح التخويف من الفوضى والعنف، بالتوازي مع القمع العنيف، لإحباط انتفاضةٍ سابقةٍ اندلعت في أيلول/ سبتمبر 2013، وذلك بترويج أن مجموعاتٍ تنتمي إلى مليشيات التمرّد المسلح هي مَن يقود التظاهرات، ويمارس أعمال الحرق والنهب التي صاحبتها. وهو، في الانتفاضة الحالية، يحاول اتباع الإستراتيجية ذاتها، ولكن بنجاحٍ أقل، على ما يبدو، هذه المرة.
توافق دولي بشأن دعم النظام
من المفارقات أن يحظى النظام بدعمٍ معتدلٍ من كل القوى الإقليمية والدولية المتصارعة، فلن تحارب أي دولةٍ من أجله. ولكن لا يبدو أن أي دولةٍ تدعم الانتفاضة الشعبية؛ إذ تخشى
يُضاف إلى ذلك أن النظام يتمتع بعلاقاتٍ قويةٍ مع الصين التي وقفت إلى جانبه منذ وصوله إلى السلطة في حزيران/ يونيو 1989، حتى في ظل العزلة الدولية التي فرضتها عليه الولايات المتحدة والدول الإقليمية المتحالفة معها. وكان الدعم الصيني محوريًا في تمكين النظام من دعم الحركات المسلحة التي أسقطت النظامين الأثيوبي والتشادي في عام 1991، في وقتٍ كان السودان يعيش عزلةً كبرى، بسبب موقفه من حرب الخليج عام 1991، واتهامه برعاية الإرهاب. كذلك فإن الصين (بالاشتراك مع ماليزيا) أدّت دورًا محوريًا في جهود استخراج النفط السوداني في نهاية التسعينيات، في سابقةٍ عالميةٍ هي الأولى من نوعها، تقوم فيها شركاتٌ غير غربية باستخراج النفط ومعالجته وتسويقه، وقد سمح ذلك بتعزيز قبضة النظام على السلطة، بسبب الموارد المالية التي حصل عليها من عمليات تصدير النفط. كما تأتي الاحتجاجات في وقتٍ لا تبدو فيه واشنطن متحمسةً لأي موجةٍ جديدةٍ من التغييرات في المنطقة، في وقت تحسنت فيه علاقاتها بالنظام في الخرطوم، بعد حل أكثر القضايا التي دفعتها إلى عزلهن وفرض عقوباتٍ عليه، وفي مقدمتها قضايا دعم الإرهاب ومشكلة الجنوب الذي انفصل عام 2011.
خاتمة
يدعم النظام الدولي والإقليمي نظام الرئيس عمر البشير على نحو غير فاعل؛ فالدول التي تدعمه لم تسانده اقتصاديًا خلال الأزمة الحالية، ولن تتدخل مباشرة. ولذلك يبقى العامل الرئيس هو التوازنات الداخلية التي سوف تحسم الصراع، فقد انهار نظام الرئيس الأسبق، جعفر النميري، عندما كان في ضيافة البيت الأبيض. ويتوقف الأمر على موقف الجيش، وعلى إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية يتنازل فيها البشير عن السلطة، وتتشكل بموجبها حكومة وحدةٍ وطنية (تشارك فيها قوى المعارضة)، تدير البلاد إلى مرحلةٍ انتقالية، تُعِدّ خلالها لحوار وطنيٍّ ودستورٍ جديد وانتخاباتٍ تمهد الطريق نحو تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد، غير أن كل الدلائل تشير إلى أن هذه الشروط لم تتوفر بعد، لضمان الوصول إلى هذه النتيجة، وتجنيب البلاد مزيدًا من العنف والفوضى.