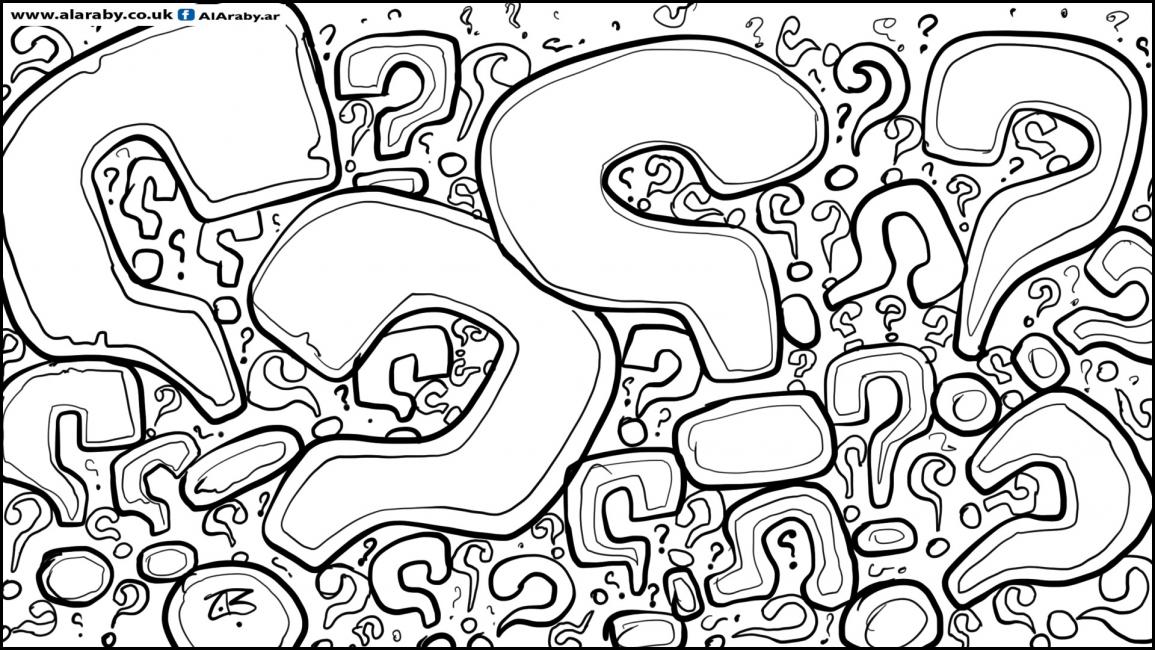هل توجد أيديولوجية إسلامية حقاً؟

وافق حزب العدالة والتنمية، الإسلامي، على التطبيع مع الصهاينة. الحزب مغربي، وأسبابه مغربية. يريد المغرب الاعتراف الأميركي بسيادته على صحرائه الغربية. عرض الرئيس ترامب الاعتراف مقابل التطبيع، وافق الملك، ووافق الإسلاميون. في الجزائر تتبنّى الدولة موقفا انفصاليا في قضية الصحراء الغربية، موقفا مختلفا عن موقف المغرب، ويتبنّى الإسلاميون الجزائريون (حركة حمس) بدورهم موقف دولتهم الذي يدعم مصالحها، ومن ثم مصالحهم. الإسلام في المغرب وحدوي تطبيعي، والإسلام في الجزائر انفصالي أممي! الإسلام في المغرب مع ترامب، وفي الجزائر ضده، الإسلام مع الإسلاميين في الشيء وضده... ما معنى ذلك؟
يزعم الخطاب الإسلامي "الحركي" أن أصحابه مختلفون عن غيرهم، ليسوا سواء، فهم ممثلو الهوية. أما الليبرالي أو اليساري فهو يتبنّى أفكارا دخيلة. الإسلاميون يتبنّون قضايا أمتهم، ويتجاوزون مفاهيم الدولة القومية القطرية إلى مفهوم الأمة. لدى الإسلاميين تصوّرات صلبة، السياسة عندهم عمل شرعي، أخلاقي، عقائدي، وليس ممارسة مدنّسة، وصراعا دنيويا على مصادر الثروة والقوة، هي لله. الفرق بين الإسلاميين ومنافسيهم، في الخطاب الحركي، هو بين المقدّس والمدنس. والآن.. يتجاوز الإسلاميون المقدّس إلى المدنس، الأمة إلى الدولة، الشرع إلى الثروة والقوة، المقاومة إلى التطبيع، فلسطين إلى إسرائيل، فماذا تبقّى منهم، وماذا تبقّى من خطابهم، وماذا تبقّى من أيديولوجيتهم، وماذا تبقى من الإسلام الحركي كله؟!
لا يتعلق الأمر بالإكراه السياسي، ولا يتعلق بمحاولة الإسلاميين الاقتراب أكثر من الدولة الوطنية، وقطع الطريق على مزايدات خصومهم بأنهم ليسوا وطنيين، إنما يتعلّق بموقفٍ "ثابت" ومتكرّر لدى الإسلاميين، فهم ربّانيون إلى أن تأتي السلطة، بعدها يعود العمل السياسي إلى "علمانيته"، في نسختها غير الأخلاقية. في مصر، تحالف الإخوان المسلمون الأوائل مع القصر، وهتفوا "الله مع الملك"، أتوا بالله نفسِه ليقف مع فاروق الأول ضد خصومه، ثم تحالفت الجماعة مع الضباط الأحرار ضد الملك، وبرّروا سياساتهم وإعداماتهم، قبل أن ينقلب عليهم جمال عبد الناصر. تكرّر الأمر مع أنور السادات، قبل أن ينقلب بدوره، وتجمّد مع حسني مبارك، على الرغم من محاولاتهم لعرض خدماتهم. وجاءت الثورة، حَكَم "الإخوان"، واحتاجوا ظهيرا عسكريا، تحالفوا مع عبد الفتاح السيسي، رجل مبارك، مدير مخابراته العسكرية، سبق أن ذهب إلى الميدان، وقت الثورة، وقابل القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، وهدّده. أبلغهم البلتاجي بذلك، ولم يلتفتوا. سبق أن أجرى السيسي بنفسه كشوف العُذرية، والقضية شهيرة، وملفّها على مكتب الرئاسة، منذ اليوم الأول، لم يلتفتوا، تحالفوا، السلطة قبل الدين وفوقه، الدين، في صيغته الإسلاموية، ليس متبوعا، بل تابعا، ومسوّغا، ومبرّرا، وممرّرا، وأفيونا للشعوب والأتباع!
لا يتوقف الأمر عند الحفاظ على السلطة أو التحالف معها، بل يتجاوزه إلى موقف الإسلاميين من كل شيء. لا توجد مواقف صلبة، لا توجد قيمة ثابتة. لا يوجد معيار واحد. الديمقراطية مقبولة ولا تتعارض مع الإسلام إذا جاءت بالإسلاميين، والانقلابات جريمة إذا انتزعتهم، في السودان عام 1989، ويوم 30 يونيو/ حزيران. للمفارقة وسخرية الأقدار، ينجح انقلابٌ عسكري، يقوم به إسلاميون، يفرح الإسلاميون، ويعتبرونه نصرا من الله، صار الانقلاب نصرا! والله مع الانقلابيين! يتورّط في تأييده الإسلاميون في مصر، ويعتبرونه "إرادة الشعب". يكتب الشيخ محمد الغزالي، وهو من هو، في تأييده والاحتفاء به. يتكرّر الأمر نفسه مع الشيخ يوسف القرضاوي، يتبنّى الديمقراطية بتأويلاتٍ شرعية، الانتخابات، المظاهرات السلمية، ثورات الربيع العربي، يصل الأمر إلى إهدار دم معمر القذافي. بعد الثورة يصبح الخروج على محمد مرسي حراما، من وجهة نظر الشيخ، لأنه منتخب، على الرغم من أن الخروج، وقت صدور الفتوى، كان بالمظاهرات السلمية نفسها. فقه الثورة حاضرٌ لنصرة الإسلاميين وهم معارضون، وفقه طاعة ولي الأمر وحرمة الخروج عليه حاضر لنصرتهم وهم في السلطة. والموقف من الديمقراطية والانقلابات يتحدّد وفق موقع الإسلاميين ومصالحهم. هنا نحن نتحدث عن الغزالي والقرضاوي، وهما من أنبه من أنجبت الحركة الإسلامية، في الخمسين عاما الماضية، فماذا عن غيرهما؟