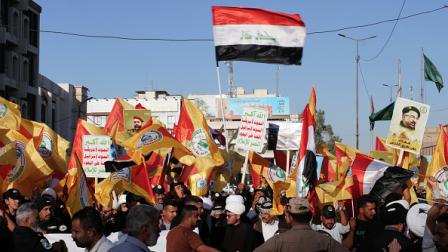بنت حملة ترامب جهودها للتقرب من هذه الأقلية على نظريةٍ في علم السياسة الأميركي، لطالما صنفت هؤلاء بأنهم "الحزب الأميركي الثالث". هذه النظرية، يرى باحثون سياسيون منتقدون لها، أنها من نسج الخيال، وقد لا تجد ما يدحضها بوضوح أكثر من دراسة أنماطٍ لترشح أسماء من أصول أفريقية على مرّ التاريخ الأميركي للرئاسة، نجح من بينها فقط باراك أوباما في تخطي عتبة البيت الأبيض. حينها، قيل إن الولايات المتحدة أصبحت جاهزةً لتقبل رئيسٍ من أصحاب البشرة السوداء، وأنها قد تكون دخلت مرحلة ما بعد التمييز العنصري. كذلك بنت حملة ترامب، في محاولتها اختراق تصويت الأميركيين الأفارقة، والذي يذهب منذ عقود لصالح الديمقراطيين، على حقيقتين: أولاً انخفاض نسبة البطالة لدى السود في عهد ترامب، قبل أزمة وباء كورونا، في جريرة الانخفاض العام في هذه النسبة والأرقام الجيدة للاقتصاد في عهده. أما السبب الثاني، فيرتبط بتحليل للتوجهات السياسية لهذه الشريحة، يقول إنها تشكل تياراً محافظاً، حتى داخل الحزب الديمقراطي، ما يعني إمكانية إبعاد بعض أفرادها عن الحزب الأزرق، عبر تحريك نفورٍ ما من مرشحيه التقدميين، كبيرني ساندرز أو إليزابيث وارن (انسحبا تباعاً من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي).
وضخّت حملة ترامب 10 ملايين دولار بداية العام الحالي، لإعلان "السوبر بول" (نهائي كرة القدم الأميركي) يُظهر امرأة من أصحاب البشرة سوداء خفّض ترامب عقوبة سجنها عام 2018، ويُعدّد جهود الرئيس في مجال إصلاح العدالة الجنائية، وهو مطلب أساسي للمحتجين اليوم. كما استضاف ترامب مواطناً أسود عاطلاً من العمل، وطفلة من أصول أفريقية قدّم لها منحة دراسية، خلال خطاب الاتحاد الأخير. ويعتبر مسؤولون في حملته، أن هدفهم سرقة ولو واحد في المائة من أصوات السود لصالح الحزب الجمهوري، في استراتيجية يقودها صهر الرئيس، جاريد كوشنر. ومن ضمن الحملة، الترويج لمجموعة "الأصوات السوداء لترامب"، التي التقط معها الرئيس صوراً في المكتب البيضاوي. هذه المجموعة المتواضعة، والتي واصلت عقدها اجتماعات افتراضية أسبوعية مع حملة ترامب خلال الأشهر الماضية، ليس معروفاً ما إذا كانت مستمرة، بعدما توالت الصدمات أخيراً: أرقام عالية لإصابات كورونا في صفوف السود، ضعف الرعاية الطبية التي حصلوا عليها، البطالة التي طاولتهم، والمصائر القاتمة لأعمالهم ما بعد كورونا، مقارنة بالأميركيين البيض. وجاء مقتل فلويد، وقبله أحمد أربيري وبريونا تايلور، وغيرهما على يد الشرطة، ليقضي على آخر الآمال بمرحلة أميركا ما بعد العنصرية.
ولأن الحديث هو عن هذه الشريحة المجتمعية تحديداً في المشهد السياسي الأميركي، وموقعها داخل الخريطة السياسية، يجوز تحييد حقائق إضافية، أهمها اختلاط العامل العنصري خلال الاحتجاجات الدائرة حالياً، بما عداه. تحسن الاقتصاد في عهد ترامب، يخفي تواصل إحكام واحد في المائة من الأميركيين قبضتهم على ثروات الولايات المتحدة. وحتى في مينيابوليس، التي تفجرت فيها الأزمة في 25 مايو/ أيار الماضي، والتي تعد من أكثر المدن الأميركية قابلية للعيش، يقل المدخول السنوي للسود بثلاثة أضعاف عن مدخول البيض.
لكن ذلك لا يفسر وحده توجه السود للتصويت ديمقراطياً منذ سبعينيات القرن الماضي، حتى ولو لم يدخل حيّز التنفيذ بعد خطاب الناشط الحقوقي جيسي جاكسون إليهم عام 1984، عندما ترشح للرئاسة عن الحزب. حينها قال جاكسون إن "رسالتنا للديمقراطيين البيض، هي أنه لا يجب أن تضعوا التصويت الأسود في جيبكم، فقط لأن لا مكان آخر لنا للذهاب إليه". اليوم، لا يزال الأميركيون من أصول أفريقية يعيشون في جلباب الحزب الأزرق، ولا مكان آخر للتوجه إليه، على الرغم من قوتهم الانتخابية.
من حزب لينكولن إلى روزفلت
في مارس/ آذار 1870، أدلى توماس ماندي بيترسون بصوته في انتخابات محلية بنيوجرسي، كأول أميركي من أصول أفريقية يمارس حقّه بالتصويت في الولايات المتحدة، بعد تمرير التعديل الـ15 للدستور، في فبراير/ شباط من العام نفسه. واحتفل الأميركيون في فبراير الماضي، بمرور 150 عاماً على هذا التعديل، الذي أقر لـ"منع الحكومة الفيدرالية، وأي ولاية، من حرمان حق التصويت بناءً على اللون، أو العرق، أو وضع سابق للاستخدام (العبودية)"، على الرغم مما لا يزال يتعرض له هذا التعديل اليوم مما يشبه الـ"مضايقات الحقوقية". منذ ذلك الحين، أعطى الأميركيون السود أصواتهم للجمهوريين، باعتبارهم حزب "الإلغائيين" للعبودية، وحزب "محررهم" أبراهام لينكولن، من دون الالتفات إلى الجدلية السياسية التي رافقت أسباب هذا التحرير، وخطاب الشماليين المؤسس للرأسمالية: "اقتصاد حر، يعني عمالة حرّة". ولم يُمنح السود حقّ حضور المؤتمر العام للحزب الديمقراطي سوى في العام 1924. ويرتبط ابتعاد هؤلاء عن الحزب، من جملة أسبابه، بارتباط الديمقراطيين الجنوبيين بالعبودية، والتي أعادت حرمانهم من التصويت. ولم يعد السود فعلياً للانخراط في السياسة الأميركية حتى بدايات القرن الـ20، مع هجرتهم إلى الشمال وهروبهم من نظام جيم كرو القمعي في الجنوب (1870 حتى منتصف ستينيات القرن الماضي). وحتى مع ذلك، فقد تعرضوا للتضييق بقوانين للولايات وضعت شروطاً على تصويتهم، وبعنف الجماعات العنصرية، إلى أن جاءت "الصفقة الجديدة" أو العقد الجديد، الذي وضع الرئيس الـ32 للولايات المتحدة، الديمقراطي فرانكلين روزفلت (1933 -1945)، بموجبه برنامجاً معيناً للأقليات، ومن ثم رفع الحزب لواء الحريات المدنية (جون كينيدي، ووقع الرئيس الديمقراطي ليندون جونسون قانون الحريات المدنية في العام 1964).
هذه اللمحة التاريخية المختصرة، قد تفسر اليوم تمسك هذه الأقلية بالحزب الديمقراطي. يقول كلّ من إسماعيل وايت وكريل ريد، في كتاب "صعود الديمقراطيين: كيف تحدد القوة الاجتماعية السلوك السياسي للسود"، إنه على الرغم من تحسن مستوى المعيشة للسود في الولايات المتحدة، ودخولهم نادي الطبقات الوسطى والغنية، وتنوع آرائهم السياسية، إلا أن ذلك لم يسهل عودتهم للحضن الجمهوري، خصوصاً بسبب تفضيلهم التوحد والالتفاف في بلد ثنائي الحزبية، لإعلاء شأن قضيتهم ونضالهم، ما جعل تأييدهم للحزب الأزرق بمثابة "نمطٍ للتمكين السياسي". يأتي ذلك مع موجة تقدمية وشابة داخل الكتلة السوداء المصوتة للحزب، تعزز المنافسة في صفوفه، وهو ما باتت تدركه القيادة الديمقراطية اليوم.
ظاهرة أوباما
من الأخطاء الشائعة في التاريخ الأميركي أن عضو مجلس النواب الديمقراطي شيرلي شيزهولم، من ولاية نيويورك، هي أول أميركية من أصول أفريقية تترشح للرئاسة الأميركية عن حزب رئيسي، وذلك في عام 1972. كانت شيزهولم أول أميركية سوداء تدخل الكونغرس عام 1968، كنائبة عن نيويورك. كذلك حلم جيسي جاكسون، وآخرون، بما حققه السيناتور باراك أوباما عام 2008. لكن المرشح الأول من أصحاب البشرة السوداء للرئاسة، هو فريديريك دوغلاس، الذي ولد عبداً في ماريلاند عام 1818، وحصل على صوت واحد من مندوب في كنتاكي، خلال ترشحه للرئاسة عن الحزب الجمهوري عام 1888. كما يتحدث التاريخ عن جورج إدوين تايلور، الذي ترشح في العام 1904 عن حزب الحرية الوطني (أو حزب الحرية الوطني للنيغرو). وأخيراً، تراجع الطبيب من أصول أفريقية بن كارسون عن ترشحه للرئاسة عن الحزب الجمهوري لصالح دونالد ترامب عام 2016، ثم تمّ توزيره. وووفقاً لتقرير صادر عن معهد "بيو" للأبحاث في العام 2016، لم تعرف الحكومات الأميركية أكثر من 22 وزيراً من ذوي البشرة السوداء.
وبحسب التقرير نفسه، فإن أربعة من أصل 10 مواطنين أميركيين سود يرون أن التقدم السياسي يشكل تكتيكاً قوياً بالنسبة إلى هذه الشريحة لتمكين قضيتها. لكن حتى العام 1965، لم يكن هناك أي سيناتور أسود في الكونغرس، أو أي حاكم أسود لولاية أميركية، فيما يبلغ اليوم عدد النواب السود 52 نائباً (12 في المائة)، ما يعتبر متوازناً مع نسبة المواطنين السود في الولايات المتحدة (14 في المائة). وحتى العام 2013، لم يكن هناك سيناتوران من أصول أفريقية يخدمان معاً في فترة ولاية واحدة لمجلس الشيوخ. كما أن لا حاكم ولاية أسود اليوم في الولايات المتحدة، وتبوأ أربعة فقط منهم هذا المنصب في التاريخ الأميركي.
هذه الوقائع، تفسر ربما تقدير المتابعين، وكذلك السود، بتحقيق العدالة العرقية، مع وصول أوباما إلى البيت الأبيض، على الرغم من الظروف الكثيرة التي ساهمت في ذلك، وأهمها تبني أوباما لخطاب عالمي، ومتحرر عرقياً. وترى ليزا فيروني باتشر، في دورية "أبحاث الحضارة الأميركية"، أن هذا الخطاب أصبح ضرورياً لتمكين السود سياسياً في الولايات المتحدة. وقد يكون هذا التكتيك اعتمده جيسي جاكسون عام 1988، حين ترشح مرة ثانية للرئاسة، ما ضاعف عدد الأصوات التي منحت له. ويقول نوام في "نيو ريبابلك"، إن "الناخبين البيض يخشون التصويت لمرشح أسود، لذا عليه أن يترشح في منطقة ذات غالبية من عرقه. وأفضل التكتيكات للصعود، هي أن يبني لسنوات هوية سياسية تتخطى العرق أو تربطه بأيديولوجيا معتدلة".
اليوم، يبلغ عدد الأميركيين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة 47.8 مليون نسمة، ما يشكل 14.6 في المائة من السكان، بحسب مكتب الإحصاء السكاني عام 2018. ووفق موقع "بلاك ديمغرافيك"، اعتبر 48 في المائة من السود أنفسهم ديمقراطيين ملتزمين في العام 2016، و22 في المائة ديمقراطيين "غير ملتزمين"، بينما صنف 10 في المائة أنفسهم كمستقلين قريبين من الديمقراطيين، و8 في المائة فقط كجمهوريين، أو قريبين من الجمهوريين.
أما بالنسبة إلى التوزع الديمغرافي، فتضم العاصمة واشنطن أكبر عدد من السكان السود (48 في المائة)، تليها ميسيسيبي وجورجيا وماريلاند وكارولينا الشمالية، و8 في المائة في مينيسوتا، حيث تفجرت الاحتجاجات الأخيرة في مينيابوليس. ويتوزع 55 في المائة من السود في الجنوب الغربي وجنوب الوسط.
ومنذ العام 1970، شهدت الولايات المتحدة هجرة معاكسة جديدة للأميركيين الأفارقة من الشمال إلى الجنوب، بعد هجرتهم الكبيرة إلى الشمال (1916 – 1970)، ما غيّر الأنماط الانتخابية. وتعززت وتيرة هذه الهجرة مع بداية الألفية الثالثة، هرباً من الانكماش الاقتصادي في ما يعرف بولايات "حزام الصدأ". ويقول الديمغرافي الأميركي بيل فراي، من معهد بروكينغز، لـ"ذا غارديان"، إن الولايات التي حققت النسبة الأعلى من التموضع الإضافي الأسود هي جميعها ولايات متأرجحة، كجورجيا وتكساس وفلوريدا وكارولينا الشمالية.
في المحصلة، يجمع المؤرخون على أن الأميركيين من أصول أفريقية يتمسكون بوفائهم لمن يثقون به، ما يبقي جو بايدن في منطقة الأمان للحصول على دعمهم في رئاسيات 2020. وفيما يعول ترامب على دعم البيض الأوفياء أيضاً، سيبقى السود بمثابة بيضة قبان لوصول أي رئيس إلى البيت الأبيض. هؤلاء يفضلون تسميتهم بالسود على الأميركيين من أصول أفريقية، كما يؤكد استطلاع للرأي، لافتاً إلى أن 80 في المائة منهم يتواصلون في منتدياتهم السياسية مع من هم من لونهم. وفيما يدخل الحراك المدني الأميركي فصلاً جديداً، يبدو الخروج من الغيتو السياسي لهذه الشريحة المجتمعية معقداً، بحجم تعقيدات تجذر العنصرية في هذا البلد، منذ أن بني على ظهر السكان الأصليين. هو تعقيد قد يفككه شعار ترامب نفسه للأميركيين السود "ماذا ستخسرون؟". لعله ما يفسر اليوم "ربيع أميركا أسود".