منذ البداية، لا يُخفي الكاتب الفلسطيني، أستاذ الأدب العربي في جامعة كليرمونت الأميركية، بسام فرنجية في تصديره لكتابه "مقدمة للثقافة العربية المعاصرة" (منشورات كونيلا الأكاديمية، كاليفورنيا، 2019) تهيّبه من خوض غمار تأليف كتاب عن الثقافة العربية، فمثل هذه المهمة كما يرى جسيمة، وتعني تحمل مسؤوليات عظمى، وتتضمّن تحديات على رأسها صعوبة الإحاطة بالثقافة العربية الغنية والهائلة والمتعددة الوجوه في كتاب واحد.
ومع ذلك قرّر المغامرة، ومحاولة كتابة ولو مقدمة لهذه الثقافة، حين اقترحت عليه مسؤولة منشورات جامعة ييل، ماري جين بيلوسو، تأليف كتاب من هذا النوع، وقد أدهشها خلو أسواق الناطقين باللغة الإنكليزية من دراسات شاملة عن الثقافة العربية المعاصرة على الرغم من الأهمية الجغرافية/السياسية لهذه المنطقة، وتوجه الأنظار إلى العالم العربي خصوصاً بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001. ومن هنا بدأ يعمل، وقرّر أن يكون مدى كتابه واسعاً على شكل مقدمة شاملة عن غنى الثقافة العربية وجوانبها المعقدة المتميزة، منطلقاً من رغبة تقديم فهم أعمق لماهية الثقافة العربية، وكيف شكلتها أحداث الأزمنة الراهنة، ما يساعد القرّاء على فهم أفضل للخصائص الرئيسية للعرب وثقافتهم ومجتمعهم. كما وضع نصب عينه أنه لا يهدف إلى مديح الثقافة العربية ولا إدانتها بل يقدمها من زاوية نظر قائمة على معرفته بمنطقة نشأ فيها وعلى تجاربه الشخصية.
يبدأ الكتاب بتلك الأزمنة السحيقة التي ظهر فيها الناس الذين أصبحوا العرب، معرَّفين بأهم ما يشترك فيه أي شعب من الشعوب، أي اللغة والثقافة والهوية. ثم يقدم واحدة من موضوعات الكتاب المركزية؛ فمع ظهور الإسلام، وقوته الدينية والثقافية والسياسية اللاحقة في العالم العربي، أصبحت الثقافة العربية متصلة اتصالاً لا انفصام له بالثقافة الإسلامية. صحيح أن الثقافتين غير متماهيتين، لأن العرب تمتعوا قبل الإسلام بثقافة فريدة، وساهمت قوى أخرى في تشكيل الهوية العربية، ولكن من المحال الحديث اليوم في العالم العربي عن ثقافة عربية من دون الاعتراف بدور الإسلام في تحديدها وتعريفها، حتى بالنسبة للمسيحيين والجماعات الدينية الأخرى.
ولأن القصد هو فهم الحاضر العربي، كان من الضروري أن يستكشف الكتاب ثراء تراث هذا الحاضر وتاريخه ولغته وحضارته وديانته وثقافته. والمؤلف يدرك أن الماضي العربي الزاهر في عقول أبناء الشعب العربي ليس أمراً من أمور الماضي، بل هو حيٌّ في ذاكرتهم الجمعية. ولا يزالون اليوم ينظرون إلى الوراء، إلى تلك الفترة التي بدأت في القرنين السابع والثامن الميلاديين حين فتحت إمبراطورية عظيمة العالمَ القديم، وأبدعت حضارة غنية عمرها خمسمائة عام، وأنتجت تطوراً مهماً على صعيد الاقتصاد والتقدّم العلمي، كما أنتجت ازدهاراً ثقافياً.
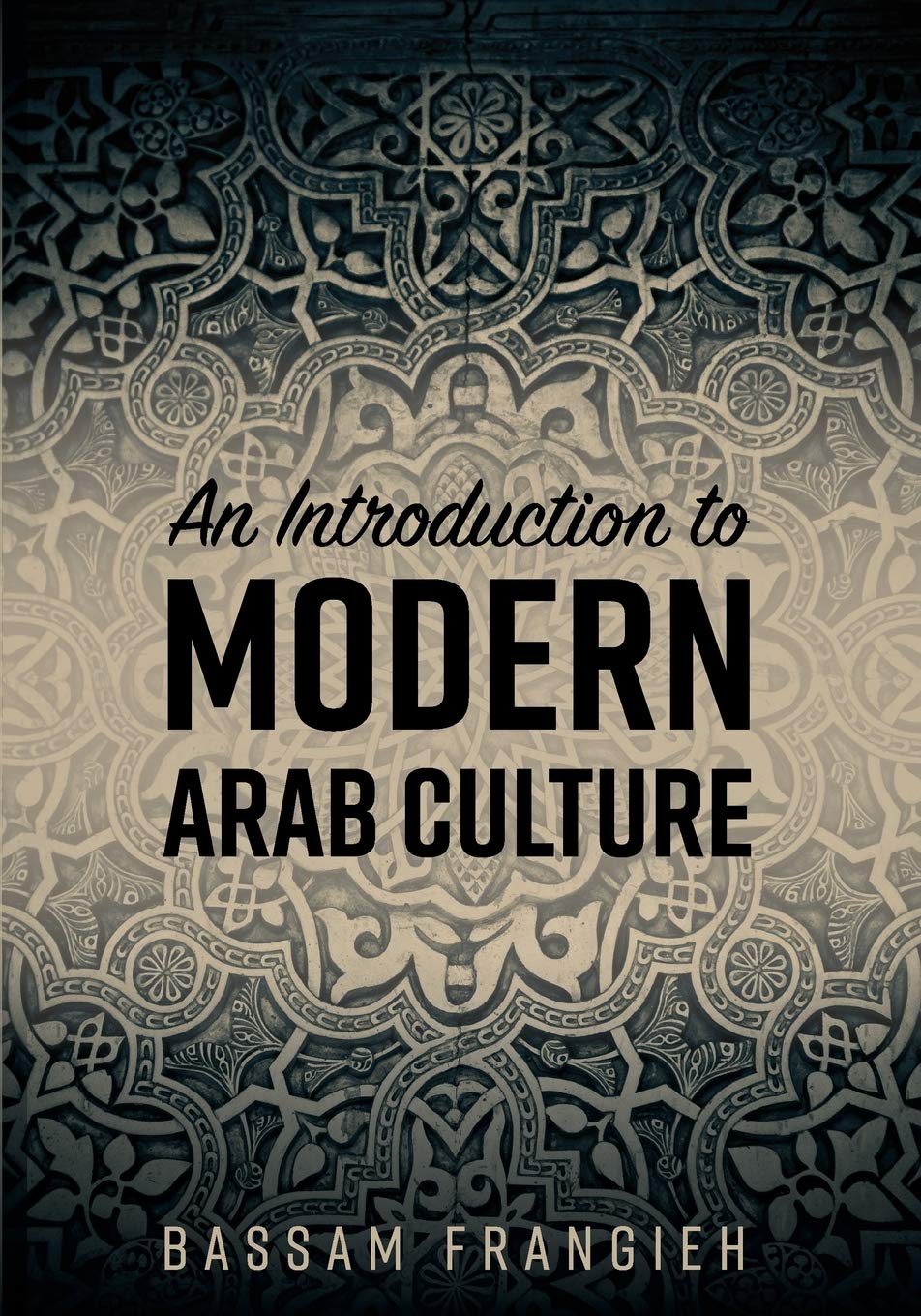 وهذه الفترة هي التي يُحتفى بها كفترة ذهبية تفتحت في "الشرق الأوسط" وآسيا وشمالي أفريقيا وجنوبي أوروبا في وقت كانت فيه بقية أوروبا ضائعة في عتمة القرون الوسطى.
وهذه الفترة هي التي يُحتفى بها كفترة ذهبية تفتحت في "الشرق الأوسط" وآسيا وشمالي أفريقيا وجنوبي أوروبا في وقت كانت فيه بقية أوروبا ضائعة في عتمة القرون الوسطى.
ويسهب الكاتب في التأكيد على الاستقرار والثراء اللذين تميّزت بهما هذه الفترة، وتفصيل ما قدّمه العرب فيها من مساهمات إلى العالم والإنسانية؛ شبكات تجارة واسعة ونشر التعليم على نطاق عالمي واحترام المرونة التي تميزت بها الإمبراطورية.
يقول الكاتب في هذا السياق "صنع العرب حضارة تقدّمية حيوية دينامية، ضمّت سكاناً متنوّعي الأعراق والديانات ساهموا في إنشاء هذا العصر الذهبي العربي. وتجلت هذه الحضارة في تقدم كبير في الحقول العلمية، مثل علوم الكيمياء والرياضيات والفلك والفيزياء والطب والملاحة البحرية، وازدهرت الفلسفة والمعمار والأدب والموسيقى أيضاً، وتجذرت كل هذه الحقول في إطار الاستقرار والتلاحم الثقافي القوي".
ومن هنا يصبح مفهوماً اعتزازُ العرب بماضيهم المجيد هذا، ومن الطبيعي أن يعبّروا عن الحنين والتوق العميق إلى حضارة قادت العالم طوال خمسة قرون، "وأن يظل هذا الماضي حيّاً في عقولهم وقلوبهم" على حد تعبيره. وفي سياق وصفه لهذا التاريخ، يقدم الكثير من خصائص الشعب العربي الثقافية ونوعيتها في عدّة فصول متوالية، تتناول الهوية والأدب والعائلة واللغة والقيم والموروثات والإسلام والقرآن والفكر والتاريخ، والتطورات الاجتماعية والسياسية والموسيقى، واللغة على وجه الخصوص التي كانت أداة مركزية في تطوّر الديانة والعلم والفلسفة والأدب، كما في المناقشات اليومية والأحاديث على امتداد المسافة من مراكش إلى عُمان بلهجات متنوعة وغنية، أساسها هذه اللغة الكلاسيكية الراقية، وفي الشعر المستمد من الأسس نفسها الذي يوفر أكثر انعكاسات العقل العربي رفعة، ويصوّر قيم المجتمعات العربية، ويكشف عن جوهر ثقافتها.
ويلاحظ، حين يتطرّق إلى الشعر المعاصر، أن أبرز شعراء هذه العصر وضعوا أنفسهم في موضع معارضة دائمة للنظام الاجتماعي/ السياسي القائم، يهاجمون عطالته، ويدعون إلى تغييره. ويتواصل ظهور موضوعات ومدارس أدبية جديدة، مع استعارات مبتكرة ومخيلة شعرية وأساليب لفظية معقدة. وفي هذه الفترة، تصبح الرواية العربية أداة فعالة في تصوير المجتمع والثقافة.
إلا أن كل هذا لا يجعل الكاتب يغفل أنه على الرغم من تراث العرب المجيد، والكثير من خصائص ثقافتهم الغنية، يعانون اليوم من الكثير من المعضلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية، وتواجه ثقافتهم الهشاشة والتشظي على الكثير من الصعد. ويبدو هذا التخلف في الزمن الراهن بالنسبة للعرب مناقضاً بشكل صارخ للحضارة الباهرة التي قادت العالم لعدة قرون. والسبب بالطبع هو ما أحدثته الكوارث المتتابعة من تدهور متواصل بدأ في القرن الثالث عشر حين اجتاح المغول بغداد وأحرقوا مكتباتها في عام 1258.
وفي جنوبي إسبانيا انحدرت الممالك العربية وتلاشت في عام 1492، ووقعت غالبية العالم العربي تحت الحكم العثماني لمدة تقارب الأربعة قرون (1516-1918). ومع نهاية الحرب العالمية الأولى حلّ محله الاستعمار الأوروبي. وبعد الحرب العالمية الثانية وعلى الرغم من استقلال غالبية الدول العربية إلا أن هذا العالم وقع تحت هيمنة المصالح الاقتصادية الغربية التي دعمت أنواعاً من الحكومات المستبدة.
وهنا ينتقل الكاتب إلى بحث ما اصطلح على تسميته "أزمات الثقافة العربية" المعاصرة التي هي في نظره نتاج قرون من التراجع والهيمنة الأجنبية، ومظاهرها الركود والاختناق وتجمّد النمو الثقافي بسبب العوائق المفروضة أمام حرية التعبير، وما يتلو هذا من نقد لإخفاق الثقافة العربية المعاصرة من قبل مثقفين وخبراء ذوي آراء وتحليلات متنوعة.
ويؤرخ الكاتب لبواكير اليقظة العربية بدءاً من القرن التاسع عشر بعد غزو نابليون بونابرت لمصر في عام 1789، وتلك المواجهة المفاجئة مع الغرب التي يدعوها بعض الباحثين العرب تقليدياً بـ"صدمة الحداثة"، مع أن الحداثة العربية لم تتحقق بعد أكثر من قرنين. ويشير الكاتب إلى حقيقة أن بعض هؤلاء يرون في هذا نهضة زائفة أو فاشلة، ويؤمن بعضهم أن النهضة العربية الحقيقية والحداثة بدأت فعلياً في القرن الخامس عشر قبل وصول الغربيين بزمن طويل.
ويجادل آخرون، ومنهم الباحث المصري محمود أمين العالم، بحدة في أن الغرب عرقل دائماً أي حركة نهضة عربية محلية بتدخله وهيمنته واستعماره للعالم العربي، ويفضل العالِم استخدام تعبير "صدمة الإجهاض" على تعبير "صدمة الحداثة". ولكن على الرغم من وجود تباين وتعارض في الآراء، هناك قبول عام بأن ثمة يقظة أو نهضة بدأت في القرن التاسع عشر، ويعتقد الكثير من المثقفين أنها انتهت مع هزيمة العرب في عام 1967، وتلاشى الحلم باستقلال حقيقي، ووقعت غالبية الأنظمة العربية، الثرية منها والفقيرة، تحت نفوذ القوى الأجنبية. وحتى الأكثر ثراءً بينها لم تستطع إنتاج تطوّر صناعي وعلمي واجتماعي وسياسي وثقافي لصالح شعوبها.
وبعد أن يعرض الكاتب آراء بعض المثقفين العرب، يرى أنهم منذ النهضة يواجهون تحدّيات كبرى في محاولتهم إحياء ما أمكنهم من عصر الحضارة الذهبي، إلا أنهم كانوا قادرين، إذا أخذنا في الاعتبار فترة التراجع الطويلة والحكم العثماني والاستعمار الغربي وتبعية الكثير من حكامهم للقوى الأجنبية، على إحياء بعض من سمات مهمة وعناصر أساسية من ماضي الحضارة العربية. مثال ذلك أنهم أحيوا لغة العصر الكلاسيكي وحدّثوها، وأحيوا الأدب العربي أيضاً، وخاصة الشعر العربي المتقدم اليوم، والرواية التي وصلت إلى مستويات عالية.
ولا ينسى الكاتب جهود الموسيقيين، والتقدم الكبير الذي حققه أكاديميون وكتاب في حقول الصحافة ووسائط الإعلام والترجمة. ولكن مع كل هذا ظلّت التحديات هائلة والمشاكل بلا حلول في ضوء الوقائع الراهنة غير الصحية اقتصادياً وسياسياً وحوكمة. ويرى الكاتب في ختام فصول كتابه أن هذه التحديات تتضمن مجالات قضايا الوحدة العربية والاستقلال الاقتصادي والتدخل الأجنبي والفكر العربي والنزعة الطائفية والسلطة والقيادة وقابلية المحاسبة والتحديث وإصلاح التعليم.. والقائمة تطول. ومن دون معالجة هذه المعضلات، ومن دون تغيرات سياسية واقتصادية، لا يمكن الإشارة إلى أن نهضة عربية جديدة تحدث حقاً.



