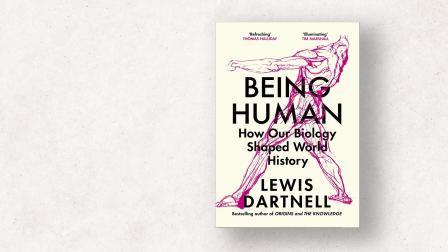في أحد رسومات الفنّان الجزائري عبد الحميد أمين، المعروف باسم "نيم"، يَظهر رئيسُ أركان الجيش الجزائري الراحل، أحمد قايد صالح، وهو يُلبِس أحدَ المرشّحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، التي جرت قبل أيام، حذاءً ذهبياً، بينما اجتمع حولهما بقيّة المترشّحين وهم يراقبون المشهد في فضول.
لم يكُن المرشّح الذي وافقت قدماه مقاسَ حذاء ما يُسمّى في الجزائر بـ"السلطة الفعلية" سوى عبد المجيد تبّون، الذي تولّى عدّة مناصب عُليا خلال حُكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، آخرها منصب وزيرٍ أوّل لفترةٍ لم تتعدّ ثلاثة أشهر سنة 2017.
في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول، ستُجرى الانتخابات التي سيُعلَن عن فوز تبّون فيها بنسبة ثمانية وخمسين في المائة من إجمالي أصوات الناخبين. وقبل يومٍ واحد من ذلك، ستُصدِر محكمة وهران، غربَي البلاد، حُكماً بسجن الرسّام لمدّة سنةٍ، من بينها ثلاثة أشهر نافذة، بعد إدانته بتهمة "الإساءة إلى رموز الدولة"، على خلفية رسوماته التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تتضمّن رسومات "نيم" (1985)، الذي اعتُقل في مقرّ عمله بمدينة وهران من قِبل رجال أمنٍ بزيٍّ مدني قبل إحالته إلى القضاء، نقداً لاذعاً للسلطة وسياساتها التي رأى قطاعٌ واسع من الجزائريّين أنها تهدف إلى استمرار النظام القائم؛ أحدُها يُظهر رئيس الأركان الراحل مع عبد القادر بن صالح الذي تولّى منصب رئيس الدولة بعد استقالة بوتفليقة في إبريل/ نيسان وهما يحيكان ثوباً لتبّون رُسم عليه حرف "T" على شاكلة أزياء أبطال السينما الأميركية الخارقين، وفي الخلفية عُلّقت صورةٌ لبوتفليقة على الجدار.
في رسمٍ آخر، يَظهر الرجلان مع الوزير الأول السابق نور الدين بدوي وهُم يعزفون على متن سفينة توشِك على الغرق، في إحالة إلى أحد مشاهد فيلم "تيتانيك" لجيمس كاميرون، بينما يَظهر رئيسُ الدولة السابق، في رسمٍ آخر، على هيئة دُمية روسيةٍ (ماتريوشكا)، في إشارةٍ إلى تصريحاته خلال لقائه بالروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر/ تشرين الأوّل؛ حيث قدَّم له بلغةٍ فيها الكثير من الدونية ما يُشبه تقريراً مفصّلاً عن الوضع في الجزائر.
يُضاف اسمُ عبد الحميد أمين إلى قائمةٍ تضمُّ العشرات ممّن يُطلَق عليهم "معتقلو الحراك"؛ ومن بينهم ناشطون سيّاسيون وصحافيّون وشعراء وفنّانون. وبحسب حقوقيّين، فقد جرى توقيف قرابة مئة سجين سياسي منذ حزيران/ يونيو، حُكم على بعضهم بالسجن وأُفرج عن البعض الآخر، بينما لا يزال معظمهم ينتظرون محاكماتهم.
أحدُ هؤلاء هو الشاعر الشاب محمد تاجديت الذي بات يُلقَّب بـ"شاعر الحراك"، وقد برز بقصائده المؤيّدة للحراك الشعبي والمنتقدة للسلطة، والتي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ويقرؤها في الشارع؛ ففي التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول أصدرت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة حُكماً بسجنه ثمانيةَ عشر شهراً نافذة، بتهمة "الإضرار بالمصلحة الوطنية".
 من الوسط الثقافي دائماً، يبرز أيضاً الممثّل والمخرج المسرحي عبد القادر جريو الذي جرى اعتقاله بمدينة وهران في الواحد والعشرين من ديسمبر/ كانون الثاني، ليُطلَق سراحه بعد يومَين، بعد أن جرى الاستماع إليه في محكمة وادي تليلات، على أن تُواصَل متابعته قضائياً بتهمة "التحريض على التجمهُر".
من الوسط الثقافي دائماً، يبرز أيضاً الممثّل والمخرج المسرحي عبد القادر جريو الذي جرى اعتقاله بمدينة وهران في الواحد والعشرين من ديسمبر/ كانون الثاني، ليُطلَق سراحه بعد يومَين، بعد أن جرى الاستماع إليه في محكمة وادي تليلات، على أن تُواصَل متابعته قضائياً بتهمة "التحريض على التجمهُر".
ارتبط اسم جريو، الذي يعمل أيضاً أستاذاً للمسرح، ببرنامجٍ سياسي ساخر بثّته قنواتٌ خاصّة خلال السنوات الماضية، وحقّق انتشاراً واسعاً بسبب جرأته في انتقاد السلطة، ثمّ انخرطَ في الحراك الشعبي منذ بدايته، سواءٌ من خلال مشاركته الميدانية في المظاهرات، أو من خلال ما ينشره على صفحته الشخصية في فيسبوك.
قد تُدلّل هذه الأسماء الثلاثة القادمة، من الرسم والشعر والمسرح، على مدى حضور الوسط الثقافي في الحراك الشعبي الجزائري. لكنها، مِن جهةٍ أُخرى، تُؤشّر على واقع حرية التعبير في "جزائر ما بعد بوتفليقة"، والذي يَشهد خلال الأشهر القليلة الماضية تدهوراً لم يشهده حتى في السنوات العشرين من حُكم بوتفليقة.
والواقع أنَّ الاعتقالات في أوساط النشطاء السياسيّين كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أسهمت في استمرار الحراك السلمي؛ حيثُ رأى كثيرون أنها دليلٌ على عدم جدية السلطة في التغيير، وسعيها إلى فرض الأمر الواقع عبر إجراء انتخاباتٍ "تفتقد إلى الحدّ الأدنى من النزاهة والشفافية".
في هذا السياق، يُمكن اعتبار التاسع عشر من حزيران/ يونيو محطّةً مفصليةً في عمر الحراك؛ ففي هذا التاريخ، حذّر رئيس أركان الجيش الراحل من رفع أيّ علَمٍ آخر غير العلَم الوطني خلال المظاهرات، وتحدّث عن "إصدار أوامر صارمة لقوّات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين سارية المفعول والتصدّي لكل مساس بمشاعر الجزائريين"، وقد فُهم بأنَّ الأمر يتعلّق بالراية الثقافية الأمازيغية التي تُرفع بشكلٍ بارز خلال المسيرات.
وبالفعل، شنّت قوات الأمن، بعد يومين، حملة اعتقالات ضدّ كلّ من يحمل الراية الأمازيغية (التي تختلف عن راية الانفصال)، وهو ما تسبّب في إحداث شرخٍ بين المتظاهرين أنفسهم؛ إذ تمسّك كثيرون بما يعتبرونه حقّاً في رفع رايةٍ تُعبّر عن ثقافة الجزائريّين وهويّتهم، بينما رأى آخرون أنَّ الراية الوحيدة التي ينبغي رفعها هي العَلم الوطني. وكان ذلك مقدّمةً لشرخٍ آخر بين فريقَين؛ يؤيّد أحدهما السلطةَ ويتبنّى خياراتها السياسية والأمنية ويُبرّر تجاوزاتها، ويُصرّ الثاني على استكمال الحراك حتّى يحقّق كلّ مطالبه وأهدافه.
بدا أنَّ المستفيد الأكبر من هذه الحالة هو السلطة نفسها، والتي ظهر أنها نجحت إلى حدٍّ كبير في تحويل الأنظار عن المطالب الحقيقية للجزائريّين إلى قضايا خلافية تتعلّق باللغة والثقافة والهوية والتاريخ، تُساندها في ذلك ترسانةٌ إعلاميةٌ تتحدّث فيها الصحافة الحكومية والخاصة وصفحاتٌ في مواقع التواصل الاجتماعي على لسان رجُلٍ واحد يُحاول تشويه الحراك وتصويره كفعلٍ مخترَق ومُسيَّر من قِبل "أطراف خارجية"، ولا يمثّل غير لونٍ واحدٍ من الجزائريّين. وكان لافتاً انخراطُ وجوهٍ محسوبةٍ على الأوساط الثقافية والسياسية والأكاديمية في حملةٍ ممنهجةٍ ضدّ منطقة القبائل التي تُعدّ المعقل التاريخي للمعارضة في الجزائر (لم تصل فيها نسبة المشاركة في الرئاسيات الماضية إلى واحدٍ في المائة).
بالموازاة مع اعتقالات المعارضين وما يرافقها من تجييش إعلامي غير مسبوق، تتواصل - بوتيرة أقلّ - ما تسمّيها السلطة حرباً على أركان الفساد في دائرة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وقد جرّت إلى السجون حتى الآن عشراتٍ من المسؤولين الكبار، من بينهم 12 وزيراً، صدرت بحقّ بعضهم أحكامٌ بالسجن. آخر هؤلاء وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي التي أُودعت "سجنَ الحرّاش" بالجزائر العاصمة في تشرين الثاني/ نوفمبر، في انتظار محاكمتها في قضايا فسادٍ تتعلّق بـ "تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقّة وسوء استغلال الوظيفة" خلال فترة توليّها الوزارة بين 2002 و2014.
غير أنَّ أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الحملة هو استثناؤها بوتفليقة نفسه، والذي كان جميعُ المسؤولين يُؤكّدون أنهم يطبّقون برنامجه؛ وهو ما يجعل المعارضين يعتبرون أنَّ ما يحدث اليوم لا يخرج عن كونه مجرّد عدالة انتقائية، بدليل متابعة وزيرةٍ للثقافة بتهمٍ فسادٍ في وقتٍ ترشّح وزير ثقافة آخر ينتمي إلى المنظومة نفسها؛ هو عز الدين ميهوبي، للانتخابات الرئاسية الماضية، وكان قاب قوسَين أو أدنى مِن أن يُصبح عاشر رئيس في تاريخ الجزائر المستقلّة.