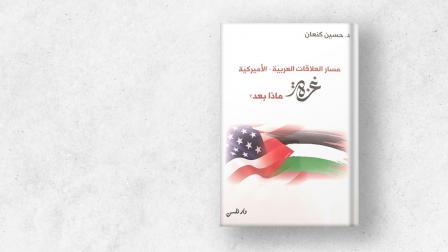لفتت نظري صورة فوتوغرافية معبرة في مقال بالإنكليزية نشره الصديق أحمد منقارة بعنوان "الشباب اللبناني يسترجع الفراغ العام عبر الفن والحوار". الصورة التقطتها السينمائية ماري - روز أسطة لمغنّية السوبرانو اللبنانية منى حلاب في الثاني والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في "المسرح الكبير"، وسط بيروت، والذي صمّمه يوسف أفتيموس، أحد أبرز المعماريّين اللبنانيّين في مطلع القرن العشرين.
هذه الصورة مستلّة من فيلم قصير أنتجته أسطة لمنّى حلاب وهي تؤدّي أغنيةً عفوية عن الثورة اللبنانية في بهو المبنى المهجور والمترَب، ألّفتها مجموعة من المشاركين في التظاهرات، تشع من كلماتها روح لبنانية جديدة عابرة للطوائف. تقول الأغنية:
"لما ساحة النور تهتف، كرمالك يا صور
والنبطية دموعا تذرف، عشوفة ساحة النور
وبيروت متل العادة، تفوّت الزوار على بيتا
لما تشوفوا هالمناظر، ما بتقول يا ريتا؟
حالتنا دايماً هيك، بلا طوائف عالهوية
من اليوم ورايح لازم هاي، تكون هيّ القضية"
ولكن ما شدّ انتباهي حقّاً هو عبارة مبخوخة بالأسود على عتبة خرسانية ضخمة تقول "بدنا (نريد) خبز وعلم ومسرح". أثار هذا الشعار المكتوب على عجلٍ في نفسي خواطر عن دلالاته في هذه اللحظة المفصلية في التاريخ العربي المعاصر؛ فقد أوحت لي العبارة بانبثاق صوت جماعي غير مسبوق لجيل من الشباب العربي المُحاصَر والمُهمَل الذي هبّ مؤخّراً مراراً ضد حكّامه المتسلّطين والقامعين في بلدان عربية شتّى مطالباً بحقوق حُرم منها لعقود طويلة، اختزلها الشعار في ثلاثة عناصر: الخبز والعلم والمسرح.
طلب الخبز أو الإعالة المادية شعار واضح وصريح، سمعناه بدايةً في شعار ثورة يناير في مصر "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، وهو مفهوم تماماً في ظل اقتصاد راكد ومتعفّن حكم على شرائح ضخمة من شبابه بالبطالة الدائمة والتفتيش اللاهث عن لقمة العيش. وكذلك الحال في طلب العلم أو المعرفة في منطقتنا العربية التي ما زالت تعاني من تدهور نُظُم تعليمها وتخلّفها المدقع عن اللحاق بركب عصر التكنولوجيا المتقدّمة وقواعد المعلومات الهائلة والمتوافرة بكبسة زر.
لكن طلب المسرح، هذه المؤسّسة الغائبة (أو المغيَّبة) عن الواقع الثقافي العربي، أمر قد يبدو غريباً في البداية. ولكن إذا ما تمعّن المرء فيه لوجده يرمز إلى حيّز مدني مهمّ يلخّص بوجوده مكوّناً أساسياً من العيش المشترك لم تعرفه أجيال عديدة من العرب (وغيرهم من شباب الجنوب الفقير) الذين نشأوا في ظل أنظمة الاستبداد الحديث. هذا البعد المفقود هو الفضاء العام أو الفضاء المدني.
لست أقصد هنا غياب الساحات العامّة من المدن العربية. فهذه، على قلّتها وسوء تخطيطها، موجودة إلى حد ما في كل مدينة عربية. ولا أقصد أيضاً المناطق الحضرية المفتوحة في المدينة، مثل الأسواق أو مراكز التسوّق، التي تُعتبر عادةً فضاءات عامّة حيث يتجمع الناس، ولكن غالباً لممارسة نشاط تجاري لا أبعاد جماعية أو مدنية له.
ولكنّي أعني المساحات التي ينخرط فيها الناس بشكل فعلي في نشاط جماعي، مثل التثقّف أو العبادة أو الاحتجاج. ومن ثم ففهمي لطلب المسرح في الكتابة على كتلة "الغراند تياتر" الخرسانية نابعٌ من وظيفة المسرح المهمّة كمساحة نقاش عامّة.
فالمسرح، الذي ابتكره الإغريق حوالي القرن السادس قبل الميلاد، كان في الأصل حلقة من سلسلة كاملة من الأنشطة الثقافية التي شارك فيها جميع المواطنين، والتي تراوحت بين المهرجانات الشعائرية، من عبادات ورياضات واحتفالات طقسية، والتجمّعات السياسية في الآغورا (أو ساحة المدينة الرئيسية والعامّة). كانت هذه الأنشطة تهدف في المقام الأول إلى التأكيد على مشاركة المواطن في الحياة العامة للمدينة بكل أبعادها كجزء من مواطنيته (ولو أن النساء كن مستبعدات عن هذه النشاطات).
ضمن هذا الإطار، شكّل المسرح حيّزاً عامّاً مهمّاً ومساحةً للحوار رئيسيةً يتقاطع فيها التمثيل والترتيل والغناء الكورسي الذي يؤدّيه الممثّلون والمشاهدة والتفاعل الذي يقدّمه المتفرّجون. كان المسرح أيضاً الإطار الذي نشأ ضمنه نوع من التعلّم العاطفي والسياسي من خلال المسرحيات التي ألّفها كبار المؤلّفين المسرحيّين الإغريق من أمثال أخيلوس وسوفوكليس وأوريبيدوس، ومن خلال تشكيل فضاء المسرح والإعداد الفني والديكور. ولكن الوظيفة الضمنية للمسرح كانت في المقام الأول تسهيل التفاعل بين الممثّلين والجمهور، الذي كان من المتوقّع أن يشارك في التعبير بحرية.
هذا التفسير غير التقليدي للمسرح، على تاريخانيته الواضحة بعض الشيء، يسمح لي بقراءة مطالب الشعار البيروتي بشكل أقل تخصّصاً وأكثر انفتاحاً و"ثورية"؛ ففي عصر الاحتجاجات واسعة النطاق التي أشعلها الشباب المحرومون والقلقون على مستقبلهم الذي سيطرت عليه طبقات سياسية ومالية فاشلة وفاسدة حكمتهم مع ذلك لعقود، يوفّر المسرح مساحة عامّة مثالية وفاعلة وآمنة بعض الشيء للمشاركة والتعلّم والتعبير والحوار الثقافي.
من هذا المنظور المنفتح للمسرح كفراغ عام، يمكن للعديد من المساحات العامة والمفتوحة الموجودة أصلاً في المدينة أن تحقّق هذه الأهداف التثقيفية والاجتماعية بإضافة جرعة صحية من الحرية لوظائفها مع حد أدنى من التدخّل المعماري في تصميم وتأهيل فراغاتها.
من الواضح مثلاً أن الساحات العامة يمكن أن تُوظَّف في كثير من الأحيان كمسرح مؤقّت، حيث تشغل زواياها بالخطباء والموسيقيّين وجميع أنواع الفنّانين الذين يتفاعلون مع المارّة بالحركة والكلمة والصورة. يمكن أيضاً أن تصبح المقاهي والبارات والمطاعم مسارح مؤقّتة. وكثير منها في الواقع تتبنّى هذه الوظيفة في بعض الأوقات، وأحياناً بشكل منتظم. وبالطبع يمكن للمسارح الفعلية، المصمّمة أساساً كمسارح، أن تتخطّى دور الترفيه فقط، الذي وجد العديد منها نفسه فيه، من دون التخلّي عنه كأداة لجاذبيتها، وأن تقتبس بعضاً من روح الحرية التي يطالب بها شباب المتظاهرين، كما فعل بعضها في عهود الأمل الفائتة.
يمكن في هذا المجال إعادة بناء "المسرح الكبير" في بيروت لتلبية هذا الغرض بأن يكون جامعاً ومكاناً للقاء والحوار بين المواطنين، لا أن تُمحى هويته كما يُشاع من أن مالكته، شركة "سوليدير" العقارية، تنوي تحويله إلى رمز نيوليبرالي للعمران الذي حملت هي نفسها رايته في بيروت بعد الحرب الأهلية بأن ترممه كـ "بوتيك آوتيل"، أي فندق مخصص.
المطلوب لاستعادة الصفة المدنية في هذه الأماكن العامّة هو إعادة التأكيد على الالتزام القوي بمفهوم المواطن كفاعل حر وموثوق به في المجال الجماعي.
* مؤرّخ معماري سوري وأستاذ كرسي الآغا خان للعمارة الإسلامية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا