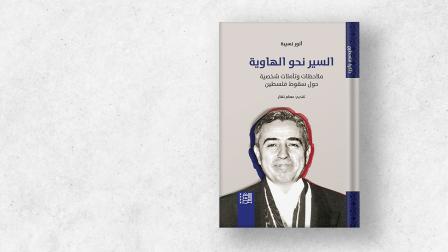استمع إلى الملخص
- **التأثير السلبي على المناخ الإبداعي**: الجدل يؤدي إلى ضغوط سياسية واجتماعية تحد من حرية التعبير وتسبب خسائر جانبية مثل الاعتداءات الجسدية أو الحبس.
- **أمثلة من الأدب العربي**: رواية "هُوارية" للكاتبة إنعام بيّوض أثارت جدلاً كبيراً بسبب تناولها مواضيع حساسة، مما يعكس الصراع بين الحرية الإبداعية والقيود الاجتماعية والسياسية.
لو حسبنا كم استخدَمت الصحافة عبارات إثارة اللغط، والضجة، والجدل، والغضب لدى إشهار عملية إبداعية عربية من كتابة، وسينما، ومسرح، وفنون تشكيلية، وأغانٍ، لصار عندنا كومة ذهب محتملة وكومة غبار. الذهب ليس مضموناً. قد يتحقق عياناً أمام صاحب الشأن المستهدف (بفتح الدال وكسرها) كل هذه الإثارات، وقد يكون خُلبياً، كما تعد البروق الكاذبة بالمطر.
المضمون في كل الأحوال هو الغبار، سواء أكان تثويره بقصد أو بربع قصد من صاحب العمل. هناك كتّاب وفنانون يشتغلون في جنوب المتوسط وعيونهم على الشمال، فلماذا لا يتغبرون ويتعفرون استناداً إلى "لعل"، هذا الحرف المشبه بالفعل الذي يسحبنا من رموشنا مترجّين وآملين؟ وهناك غبار خارجي قد يكون كيدياً من أصحاب الكار نفسه، أو بفعل تزاحم الغوغاء الذين يحسبون كم سيضيع عليهم من "لايكات" إذا ما غابوا يوماً أو يومين وهم يقرأون صفحات كثيرة.
ولقد كان الزمن السابق متأملاً أكثر، والجدل مؤطراً بين السلطات المعرفية والسياسية والمنتديات والصالونات، وكان على الجمهور أن يقطع الشوارع، ليشتري الكتاب أو يعاين فيزيائياً العمل الفني.
غبار الأسبوع
اليوم، فإن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الملايين يشاركون بضرارة في إثارة الغبار الذي سيلوث الجو وسيهدأ بعد أسبوع. فالغبار له أوقات عمل رسمي ينتهي مع عطلة الأسبوع في الغالب الأعم من هذه الحوادث.
بعض الاستثناءات قد تحمل أكلافاً مؤسفة، من اعتداء جسدي أو حبس، أما المنع فهو المجال الجديد الذي يوفر قرصنة مريحة لبعض من أثاروا الغبار كي يحصلوا على المادة الإبداعية. والكثيرون منهم قد لا يعنيهم الأمر، لأن طبيعة وسائل التواصل مثل السوق الفورية تبيع أي غبار لأي عابر السبيل. كثيراً ما سمعنا عبارة "مع أنني لم أقرأ هذه الرواية ولكن.."، هذا تل غباري يعتدي على التهريج، التهريج الذي نحترمه لأنه ظريف ويسعد الناس.
الخسارة تتمثل في مناخ عام تتآكل فيه القدرة على الكتابة
الآن، من منا يتذكر رواية "هُوارية" للكاتبة الجزائرية إنعام بيّوض؟ يتذكرها فقط من قرأها ومن أحصى الخسائر متأسفاً على وقوع إصابات جانبية بسبب كثافة الغبار الذي ثار تحت أرجل جموع هائلة لم ولن تقرأ. انتهى مهرجان اللغط الذي بنته الجموع الافتراضية على خدش الحياء الخاص بمدينة وهران، والتعبيرات الجنسية والسوقية التي وقعت في هذه المدينة بالاسم حياً لحي وشارعاً لشارع.
خلاقة المقدس والمدنس
ولكل منا أن يتخيل أي مدينة عربية يمكن أن تضم هذه الفئات المشوّهة أرواحها والجميلة جمال الشياطين والبشر والضحايا والحالمين المكسورين والمستغلين الشبقين. ثمّة امرأة تمتهن الدعارة في مدينة ما، يزورها زبائن ما في زمن ما. هذه وصفة آمنة حين تقرأها بالعربية الفصحى، أو غير مستعدية لقبيلة بعينها.
إياك أن تستعمل لهجة محلية. بينما تفعل ذلك تستمع في الجوار إلى أغنية من طراز "الواي واي" تمجد نوعاً من المخدرات، إذا رقنتها بأصابعك تحولت إلى كلمة، والكلمة هي خلاقة المقدس والمدنس وهي التي تبتّ في المصائر وتوقّع عليها. لقد وضعنا الغبار أمام سؤال عن المدينة، أي مدينة إذ يتوافر فيها قاع، ويمكن أن تدور فيها الحكايات.
في رواية "حيث لا تسقط الأمطار" للشاعر الأردني أمجد ناصر (1955 - 2019)، لا توجد أمكنة مسماة باسمها، بل استعارات مثل المدينة الرمادية ومدينة السندباد. فكرتُ وأنا أقرأها ما الداعي لهذه الاستعارات؟ والجواب في نهاية الأمر: هذا خيار الكاتب وهو حر. وليس دائماً احتراس الكاتب رقابياً، بل ربما لعبة فنية حتى تخرج الرواية من شبهة السيرة الذاتية. لذا فالعهدة على الكاتب والقراءة للقارئ.
لو سحبنا شخوص وهران إلى المدينة الرمادية لن يكون هناك أي ضير يسببه الاسم. حتى لو جرى التخمين فهو بلا أي تبعة قانونية أو عرفية، إلا للمتمحكين مضمري النيات.
يشبه إخفاء اسم المكان وتعمية لغته ما عشناه في ثقافتنا المدرسية، خصوصاً في المرحلة الإعدادية التي تبشر بأوائل البلوغ. فاسم الأم كان من ضمن مستلزمات الشرف الوجودي. إذا فاجأ ولد آخر بقوله: عرفت اسم أمك فهو كمن وضع قنفذاً على جلده الحساس.
الخسارة
والحال أن الخسارة العميقة تتمثل في المناخ العام الذي تتآكل فيه القدرة على الكتابة، تحت أنظمة تضبط معايير التعبير بوصفها السلطة السياسية المحتكرة للقوة، أو تترك مساحات للعنف التعبيري دفاعاً عن الشرف المجتمعي، وهو رمز أنثوي يتلبس المدينة ذات الطبقات المتصارعة. تتحول المدينة إلى حياض يذاد عنها بالسيف، وفي الجملة هي صفقة موغلة في العمق التاريخي ومتعاضدة بين السلطة والعرف.
فإذا صحت نسبة عبارة "كل الحرية المتاحة في العالم العربي لا تكفي كاتباً واحداً" إلى القاص والروائي المصري يوسف إدريس (1927 - 1991)، فإن الأعمال التي تثير اللغط وما شاكل تصبح في أحد وجوهها وسيلة هجومية مغامِرة لإثبات الذات الروائية. ولكنها قد لا تكون هجوماً على آخرين، بل على ذاتها التي تتستر وتنكشف.
منذ التسعينيات وضمن ما درسه أستاذ الأدب المقارن المصري صبري حافظ بعنوان "جماليات الأفق المسدود"، باتت "ثمة حاجة إلى نزعة جديدة هي نزعة الرفض التمردية التي يؤكد عبرها الخاص رفضه للعام، أو يعلن عبرها على الأقل عدم إذعانه له، ورفضه للوقوع تحت سلطانه".
يعود بنا الناقد إلى المرحلة التي اندلعت فيها الكتابة الروائية محدقة في الذات الفردية بعد يأسها المطلق أمام الأفق المسدود. هذه كانت المرحلة التي تتساوق مع ما يعرف في الجزائر بالعشرية الدامية.
رواية "هوارية" عنيفة، لأن الكاتبة اختارت مرحلة تسبق العشرية وتتبعها لتظل البؤرة هي عقد التسعينيات، دون أن يكون فيها تتابع روائي زمني من البداية حتى النهاية، بل من خلال بورتريهات تسيل من جوانبها الصور والمشاعر والتحولات. كل واحد إما يتحدث عن نفسه أو يتحدث عن غيره. وفي جميعها الكاتبة واحدة تكتب بالمستوى اللغوي ذاته دون أن تعبأ بضرورة التنوع المفترض في مستويات السرد بين شبه الأمي وقارئ الفلسفة.
كاتب شبح
ولكن بدت اللعبة مقبولة عندي، فقد توزعت الحصص السردية من الناس إلى يد الكاتبة كأنها تمارس وظيفة ما يسمى "الكاتب الشبح"، تكتب بناء على طلب الساردين الذين تظهر أسماؤهم علامات مفتاحية، تعطي الإذن لها أن تخلق كل شيء، الشخص ومكانه وزمانه ومصيره.
كان خيار الكاتبة أن تصادت مع هذه العشرية الحرجة، وإن كانت واضحة في انحيازها إلى رواية السلطة التي تحدد من خرج على الدولة فوصم بالإرهاب، إلا أن روايتها دخلت أحشاء المدينة، ووزعت الأحلام والهزائم على الجميع.
بدت اللغة ملمحاً بارزاً في الرواية. أعني بذلك المعجم الخاص بها، وهو معجم غني لا يعطي بالتأكيد ضمانة روائية ذات سوية عالية، إلا أنه هنا حيوي ونابض، رغم حضور أخطاء إملائية ونحوية صارت ضمن الفلكلور العربي المعتاد، حتى أن واحدنا إذا عثر على كتابة خالية من الأخطاء انتابه الشك والقلق.
وأعني كذلك تقديمها مثالاً للعبارة المتخففة من الشحوم الزائدة، وقدرتها على الوصف الخاص الذي لا تعثر فيه على كليشيهات معادة، وتتكرر بما لا تخطئه العين في الأعمال الروائية الجديدة.
مما درجنا على سماعه إذاعياً وتلفزيونياً "فاصل ونواصل"
بالطبع، إن كل عمل يمكن أن تلاحقه أحكام ما ينبغي ولا ينبغي. وما بين "جماليات الأفق المسدود" وامتعاض الناقد الفلسطيني إبراهيم أبو هشهش من أن الرواية العربية صارت "رواية هموم نفسية واجتماعية أو سياسية في الغالب تعيش في الغرف والمقاهي والشوارع، وتكاد تكون منبتة انبتاتاً تاماً عن محيطها الطبيعي"، يبدو أن هذا المخاض سيتواصل إلى أمد أطول نعوّل فيه على استثناءات قليلة تدرك المأزق ولا تذعن له.
وبصرف النظر عن أسبوع الغبار، فإن الضحية الأولى هي قارئ دار "ميم" للنشر، إذ لم تحتمل الناشرة الكاتبة آسيا علي موسى هذا الضجيج فأقفلتها، وتركت "الجمل بما حمل" بحسب بيانها الأول والأخير. كان هذا أسوأ ما وقع، إذ أخرج الغوغائية من صفتها الفرجوية إلى إثبات الوجود قولاً وفعلاً.
مما درجنا على سماعه إذاعياً وتلفزيونياً "فاصل ونواصل"، يبقى ملف إثارة أو ثوران اللغط والجدل وأمثالهما ملفاً غير ملتفت إليه بشكل جدي يفصل الحنطة الروائية عن الزؤان.
فقصتنا من أولها تقوم بنية حسنة على أن العمل الروائي ليس له إلا أن يكون مختلفاً، ومنتمياً لروحه، وأذكى من يبرز أي انحيازات دعائية، وبانياً لعمارته الواقعية والخيالية من ذاته الفردية والجماعية. وفي هذا كله، وبعد أن تشطب كل ما سبق وتضيف من عندك إلى ما لا نهاية، يبقى أي عمل شهادة على صاحبه إن كان نصه قادراً على المشي بكرامة إبداعية، أم يحتاج إلى تسوّل الزوابع.