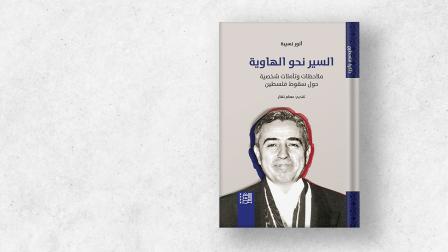لم تكن حياة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي (1944 – 2021)، الراحل قبل أيام في عمّان، سوى قفزٍ في بقع الجغرافية المترامية من رام الله إلى القاهرة، فبودابست وبيروت ولندن وعمّان وغيرها، والتي أفرزتها النكسة ومآلاتها. النكسة التي ضربت أوّل ما ضربت طريق الشاعر إلى جدار البيت الذي ستستحيل خيالات الشهادة الجامعية المبروزة عليه إلى يوتوبيا مستحيلة، لا بعودة مؤقتة على شكل زيارة بتصريح يصدره الاحتلال، بل بعودة تستقرّ ويستقرّ بها في وطنه كما تجري العادة في كل دول العالم.
أفرز جرح الوطن والعودة إليه واغتراب ما بينهما اثنين من أبرز كتب السيرة الذاتية المكتوبة بعد تسعينيات القرن الماضي، والتي حكت جرحاً ذاتياً ظلّ ينزف غربةً إلى لحظة رحيل صاحبهما، أوّلهما "رأيت رام الله" الصادر في العام 1997، والثاني "ولدتُ هنا، ولدت هناك" الصادر في العام 2009. تتشابك سيرة الكتابين مع سيرة الرجل في ملحمة لم تكن لتتأتّى لولا ظرفٍ شائك فرض نفسه فلسطينياً على كامل الوطن، وظرف إنساني ظلّل سيرة الرجل من أوّلها إلى آخرها.
ولعلّ المفارقة الأهم التي افتتحت الكتابين النثريين لصاحب "الطوفان وإعادة التكوين" (1972) هي في مشهدي محاولة الدخول إلى أرض الوطن في الكتاب الأوّل، ومحاولة مغادرته في الكتاب الثاني. وقد كانت محاولة الدخول قد جاءت بعد نفيٍ قسريّ عن أرضه لمدّة زادت عن ثلاثين عاماً، وهو المشهد الذي دفعه لتأمّل بندقية الجندي الواقف على الحدود مع الأرض المحتلّة: "بندقيّته هي تاريخي الشخصيّ. هي تاريخ غربتي. بندقيته هي التي أخذت منا أرض القصيدة وتركت لنا قصيدة الأرض. في قبضته تراب. وفي قبضتنا سراب". لكنّ مفارقة محاولة الخروج من الوطن بعد ذلك ظهرت وكأنّها محاولة للهروب منه تحت وطأة الاجتياح والقصف والحصار: "ها نحن نصل سالمين الى أريحا كما وعد (سائق الحافلة). ما زلت لا أستوعب كيف تمكن من ذلك. ربما هو الحظ أو الهواتف النقالة أو دهاء القرويين والرعاة أو ربما – وهذا هو الأرجح – أنّ القدر لم يسمح بعد للفلسطينيين أن يموتوا بحوادث الطرق".
التزمت أعماله النثرية بالبوح الهادئ وتجنّب الانفعال
تتبادل في هذا الكتاب الأحزان والضحكات الكثير من المواقف والأدوار، يأخذنا الشاعر السارد بالمفارقة المُرّة تارة، وبالالتقاطة النبيهة تارات، عبر رحلة ستكشف عن الهواجس والمخاوف أكثر مما تكشف عن الرؤية المباشرة للأحداث والمواقف والصور. ولعلّ السارد هنا يستعين بالشاعر الذي وظّفته الأقدار من أجل التقاطات كهذه، يواجه فيها القارئ بمرارة الحقيقة وقسوة النكتة في تجلياتها الأعم.
وإذا امتازت قصيدة صاحب "رنّة الإبرة" (1993) باللّغة الباردة بقصديّة تخلّى من خلالها عن التهويمات والهذيان الشعري والصوري، فقد التزمت أعماله النثرية السيَرية بالخطّ نفسه من البوح الهادئ الذي يتجنب الصراخات المنفعلة. إنها لا تتجنّب وحسب، بل تعيد امتصاص المواقف المختزنة عميقاً في الذاكرة بقُدرةٍ تأمّلية قادرة على إعادة قولبة الأحداث بما تسمح لها الذاكرة أن تأخذ أشكالاً إبداعية جديدة. لذلك كانت إعادة إنتاج أكثر المواقف الإنسانية قسوةً وصعوبة كرحيل الأهل والأخ في مواقف وظروف شديدة الصعوبة قادمةً من أماكن تُطوّع نفسها داخل اللغة ولا تسمح لها بأن تعتدي عليها بالانهيار العاطفي والمبالغة التصويرية.
لا يتوقف موقف صاحب "قصائد الرصيف" (1980) من الصراخ والانفعال في اللغة عند الجانب الشخصي منها، بل يتعدّى ذلك إلى الشعاراتية والخطاب في الشعر كله. يقول في إحدى مقابلاته: "إنّ الشعر الذي يستخدم الوطن أو الانتفاضة وهو خال من الموهبة يؤذي المادح والممدوح". ويشير إلى أنّ "الشعر الحقيقي يخدم الوطن بطريقة واحدة، هي أن يكون جميلاً ومقنعاً وصادقاً وقابلاً للقراءة والإمتاع الفني في زمان ومكان آخرين". ويضيف أن الشعراء الفلسطينيين "معنيّون بالمصير الإنساني فردياً أو جماعياً. (نحن) معنيون بأنفسنا وبالهمّ الإنساني عموماً، ولسنا دبّابة في "منظمة التحرير" يُقال لنا ادخلوا المرأب فندخل. لسنا جنوداً برتبة شاعر أو رسّام أو مغنٍّ".
لم تكن، تلك اللغة الطيّعة، السلسة في شكلها، المتطرّفة في استطالاتها، التي صبغت أعمال الشاعر نثراً، سوى نتاجٍ لتلك الصنعة التي لا يبرع بالقبض عليها إلّا من لهم باع طويل في استدخال الحياة في مربعات الحكي والتعبير والتأمل، ولعلّ ذلك أبرز ما ميّز عمليه النثريين، اللذين جاءا بالكثير من الدلالة وبالقليل القليل من الثرثرة.
* كاتب من فلسطين