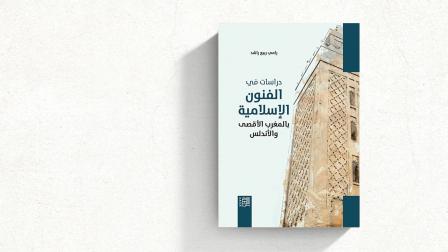عامَ 1995، فكّر فرناندو أدورناتو، مدير تحرير مجلة "ليبرال" الإيطالية، في فتح حوار بين الكاردينال كارلو ماريا مارتيني (1927 - 2012) والكاتب الإيطالي أومبرتو إكو (1932 - 2016) حول الإيمان. نُشر الحوار عام 1996 بالإيطالية وتُرجم إلى لغات عدّة، ووصل إلى العربية أخيراً، حيث صدر عن "منشورات المتوسّط" بعنوان "بماذا يؤمن من لا يؤمن؟" بترجمة أماني فوزي حبشي، وتقديم ومراجعة للمحتوى العلمي لسامح حنا.
الحوار بين مؤمن وغير مؤمن، أو بين متديّن ولا متديّن لو شئنا الدقّة. تلك حواراتٌ مغرية دوماً، ممتعة أحياناً، ونادراً ما تكون مُرضِيةً لأيّ طرف من الأطراف، خصوصاً أنّ تلك الحوارات -بطبيعتها- مرتبطة بمناسبة في الغالب، تنتهي أصداء الحوار بانتهائها. كانت المناسبة آنذاك اقتراب الألفية الثانية من نهايتها، واقتراب العالم من نهايته كما كنّا نظنّ في أغلبيتنا، وقد خابت توقّعاتنا؛ إذ لم تتجمّد الكمبيوترات عند الصفر، ولم يأت النيزك، بل تواصلت حياتنا برتابتها، بانتظار زمن النهاية الذي يبدو أنه يأتي "بالتقسيط" حروباً، وزلازل، وفيضانات. لم تَصْدق النبوءات الدينية، ولا النبوءات العلمية، وبقيت حوارات كهذه شاهداً على زمن غريب، وإنْ كان القصد منها أن تكون متحرّرة من مناسبتها.
لعلّ بعض قرّاء العربية يتذكّرون سلسلة مماثلة صدرت عن "دار الفكر" بين نهاية الألفية الثانية ومشارف الألفية الثالثة، وإن كانت موضوعاتها أشمل، إذ تناولت الدين والعلمانية والعولمة والنقد والفلسفة. كان يُراد من تلك الحوارات تنشيط المشهد الثقافي العربي الذي استقرّ آنذاك في متاريس اليقين؛ كان لكلّ مثقَّف رأيُه الذي لا يتزحزح، وكان لا بدّ من محاولة حوار تفتح أبواباً لكسر تلك المتاريس. خفتت أصداء تلك السلسلة بمرور السنوات، ولعلّ مصير كتاب مارتيني وإكو يلاقي المصير ذاته بعد عدّة سنوات، ولكن إحدى غايات القراءة والنقد نبْشُ ما غاب عن الذاكرة لإعادة طرح الأسئلة، ولإعادة تعريف البدهيات، أو ما نظنّها بدهيات. "خدعة البداهة" على حدّ قول سامح حنا في تقديمه للترجمة العربية، في ثقافة كثقافتنا نتّفق معه في كونها "تحرّم الحوار، وتجرّم السؤال".
ما المرجعية الأخلاقية التي تحكم أخلاق غير المؤمنِين؟
لا تبدأ إشكالية الكتاب من موضوعه كما قد يبدو للوهلة الأُولى، بل من عنوانه. يفترض رجال الدين، بمن فيهم "الليبراليون" أنّ الإيمان إيمان ديني حصراً، ولا معنى للإيمان إن لم يكن دينياً، غير أن إكو يقترح "إيماناً" آخر، إيماناً دنيوياً، إيماناً بشرياً. وبذا، فالحوار الحقيقيّ هنا بين متديّن وغير متديّن، بين رؤيتين للحياة: رؤية دينية وأُخرى غير دينية ليست "علمانية" بالضرورة، بل "دنيوية".
ولكن الطرفين لا يُحقّقان طرفَي المعادلة المرجوَّين، فمنطلقات مارتيني هنا ليست متحجّرة، إذ تتّسع لقبول الآخر، ومنطلقات إكو ليست دنيوية بالمطلق، إذ تشوبها أفكار دينية تسلّلت من سنوات تكوينه الأُولى، وبذا يجد القارئ أنّ الإشكالية مركّبة في كثير من مواضع الكتاب، وأنّ نقاط التلاقي أكثر من نقاط الاختلاف. ربما كان الأمر سيختلف باختلاف المتحاورَيْن، غير أنّ السؤال الحقيقي المضمَر في ثنايا الكتاب: هل من إمكانية حوار بين متناقضَيْن، أم أنّ الحوار يشترط نقاط تلاقٍ قبل الشروع في الحوار أصلاً؟
يتّفق المتحاوران منذ البداية في معظم مواضيع الحوار، إذ يؤمن كلاهما بوجوب تكريس "الرجاء" بوصفه الحلّ الأوحد للنجاة في أزمنة النهاية، ويؤمنان كذلك بوجوب قراءة الماضي بهدف فهم المستقبل، والعمل في الحاضر تمهيداً لما سيحدث غداً. النهاية هي هي من حيث الجوهر بالنسبة إلى كلٍّ منهما، غير أن الاختلاف في التفاصيل الأبوكالبسية (القيامية)، وفي تفسيرات تلك القيامة، بل حتى في ماهية تلك القيامة؛ إذ ينطلق مارتيني من التفسيرات الإنجيلية بطبيعة الحال، بينما يسلّط إكو الضوء على "العلامات" الدنيوية لتلك القيامة، من نفايات نووية وكوارث بيئية تُسرّع نهاية هذه الدنيا.
النهاية قادمةٌ لا محالة، والاختلاف في تأويل العلامات؛ الطرفان متوافقان تبعاً لسياق التسعينيات، بيد أنّ الزمن قد تغيّر وتغيّرت التأويلات أيضاً، إذ نتذكّر هنا موقفاً آخر أدق بخصوص "أزمنة النهاية" يمثّله سلافوي جيجك، يتلخّص في أنّنا نعيش الآن زمن النهاية بمعنىً من المعاني، فنحن أشبه بالقطّ في أفلام الكرتون: "نمشي على الهاوية أصلاً، وقد فقدنا الأرض تحت أقدامنا، ولكن -بخلاف حالة القط- فإنّ الطريقة الوحيدة كيلا نسقط إلى حتفنا هي أن ننظر إلى الهاوية تحتنا وأن نتصرّف تبعاً لهذا"؛ أي إنّ تمييز التسعينيات حيث كان حوار إكو ومارتيني بين الحاضر والمستقبل ما عاد له معنىً الآن، لأنّ الزمنين اندمجا الآن في سنوات الألفية وبات مستقبلنا هو الحاضر، بمعنى أنّ "الرجاء" الذي يُعوِّل عليه المتحاوران لم يعد ذا فائدة الآن؛ إذ فات أوانه.
لا تتغيّر السمة الفلسفية للنقاش حتى حين يصل الحوار إلى موضوع جوهري يرتبط بالإجهاض؛ إذ يبقى الطرفان في دائرة النقاشات والتفسيرات اللاهوتية لمعنى "الحياة البشرية"، من دون الخوض صراحةً في موضوع الإجهاض، وإن كان مارتيني أوضح من ناحية أنّ الكنيسة تنظر إلى هذا الموضوع بوصفه حالات فردية، بينما يبقى موقف إكو ضبابياً. هنا أيضاً نستشعر وطأة تقادُم الحوار ووجوب إعادة طرحه بين طرفَين آخرين في زمننا هذا، خصوصاً أنّ "حقّ الحياة" والإجهاض عادا إلى واجهة الأحداث، وعادت معهما أهمّية تحديد ماهية القوانين التشريعية، أهي دينية أم دنيوية، وما مدى دنيوية تلك القوانين حقّاً في ظلّ "صعود اليمين" في بقاع العالم كافّة تقريباً؟ وإن كان لنا تسجيل نقاط في هذا السجال، سنرى أنّ مارتيني (والطرف الديني) حقّق فوزاً بالنقاط في مسألة دخول النساء في المؤسّسة الدينية، إذ وقع إكو في الفخ الذي استشرى اليوم إلى درجة بالغة: أحقّية غير المتديّنين في فرض وجهة نظرهم حيال المؤسّسة الدينية وقوانينها الداخلية.
ليست المؤسَّسات الدينية مؤسَّسات عامة، بل هي فضاء خاصّ محكوم بقوانين تخصّ أفراد تلك المؤسَّسات حصراً، ولذا لا معنى، ولا حقّ، لغير المنتمين إليها بفرض وجهات نظرهم في أيّ تفصيل من تفاصيل بنيتها، إلّا حين تتدخّل تلك المؤسّسات في الفضاء العام. وهنا، نجد أن دعاة العلمنة يخلطون بين وجوب إزاحة المؤسَّسة الدينية عن التشريعات الناظمة لأمور المواطنين، وبين تدخّلاتهم في التشريعات الداخلية لتلك المؤسَّسات. حقُّ غير المتديّن في رفض تدخُّل المؤسَّسات الدينية في الفضاء العام، وفي وجوب ترك التديّن فضاءً خاصاً، يفترض بالضرورة عدم أحقّية فرض وجهات نظره "العلمانية" في تسيير شؤون المؤسَّسات الدينية، إن التزمت بكونها مؤسَّسات فضاء خاص.
يصل النقاش إلى المسألة الجوهرية الشائكة التي يقوم عليها الكتاب كلّه: بماذا يؤمن من لا يؤمن؟ ما المرجعية الأخلاقية التي تحكم أخلاق غير المؤمنين؟ يبدو مارتيني هنا في أقصى لحظات قوّة نقاشه؛ إذ يستند إلى مرجعية أخلاقية/ دينية راسخة لا نقاش فيها لدى عموم المؤمنين: المرجعية الأخلاقية هي الله، ومن ثمّ المؤسَّسة الدينية التي تنقل تعاليم الله إلى المؤمنين. ولكن ماذا عن غير المؤمن؟ وهل الأخلاق مرتبطة بالتديّن بالضرورة؟ يحاول إكو جاهداً إيجاد أرضية منطقية لتكريس "أخلاقيات دنيوية"، ولكنّنا نلمح بعض التخبّط في إجابته بسبب نشأة إكو الدينية، بصرف النظر عن تحوّلاته اللاحقة، إلى الحدّ الذي يُرغمنا على طرح السؤال الشائك على أنفسنا: أيمكن إزاحة المنظومة الأخلاقية الدينية؟ أو، بمعنى آخر، هل ثمّة إمكانية لتكريس منظومة أخلاقية دنيوية بمعزل عن الحمولات الدينية، مباشِرة كانت أم غير مباشِرة؟
نستشعر تقادُم الحوار وضرورة إعادته بين طرفَين في زمننا
تقوم حجّة إكو على نقطة أقرب إلى مفهوم "الأخوّة"، إذ تنبع الأخلاقيات وتتّضح تبعاً لعلاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الأنا بالآخر، ولكن تلك العلاقة ضبابية المعالم، إذ تتلاقى في مواضع كثيرة مع المنظومة الدينية ذاتها التي لا تبتعد كثيراً من دائرة الأخوّة أو السماحة أو العطف؛ لا تبتعد عن مفهوم "الخير" الذي يبدو في هذا الكتاب أقرب إلى المفهوم الديني منه إلى الدنيوي، أو لعلّه ديني بالمطلق، إن أخذنا المعنى "الروحاني" للدين بمعزل عن الإقصائية التي تكون عنصراً جوهرياً في الدين، أي دين، في ذاته.
لا يصل إكو إلى إجابة مُقْنعة، على عكس مارتيني. ومن هنا تنبع أهمية وجوب استمرارية نوع السجالات والحوارات هذا، بل تعميقه أكثر باختيار طرفَين واضحين أكثر، إذ سيجد القارئ في نهاية المطاف أنّ الحوار يدور في دائرة ضيّقة قريبة ممّا نسمّيه "الوسط"، فالطرفان، المتديّن وغير المتديّن، "ليبراليان منفتحان"، ولذا بدا الحوار في أجزاء عديدة تنويعات على المفهوم ذاته، أو مداخل مختلفة للجوهر ذاته. لعلّ السجال يكون أقوى لو كان الطرفان أشدّ اختلافاً، ولكن -في الوقت ذاته- هل ثمّة إمكانية حوار بين طرفين مختلفين بالمطلق؟
* كاتب ومترجم من سورية