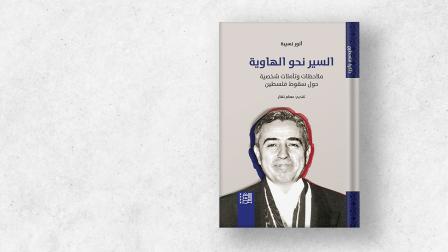منذ 2004، العام الذي أصدرت فيه الكاتبة والمعمارية الفلسطينية سعاد العامري أُولى أعمالها "شارون وحماتي"، وهي "مهووسة"، كما تصف، بالقضية الشخصية، وبالتاريخ غير الرسمي الذي يتشكل من قصص الناس.
تقول العامري، في منتدى "حديث الألِف" الشهري في "مكتبة ألِف"، التابعة لمؤسّسة "فضاءات" الذي استضافها مساء الأربعاء الماضي: "نحن نخجل من أن نحكي قصتنا". وعملها السيري الأول، الذي تُرجم إلى عشرين لغة، كان المدماك الأساس لهذه المرافعة التي تُفسح المجال لمن لا صوت لهم، أو للذين أصواتُهم خافتة، أن يحكوا عن ذواتهم الصغيرة وحياتهم المهددة وخساراتهم وأحلامهم.
كأنما في الكناية التي تنتمي إليها تدافع الكاتبة عن الحصاة وهي تسند زير الماء. ففي السردية الكبرى تفاصيل وبطاقات هوية، وأوراق شخصية، وذكريات ألبوم العائلة.
وهو ما قالت إنه يقع الآن بغزّة التي لا يمكن وصفها بأنّها تشهد حرباً بين جيشين، إنما هو احتلال يقصف المدنيين. فإذا كانت الجيوش ذات تاريخ رسمي، فإن الكتابة عن وجود الناس تحت هذه الحرب لا تقل بسالة، وبالأخص لأنها تدور في ظلال الطرف الأعزل.
فضاء شامي
واحدة من اللمعات التي ستفضي إلى رواية "غولدا نامت هنا" هي الطاولة وقد نجت مما سرقه المستعمر الصهيوني عام النكبة 1948، وعاشت مع العائلة في عمّان حيث عاشت العامري، سليلة الأب اليافاوي والأم الدمشقية في فضائها الشامي المحيط بفلسطين المحتلة منذ أبصرت النور في دمشق عام 1951، ومنها جابت بلاداً كثيرة لتحصيل علمها في مجال العمارة.
هذه الطاولة مضروبة بالرصاص، ولدى الجلوس إليها ومن حول خشبها القديم الصامت، لمعت فكرة الرواية الصادرة عام 2014، مستندة إلى أن أهل الكاتبة لم يشركوها ذاكرة خروجهم من مدينتهم يافا في النكبة، لأنهم "خجولون من الصدمة ويريدون في وعيهم ولاوعيهم أن يعيش أولادهم عيشة طبيعية".
ولأن الفلسطيني ليس لديه فترة نقاهة من كارثة إلى أُخرى، كان امتحان الكتابة من خلال تحويل الحكي إلى نص كتابي، مهمة نشأت مصادفةً إبان الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى (2000 - 2005).
هؤلاء مناضلون لم يقع تأطيرهم في التاريخ الرسمي، ليس لأنهم خاملو الشأن، بل لأن تراثاً من قدسية القضية يجعل الجزء قابلاً للتضحية بشأنه الجزئي لفائدة الكل ذي العناوين الكبيرة.
لا مفاضلات
والعامري، على كل حال، لا تقيم مفاضلات بين أشكال النضال ولا روايات جديدة مقابل أُخرى قديمة. قد تساعدنا على سبيل المثال لوحة على جدار، للفنان الرائد إسماعيل شمّوط وهي تحمل الجماعة الفلسطينية إلى شتاتها، وتحتها كرسي صدئ للفنانة منى حاطوم. كلاهما من فلسطين ويختار زاوية النظر إلى جبل بعيد أو جانباً منسياً على الشرفة.
هوسٌ بالتاريخ غير الرسمي الذي يتشكل من قصص الناس
تميل سعاد العامري إلى النوع الثاني، وتقول رداً على سؤال للكاتبة سمر يزبك، مديرة المنتدى، إن معنى النضال اليومي قد يُغفِل صورة للفلسطيني هامشية وهي ليست كذلك، كأن يفكر في القدوم من الخليل إلى رام الله ويعبر مجموعة الحواجز المذلّة.
وعليه، تطرح السؤال: ما الاحتلال سوى أنه يمنعنا من حياة يومية طبيعية، ويجهد في الآن ذاته بأن يخلق احتلالاً في رأس الفرد الذي مع الأيام سيوطّن نفسه بأن لا داعيَ للذهاب إلى رام الله، حيث استقرت في دماغه أربعة حواجز. أصبحت الحواجز تحتل مواقعها في الدماغ، فيصبح زاهداً في الحركة الحرّة وأسيراً غير معلن للفضاء الذي ترسمه البنادق ونقاط التفتيش.
بدءاً من "شارون وحماتي"، أصبحت المهندسة المعمارية مصادفةً كاتبة. وهي تقول "مصادفةً" لأنها بالفعل كتبت إبان الانتفاضة يوميات أرسلتها في إيميلات إلى أصدقاء تتحدث بلغتها الفكاهية عن احتلالي شارون (أرييل شارون رئيس وزراء الاحتلال وقتذاك) و "احتلال" داخل المنزل حيث حماتها وقد كانت في الثانية والتسعين من عمرها، ومن بين الأصدقاء إيطالية هي من تولّت إرسال اليوميات إلى ناشر.
هواجس أُولى
وفي أولى التجارب التي تخرج للعلن تبرز معها هواجسها، فقد قالت إن خشيتها الأشد كانت من المتلقّي الفلسطيني الذي يعرف غالبية ما يدور النص حوله، فهُم الجيران والأهل وزملاء العمل.
وهذا النوع من الهواجس غير منطقي، ولكن لا مفرّ من وقوعه، لأن الكتابة حين تنهل من يوميات الشارع والمنزل لا تكتفي بأن تكون لسان حال، بما هو محل تقدير صحافي أو توثيقي. إنه هنا يعيد صوغ المألوف ويفرك بالليمون قطعة النحاس التي علاها الصدأ، كأنه يكتبها بصدئها ولمعتها الجديدة.
للكاتبة خمسة أعمال سردية هي على التوالي: "شارون وحماتي" (2004)، و"مراد مراد" (2011)، و"غولدا نامت هنا" (2014)، و"دمشقي" (2019)، و"بدلة إنكليزية وبقرة يهودية" (2022). كتبت جميعها باللغة الإنكليزية، بينما كُتبها المعمارية كانت بالعربية، ومنها "البلاط التقليدي في فلسطين"، و"عمارة قرى الكراسي"، و"زلزال في بيسان".
سيكون العام 1991 في رام الله موعد تأسيس مركز "رواق" للحفاظ على التراث المعماري الشعبي الفلسطيني، بعد سنوات طويلة من الدراسة والخبرات التي تلت انخراطها في الدراسة بـ"الجامعة الأميركية" في بيروت، وجامعة ميشيغان، وجامعة أدنبرة في إسكتلندا.
العمارة والرواية
وبين حقلَي العمارة والرواية، لا بد أن تظهر التشابكات والخلفيات التي تقف وراء تشييد العمران والسرد. إلا أنه بوضوح فاعل تستثمر المعمارية انشغالها بالمدن الفلسطينية والبيوت.
ولنا أن نتعرف إلى البيوت المقدسية فائقة الجمال التي طُرد سكانها إلى شتات بعيد وشتات أشد قهراً نحو القدس القديمة، حيث المسافة بين أصحاب البيوت ومحتليها الغرباء تُرى بالعين المجردّة.
وستقودنا الرواية إلى مسار واحدة من نساء القدس، وهي هدى الإمام التي تزور بيت عائلتها أيام سبت متفرقة وتتعرض للسجن يوماً ثم يُخلى سبيلها، وتعاود الزيارة وإزعاج اللصوص المتحضرين.
كما تحدثت عن غابي برامكي (1929 - 2012) وقد كان رئيس "جامعة بير زيت" حين سيدخل روايتها بوصفه الفلسطيني صاحب البيت الذي سيتحول إلى "متحف للتعايش"، ولدى تدشين المتحف يطلبون منه تذكرة. هذه التذكرة هي التي ستؤدي إلى متحف كان ذات زمن يضم هنا صالون الضيوف وهناك غرفة نومه.
ليس لدى الفلسطيني فترة نقاهة من كارثة إلى أُخرى
المعمارية الكاتبة توصلنا إلى رواية "دمشقي" وكتبتها عن دمشق وقد حفظت تفاصيلها بوصفها "المكان الآمن" الذي تتذكره في طفولتها، في بيت جدها لجهة الأم الدمشقية، البيت التقليدي والمشير إلى الحال الميسورة، ثم انطلاقاً منه إلى الفضاء العام للمدينة المليئة بالخيرات كما رأتها، قبل أن تنقلب الحال بعد 2011، ويصبح السوري لاجئاً، بهوية مختزلة ظالمة أرادت من روايتها أن تواجهها وتكتب عن مدينتها التي تعرف.
أُمّ الغريب
أمّا الرواية التي قالت إنها بذلت فيها الجهد الأكبر فهي الأخيرة "بدلة إنكليزية وبقرة يهودية"، لأنها لم تعتمد فيها على قصص متفرّقة، بل أنشأت حجماً روائياً أدارت فيه الشخوص والمصائر في مدينتها الأم يافا، وقد وجدت صعوبة في الكتابة عنها على غير ما كتبَته عن دمشق، لأنها في يافا شعرت بالغربة: العبرية مسيطرة، والعرب أقلية.
إلا أن قصة الحب محور الرواية بين عامي 1947 و1951، تفتح بر المدينة وساحلها على المدينة الأكثر غنى وقد كانت تسمى "أُم الغريب"، وهي بالتالي لا تنتج عائلات أرستقراطية كالمدن المغلقة مثل الخليل ونابلس، بل جمعت خليطاً من البشر من فلسطين وجوارها العربي والمتوسطي ومن الأجانب، كما شهدت المدينة موجة ترييف بعد لجوء غالبية السكان المدنيين إلى الشتات.
وهي في ذلك المدينة التي تحملها الرواية نموذجاً للمكان الفلسطيني العامر ببرتقاله وصناعته وسكته الحديدية ومسارحه ودور السينما ومكتباتها وصحافتها، قبل أن يسرقها المشروع الصهيوني مدعياً أنه أقام دولته في مكان فارغ.
تواصل سعاد العامري كل مرة القول إنهم "لو سألوني عن الكتاب المفضل لديك أقول إنه الكتاب الذي غيّر حياتي وهو 'مراد مراد.. لا شيء تخسره سوى حياتك'"، وهو الذي تعرّفت به في مصادفة من خلال العامل الفلسطيني، وستخوض معه ومع عمّال آخرين مرتدية زياً رجالياً، مغامرة دخول "إسرائيل" بطريقة "غير قانونية" بحثاً عن لقمة العيش، إبان الانتفاضة الثانية.
وتُصر على أنها ما زالت تتعلّم، من المعايشة بذات القدر الذي تعلّمته من القراءة، وتدرك كل يوم ضرورة تعلُّم الفسيفساء الشعبية وهي تعجن ذاتها وتتشكل، وفي بعض الأحيان في غفلة منّا.