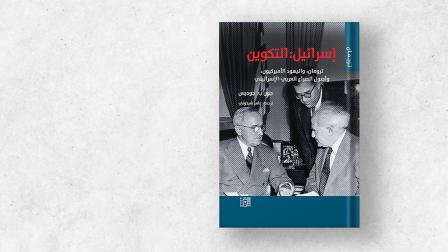إجماعٌ على واجب المقاوَمة الثقافية. هذا ما ذهبت إليه أفكار كتّاب ومثقّفين عرب من مختلف الأجيال والمشارب ممّن استطلعت "العربي الجديد" آراءهم حول ما يُمكن للثقافة العربية أن تُقدّمه وما هي أدواتها لخدمة قضاياها وفي طليعتها قضية تحرير الأرض والإنسان التي تدور رحاها الآن في فلسطين معمّدة بدم أبنائها.
عندما نتحدّث اليوم عن ثقافة عربية، فماذا نعني بذلك؟ هل نقول شيئاً حقيقياً؟ رُبّ سائل: ألم تصبح هذه الثقافة مرتهنة لمؤسّسات وأجندات وسياسات ترسم حركاتها وسكناتها؟ ألم تعد مجرد طقوس احتفائية، يديرها سماسرة ودخلاء؟ ألم تتراجع بشكلٍ فظيع عمّا كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة؟ جيلٌ بأكمله سُرق منها وآخر يُسرق اليوم؟ ألا تكذب هذه الثقافة على نفسها في وضح النهار وهي تعتقد أنّها تمارس فكراً أو نقداً أو تُنجز أعمالاً إبداعية؟ وهل يمكن وصف هذه الثقافة المنفصلة عن قدر مجتمعاتها وعن أسئلتها بالثقافة الحية؟ وحين نتحدّث عن هذه الثقافة، فنحن نتحدّث أيضاً عن مثقفها، الذي لا يمارس الثقافة لأنّه مقتنع بدورها التنويري والنقدي، بل يمارسها بعقلية التاجر أو السمسار.
لا أسئلة حقيقية له، يكتب في كلِّ شيء، ولكنّه لن يجرؤ على الكتابة عن واقعه. يستسهل مهاجمة الموتى ومهاجمة الآلهة، ولكنّه يولي الأدبار أمام مآسي الراهن، ولا يظهر له صوت في وقت الأزمات الكبرى. لا تشعر به متعاطفاً مع شعبه، وهو كثيراً ما يُعلن احتقاره له ولثقافته. معجبٌ أبديٌّ بالغرب، رغم أنّه لم يعرفه، وإن عرفه، فمن خلال شعاراته الكبرى. الحداثة لديه مجرد قشرة خارجية، يتغنّى بها ولكنّه لا يمارسها، وأنّى له ذلك، والحداثة موقفٌ من العالم، من السياسة والمجتمع والدين. وهو لم يتعوّد أن يكون له موقف.
موقف نقديّ واضح وتسخير لكلّ وسيلة كي لا يسود الابتذال
لم تفكر ثقافتنا في الحروب المستمرة والهزائم المتوالية، لم تفكر في الضحايا أو في الحصار الذي قتل أكثر من مليون طفل عراقي. لم تفكر في حصار غزة الأبدي، في القنابل الديمقراطية التي تمزّق الأطفال والنساء، ولم تفكر في الأجيال الهاربة إلى الغرب بحثاً عن الخبز، ولا في الحب ولا في الحياة. لم ترَ ضرورة للتفكير في وضع المرأة داخل المجتمع، ولا في التربية، أو في العنف على الأطفال، لم تفكر في الأشياء الصغيرة ولكن الحقيقية، لأنّها أدمنت الأوهام الكبيرة، ولم تتضامن مع شعوبها العربية في العراق واليمن وليبيا وسورية ولبنان. والقائمة ما زالت مفتوحة.
بل تضامنت مع أنظمة العسكر والممانعة والمحاصصة الطائفية. وحتّى إذا أرادت أن تنتقد، ستجدها تنتقد الأعراض لا الأسباب، تنتقد التقليد، ولكنّها لن تفكّر في علاقته بالنظام الرأسمالي. تهاجم الطائفية ولكنّها تمارسها فكراً وسلوكاً. وباسم حداثتها الزائفة والمزيّفة، ستهاجم الإسلام وتعلّق به كلَّ أسباب تخلّفنا، وسيطرب الغرب لذلك، وتباركه الديكتاتورية.
لا بدَّ لنا أن نعترف بالحقيقة المُرّة التي تقول بأن ثقافتنا العربية الراهنة أو ما نسميه كذلك ليست في مستوى واقع الشعوب العربية وقضاياها المُلحّة، وأن الصخب الموسمي الذي يرتفع هنا وهناك لا يصنع ثقافة مُلتزمة واقعها، فهو إمّا غارقٌ في العاطفية؛ والعواطف رغم نبلها لا تغّير واقعاً بل قد تؤبّده، وإمّا تعبيرٌ عن مصالح طائفية ضيّقة ومقيتة، وإمّا هو لسان حال أنظمة سياسية فاقدة للمشروعية. إنّه تعبير عن فراغ كبير هو هذا الصخب، وعن ضعف وأزمة كبيرين.
ومشكلة هذه الثقافة أنّها غير واعية بذلك، فما دامت تُنتج كتباً وأفلاماً وبرامج تلفزيونية، وتنشر صحفاً وتنظّم جوائز ومعارض أو احتفاليات ثقافية، أو توزّع أوسمة ومناصب، فهي تعتقد أنّها تؤدي دورها، وأنّ دورها لا يتجاوز ذلك. ولكنّنا نادراً ما نقرأ واقعنا من خلال تلك الإنتاجات، بل في غالب الأحيان، لن تكون أكثر من عالة على الحاضر وعقبة أمام فهمه، أو هي جزء من صناعة الوعي المستقيل.
في كتابه: "الثامن عشر من برومير لويس بونابرت" يكتب ماركس أن "الثورة... لا تستقي شعريّتها من الماضي، ولكن من المستقبل". إنّ ذلك شأن كلّ الثورات، وليس السياسيّة منها فقط. غير أنَّ هذا المستقبل لا يمكن أن نفهمه دون مراجعة نقدية للماضي والحاضر. وهذا ما لم تقم به ثقافتنا، أو لم تقم به إلّا بشكلٍ إيديولوجي. إنَّ عليها أن تتحلّى بالتواضع، وفي أقسى لحظات العنف الذي يمارسه الغرب علينا، يجب عليها أن تتعلّم من الحداثة وتواجهها من داخلها، وأن تحذر من أولئك الذي يحدّثونها عن الهوية والأصالة، لكي يخرجوها من الكونية، حذرها من العنف الذي يمارس عليها باسم هذه الكونية.
* باحث وأستاذ فلسفة من المغرب
هذه المادّة جزءٌ من ملفّ تنشره "العربي الجديد" بعنوان: "الثقافة العربية واختبار فلسطين... ما العمل؟".
لقراءة الجزء الرابع من الملفّ: اضغط هنا