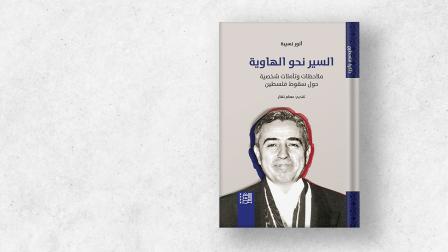تهمس رواية "تفصيل ثانوي" للروائية الفلسطينية عدنية شبلي (1974)، بما حدث لتلك المرأة الفلسطينية حين اعتقلتها سرية من الجيش الإسرائيلي على حدود مصر، بعد أن قتلوا أهلها جميعاً. لا تقترب الروائية من التفاصيل قط، ولا تُرينا ما يحدث في الداخل. كما أننا لا نرى الجنود وهم يغتصبون الفتاة الفلسطينية، بل نسمع الضابط وهو يقول إن بضعة جنود عبثوا مع الفتاة. وحين يأخذها إلى سقيفته حيث ينام، يغتصبها هو أيضاً، ثم يعلم أنَّ الجنود اغتصبوها في النهار التالي، حين كان ينهي أعمال الدورية التي ينفذها يومياً. هنا يفكر أنَّ خياره الوحيد هو إعدام الفتاة. لا يُحاسَب أحدٌ هنا، أخلاقياً، أو قانونياً، أو من أي جهة إنسانية قط، ويُنفّذ الإعدام بدمٍ بارد. هكذا تدفن الفتاة بلا أي تعليق.
تهمس الرواية بهذه الجريمة دون أن تسمي لنا الفتاة. إنّها فلسطينية وهذا يكفي. ولا تسمي أحداً من الجنود الصهاينة أيضاً، إذ لا تهمّ الأسماء هنا. يكفي حضور شخص واحد، حتّى لو كان بلا اسم شخصي، من بين الفلسطينيين الذين تعرضوا للقتل أو الاغتصاب، كي يكون شاهداً أو شهادة على ما حدث. غيابُ الاسم لا يُلغي الهوية، بل يؤكدها، يكفي أن نعرف هويته كي يستطيع تمثيل شعب كامل. وهذا ما تفعله الرواية، إذ تضع الفتاة في صورة الشعب، وتقدّم حكاية في غاية البساطة والوضوح عن الممارسة التي بدأ فيها الإسرائيليون بناء "دولتهم".
استعادة الجغرافية والتاريخ والبحث عن تفاصيل الاغتصاب
تظهرُ المهارة الروائية في القدرة على تقديم الرواية في الفصل الأول بحيادٍ بارد وجاف، إذ لا يوجد صراع، أو عدو منظور أمام الوحدة الإسرائيلية المُكلّفة بتمشيط المنطقة المحدّدة لها. يتجوّل قائد الوحدة الإسرائيلية في المنطقة بأمان، على الرغم من أنّه يبحث، أو يدقّق في احتمال وجود العرب هناك. والغاية من وجود الوحدة العسكرية كلّها هي التخلص من أي عربي في المكان كله، وتأمينه لصالح الدولة التي نشأت حديثاً، فنحن سوف نعرف في ما بعد أننا في عام 1949.
يفكّر القارئ هنا في قوة إرادة الروائية الفائقة في احتمال أن تروي الواقعة، وخاصة موضوع القتل وموضوع الاغتصاب، بمثل هذا المستوى من البرود، لكنّها تراهن على قوة الحدث الذي يمنع القارئ من أن يكون محايداً. علماً أنها لا تستطيع إلا أن تحيد عن برود السرد مرّة واحدة، وتجعل قائد الوحدة العسكرية يُلقي خطاباً تحريضيّاً يشرح فيه المهام بكلامٍ سياسيٍّ مباشر.
أمّا الرحلة التي تسير فيها راوية الرواية، في الفصل الثاني الذي تتتبع فيه الطريق إلى مكان الحكاية، فتبدو مجرد ذريعة كي تعرّف القارئ بفلسطين التي اغتيلت أيضاً. فالجغرافية التي تتنقّل فيها لمعرفة التاريخ الفلسطيني المُغتال، مغتالةٌ بدورها، بعد أن "اغتصبت". إنّها جغرافية ممسوحة أو ملغاة أو مزوّرة ومغطاة بأسماء وحدائق ومنازل وساحات وشوارع لها اسمٌ عبري. ولكن الرواية تستعيد الجغرافية والتاريخ معاً، إنها تقول صراحة هذا الأمر. وتحدّد في كل مسافة تمشيها، بحثاً عن تفاصيل الاغتصاب والاغتيال اللذين تعرض لهما المكان الفلسطيني المُغتصب على الغرار الذي تعرّض له أهله. بحيث يظهر الجنود الإسرائيليون مجرّد حرّاس مؤقتين على التزوير المزدوج للتاريخ الفلسطيني والجغرافية الفلسطينية.
لا يخشى أنصار إسرائيل بنادق الفلسطينيين وحدها، بل يخشون صوت الفلسطيني حتى حين يتكلم همساً عن مأساة شعبه.
* روائي من سورية