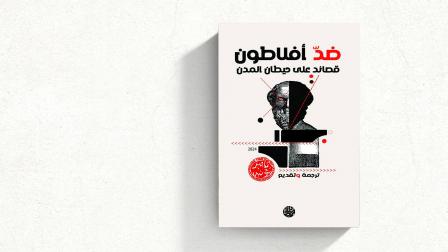استمع إلى الملخص
- غياب المستعربين والمختصين في الدراسات العربية والإسلامية عن المؤتمر أثار تساؤلات حول المنظور التاريخي المعتمد، مما يعكس الجدل حول دور العنصر العربي الإسلامي في الهوية الإسبانية.
- المؤتمر اختتم بتوقيع بيان يؤكد على أهمية التاريخ في التعلم وضرورة توحيد مناهج التاريخ، مع الإشارة إلى الأندلس كجزء مهم لفهم الحاضر وبناء مستقبل يعترف بالتعدد الثقافي.
يمثّل وجود المكوّن العربي الإسلامي في التاريخ الإسباني، لا سيما في فترة العصور الوسطى؛ وهي الحقبة التي تُعرف بالعصر الأندلسي، إشكالاً لا يزال حاضراً في النقاشات الثقافية والتاريخية بإسبانيا. مؤخّراً، برز هذا الأمر بشكل واضح في المؤتمر الذي عقدته الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية، ذات الأصل العربي، مدريد، أكثر من سبعين منظّمة ثقافية وتاريخية، بمبادرة من "معهد الدراسات التاريخية" في "جامعة سان بابلو" الذي يرأسه المؤرّخ ألفونسو بويون، ومنظّمة "Neos" التي يرأسها المؤرّخ ألفونسو بوييون.
تحت شعار "التاريخ كي يجمعنا. التاريخ كي يعلّمنا"، أرادت تلك المنظمات والمؤسّسات، الخاصّة في غالبيّتها، مناقشة الهوية التاريخية لإسبانيا، وبعض القضايا التي لا تزال عالقة في المناقشات السياسية والثقافية والاجتماعية بالبلاد، خصوصاً في ظلّ الانقسام السياسي الحاصل بين تكتل اليمين بتنوّعاته، وصولاً إلى حدّ التطرّف، وتكتّل اليسار، بتنوعاته المتناقضة أيضاً، والذي لا يتوقّف عن التشرذم والانقسام.
وعلى الرغم من شعار المؤتمر، الذي قد يبدو للوهلة الأُولى إيجابياً، فإنّ غياب المستعربين الإسبان، وأساتذة الدراسات العربية والإسلامية، والمختصّين في الدراسات الأندلسية عن جلسات المؤتمر، واقتصاره على أساتذة التاريخ وحدهم، كان مؤشّراً إلى توجّه المؤتمر، والمسائل والقضايا التي يتناولها، ومن أية ناحية ومنظور. ذلك أن هناك اختلافاً جذرياً في النظر إلى السردية التاريخية الإسبانية بين أساتذة التاريخ الإسباني في العصور الوسطى، وبين المختصّين في الدراسات العربية والإسلامية.
في العموم، لطالما احتوت السرديات الوطنية على عنصرٍ إشكاليٍّ دائم، فمسألة الهوية فيها تنطوي عادةً على تشويه لجوانب معيّنة من الماضي. في حالة شبه الجزيرة الإيبيرية، يضيف وجود المكوِّن العربي الإسلامي نوعاً من التعقيد والجدل على هذه النقاشات. وهنا يكمن أحد مفاتيح النقاش الأبدي حول الهوية الوطنية الإسبانية. فبعض المؤرّخين، كما هو الحال في المؤتمر، سألوا: ما وضع الأندلس؟ وهل يمكن حقّاً أن ندمج هذه القطعة "النافرة" في تاريخنا؟
تُشكّل الأندلس ذروة الحضارة في التاريخ الإسباني
من الأفكار التي طُرحت في المؤتمر أنّ الهوية الإسبانية تقوم على ركيزة أساسية تُدعى "حروب الاسترداد". تقوم هذه الفكرة، بشكل جوهري، في مواجهة وجود ما يسمّونه "ضدّ إسبانيا"، في إشارة إلى الأندلس، وهذا جزءٌ من الرواية التقليدية التي سادت السردية الوطنية منذ القرن التاسع عشر، وهي سردية وجدت بيئة حاضنة لها مع انتصار القوى الفاشية وسيطرة الكنيسة، بشكل أو بآخر، على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.
لا تزال هذه السردية حاضرةً إلى الآن، ولها من يؤيّدها ويؤكّدها في كتبه وفي الإعلام والصحافة، وهي جزء من سردية قوى اليمين المتطرّفة وأحزاب مثل "فوكس". ضمن هذه السردية، عانت الفترةُ الأندلسيةُ الطويلةُ النفيَ والقطيعةَ، كأنّها عنصرٌ أجنبيٌّ عن الجوهر التاريخي الإسباني. وبالفعل، بمراجعة سريعة لكتب التاريخ الإسبانية، سنرى أنّ حقبةً امتدّت على مدى ثمانية قرون بالكاد تحضر في صفحة أو صفحتَين، وتحت عنوان "الغزو الإسلامي" لإسبانيا، أو تُلحق بفصل طويل عنوانه "حروب الاسترداد".
هكذا بُنيت الهوية الإسبانية، على أساس تدمير أو إنكار فترة الوجود العربي الإسلامي الطويل فيها. وقد بدا ذلك واضحاً في المؤتمر استناداً إلى عددٍ من الأفكار التي وردت على لسان أستاذ التاريخ رافائيل سانشيز ساوز، والذي سبق أن عبّر عنها في كتابه "الأندلس والصليب"، ويمكن تلخيصها على الشكل الآتي:
- استناداً إلى كتب التاريخ الإسبانية والمناهج المدرسية، فإنّ قوّات الخلافة الأموية، في عام 711، عبرت مضيقَ جبل طارق وبدأت غزواً عسكريّاً لشبه الجزيرة الإيبيرية كان نتيجة الحملة العسكرية التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية مع بداية القرن السابع؛ بهدف نشر الدين الإسلامي.
- غزت القوّات المسلمة شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال) كجزءٍ من حرب مقدَّسة سعت فيها إلى نشر الدين الإسلامي وفرضه على سكّان المنطقة الذين كانوا يعتنقون الدين المسيحي.
- هزمت القوّاتُ الأمويّةُ المملكةَ القوطية، وبسطت سيطرتها على جزء كبير من إسبانيا، مقلّصةً وجود الممالك المسيحية إلى شريط يمتد شمالاً على مساحة ضيّقة في الجبال الأسترية.
- جذع الهوية الإسبانية الذي يُبرّر اندماجها الكامل في الحضارة الأوروبية رومانيّ ومسيحيٌّ. وهذا "الطُّعم" الأندلسي تعايشَ داخل الثقافة الإسبانية دون "أن يفاجئ أحداً".
- مع تغيُّر الوضع التاريخي والجغرافي والسياسي، لا معنى لهذا "التوكيد الضحية" للفترة الأندلسية، لأنّه يتناقض مع فكرة إسبانيا وتاريخها.
- الركائز الكبرى للهوية الوطنية الإسبانية هي العالم الكلاسيكي الأوروبي والمسيحي. وهذا لا يعني أنّها ضدّ الإسلام. فلا يمكن بناء ثقافة ذات بعد عالمي إذا كانت ضدّ ثقافة أُخرى. لكن السؤال: هل يمكن إدراج الإسلام ضمن هذا التقليد الأوروبي الكلاسيكي والمسيحي، وهل يحترمه حقّاً؟
حقبةٌ امتدّت ثمانية قرون تُلخّص في صفحة أو صفحتَين
- تُبنى الهويات على التباين والإقصاء، وفي حالة إسبانيا، فإنّ التأريخ الليبرالي، منذ القرن التاسع عشر، طوّر سرديته عن الهوية على أساس إنكار الفترة الإسلامية. ولكن صُحِّحت هذه السردية من خلال تسمية "إسبانيا المسلمة" من قبل التأريخ الرسمي. وهذا، بلا شك، يُعطي بعداً أكثر تكاملاً للهوية الإسبانية. لكن لا يزال غريباً داخل نموذج الرؤية القومية الإسبانية.
- هناك صورة وهمية عن "إسبانيا المسلمة"، وهي مجرّد أسطورة مبنية على "أحلام اليقظة" و"التزييف المقصود".
- الوجود العربي الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية يعامَل معاملة الأسطورة. موسى بن نصير وطارق بن زياد لم يكونا إلّا قائدَين عسكريَّين دخلا الجنوب الإسباني وارتكبا الفظائع.
مع انتهاء جلسات المؤتمر التي لم تتناول موضوع المكوّن الإسلامي العربي في الهوية الإسبانية فحسب، بل الجمهورية الإسبانية الأُولى، والانتقال الديمقراطي، وقانون الذاكرة الديمقراطية، وغيرها من القضايا، وقّع المشاركون على بيان يؤكّد على "أهمية التاريخ من أجل التعلّم، خصوصاً أنّ تاريخ إسبانيا مليء، أكثر من أيّ بلد أوروبي آخر، بالصراعات والحروب". أكّد البيان أيضاً على ضرورة "توحيد مناهج التاريخ وفق الأفكار المطروحة في المؤتمر، بدلاً من أن يكون هناك 17 منهاجاً مختلفاً"!
لم يكن من بين المشاركين في المؤتمر من يملك تصوّراً مختلفاً عن معنى وجود المكوّن العربي الإسلامي في التاريخ الإسباني خارج تلك الأفكار التي طُرحت، والتي يمكن تصنيفها في غالبيتها بأنها ذات طابع وطني يميني. ورغم شعار المؤتمر، الذي يبدو للوهلة الأُولى أنّه جامعٌ ومنفتح ويقبل التنوّع الغني في التاريخ الإسباني، تمّ التأكيد على فكرة رفض الآخر الموجود في السردية التاريخية الإٍسبانية.
ربما من هنا نستطيع أن نفهم غياب المستعربين الإسبان والمختصيّن في الدراسات العربية - الإسلامية والأندلسية عن المؤتمر، ذلك أنّهم من أبرز المدافعين عن المكوّن العربي الإسلامي في الهوية الإسبانية، ولطالما طرحوا أفكاراً، قد يكون من المفيد عرضها، لدحض الأفكار التي طُرحت في المؤتمر.
- يؤكّد معظم هؤلاء المختصّين بالتاريخ العربي والثقافة العربية - الإسلامية، لا سيما في فترة العصور الوسطى، أنّ كلّ من درس وقرأ التاريخ في إسبانيا، يعرف قصّة "الغزو الإسلامي"، لكنّ الحقيقة هي أنّ المصادر التاريخية ليست واضحة. فالنصوص الإسلامية التي تتناول "الغزو" (إسبانيّاً)، والفتح (عربيّاً)، تأخّرت مدّة قرن ونصف القرن، والمصدر اللاتيني الوحيد، مجهول المؤلّف، ويحمل عنوان "تأريخ عام 754".
- ما حدث في شبه الجزيرة العربية لم يكن غزواً ناتجاً عن حرب مقدّسة؛ بل كان سلسلة من موجات الهجرة بدأت من هناك ووصلت إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، مولّدة عملية تعريب للمنطقة. من أبرز المدافعين عن هذه الفكرة حالياً هو إيميليو فيرين، وكتابه "عندما كنّا عرباً"، الذي تُرجم مؤخّراً إلى العربية، هو تأكيد على ذلك. وهذه الفكرة هي امتداد لسردية في مدرسة الاستعراب الإسباني بدأت مع إيميليو غارسيا غوميز، الذي كان من أبرز المؤكّدين على ضرورة الاعتراف بالمكوّن الأندلسي جزءاً من الهوية الإسبانية.
- من الأفكار الأُخرى التي يفنّدونها هي عدم وجود تاريخ إسباني خارج الرؤية القومية الكاثوليكية. هذا التاريخ قائم على فكرة أساسها الغزو العربي الإسلامي، وهذا من وجهة نظر تاريخية غير دقيق.
- تَحوّل تاريخ إسبانيا إلى أداة لخدمة مصالح وتيارات سياسية محافظة. وقام هذا التيار باحتكار تاريخ إسبانيا وتقديم رواية واحدة لا غير. كما تدعم هذه التيارات السياسية المحافظة فكرة أنّ المسيحية مثّلت التحضّر والتقدّم، في حين جسّد الإسلام التخلُّف. ولكن هذا، تاريخياً، ليس له أساس من الحقيقة. إضافة إلى ذلك كلّه، كانت الكنيسة في إسبانيا، تاريخيّاً، العنصر الذي أعاقَ التطوّر والتقدّم، وفقاً لهم.
- يؤكّد هؤلاء الأساتذة أنّ المسألة ليست صراع هويات، بل كيف نخلق وعياً إزاء التاريخ وكيف نفهم الآخر الذي أسهم فيه عبر منجزات حضارية كانت الحجر الأساس، ليس للحضارة الإسبانية فحسب، بل للحضارة الأوروبية كلّها.
- لا يمكن فهم الحاضر والنظر إلى المستقبل دون فهم عميق للماضي. وهذا يقتضي الاعتراف بالأندلس جزءاً من الهوية الإسبانية.
- ثمّة خلط بين ما هو عربي وما هو إسلامي. وهذا خطأ كبير يرجع إلى إسقاط أيديولوجي. يظهر هذا واضحاً داخل السردية الكاثوليكية. فبعض المؤرّخين المحافظين يتحدّثون عن "غزو إسلامي". أمّا البعض الآخر فيتحدّث عن "غزوات عربية". وهذا يعود إلى جذور غارقة في أيديولوجية ما يُسمى "الاسترداد".
- فترة ديكتاتورية فرانكو أسهمت بشكل كبير في هذه النظرة السلبية إلى الأندلس.
- هناك فكر تعبوي وتحريضي هو الذي يفسِّر ظهور الأندلس بشكل مفاجئ عام 711، وهو ذاته الفكر الذي يفسِّر الطريقة التي انتهت بها عام 1492.
بُنيت الهوية الإسبانية على إنكار الوجود العربي الإسلامي
وبعيداً عن الدفاع عن الأندلس أو الدخول في تحليل هذه الأفكار، ما كان إيجابياً منها أو سلبياً، يلفت الانتباه استمرار حضور الأندلس في صلب النقاشات الثقافية الإسبانية بوصفها مستقبلاً، لا ماضياً. وهذا يختلف عن الرؤية العربية للأندلس التي لا تنظر إليها إلّا من نافذة الماضي، من نافذة الأسطورة، أو في أحسن الأحوال كفردوس مفقود نقف على أطلاله كي نبكيه. الرمز شيءٌ والأسطورةُ شيءٌ آخرٌ تماماً. الرمز مستقلّ بطبيعته، لا يحتاج إلى الأسطورة. في حين تحتاج هذه الأخيرة إليه، وتستخدمه دائماً. عادةً ما يُخلط بين الرمز والأسطورة، وقد يكون هذا الخلط، في كثير من الأحيان، ناتجاً عن سوء فهم، عن تحيُّز، أو عن نيات سيّئة أو طيّبة.
لا شكّ أنّ الامتداد الأسطوري للأندلس برز بشكل أكثر تواتراً من الطبيعة الرمزية. وقد تنامت تلك النزعة في العقود الأخيرة، سواء من الجانب العربي أو من الجانب الإسباني.
في الأندلس، رمزاً أكثر منها أسطورةً، ما يتخطَّى كلّ حدود، ما يتخطّى كلّ هوية وإرث، حيث تمثّل الأندلس عملاً مفتوحاً يتجدّد مع كلّ قراءة، في ما وراء الأيديولوجيات والسياسة، في ما وراء السرديات الوطنية، وبالتالي تكون الأندلس مستقبلاً. وهذا العمل خُلق جمعاً لا فرداً، ليس عربياً، وليس إسبانياً. إنّه أندلسي لا غير. من هنا، لا بدّ من إعادة النظر عربياً إلى الأندلس بعيداً عن السرديات الوطنية، أو سرديات الأسطورة. ربما في هذا يكمن سبب العجز عن خلق أنموذج للحضارة الأندلسية في البلاد العربية؛ لأنّنا لم نستطع أن نُخرجها من الرؤية التقليدية للماضي. في النظر إلى الأندلس بوصفها مستقبلاً مفاتيح لإعادة اكتشافها والبناء استناداً إلى نموذجها في التعدّد والتنوُّع.