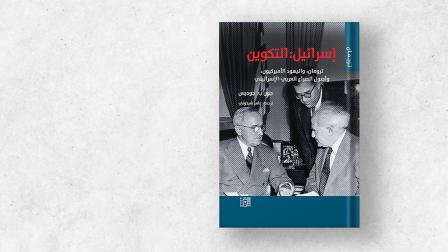في المديح الإعلامي لفيلم "الخروج للنهار" للمخرجة المصرية هالة لطفي يوصف بأنه قليل التكلفة، وهذا ليس جديداً، في السينما المستقلّة، التسمية التي تتحفّظ عليها المخرجة. كما لا توجد فيه موسيقى تصويرية، وهذا تكرّر مئات المرّات في أفلام سابقة، ولا وجود لنجوم شبّاك، وهذا ليس سابقة عصره ووحيد قرنه.
الفرصة التي أتاحتها مؤخّراً منصّة "نتفليكس" لعرضه ضمن 21 فيلماً لـ مخرجات عربيات تحت عنوان "لأنها أبدعت"، وضعتنا أمام مثالٍ جيّدٍ لسينما اليوم العادي الذي يمشي على مهله مشي الكآبة والوحشة في مكان ضيق. في إحدى العقوبات التي عرفناها في تاريخ البشر أن تُرسم دائرة ويؤمر المحكوم عليه بعدم تخطّيها. كلّ ما فعلته المخرجة المثقّفة أنها رسمت الدائرة، أو وجدتها مرسومة فراقبتها بعين متأمّلة.
لماذا تجري الأحداث؟
السرد في "الخروج للنهار" لا يقوم على الحبكة. إذاً ما الذي يجعله سينما وليس كاميرا مراقبة في سوقٍ تجاريٍّ تسجّل حركة الناس والأشياء؟ الجواب: لأن المخرجة أرادت ذلك كما تريد قصّةٌ القول لماذا تجري الأحداث، لا كيف وماذا سيحدث بعد قليل. وكما تقول لحظة الصمت في الموسيقى، حيث الصمت في الشقّة التي تسكنها أمٌّ وابنتها يقطع الحوار القليل بينهما، بينما الأب طريح الفراش لا يقوى على الحركة والكلام. استطاع الأب الغارق أن يفرض على البيت عجزه عن الكلام، وصار كناية عن العجز العام الذي يعيشه المواطن أواخر حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
جلطة
ولذلك لم يكن لدى المخرجة التي كتبت النص أيضاً، همُّ تعبئة الفراغ حتى تُضفي حركةً على هذه الشقّة الفقيرة. هي تبحث عن صوت الجسد حين يُصاب بجلطة. كان اسم الفيلم "جلطة" حين اشتغلت المخرجة عليه طوال سنوات، وإذ بها تشهد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، فقرّرت تغيير الاسم إلى "الخروج للنهار" من باب الاتساق مع الأمل الجديد الذي أطاح الصمت، ولم تعُدِ الألسن عاجزةً عن الكلام (إلى حينٍ كما يحدث دائماً في عالمنا العربي).
وربما كان العنوان الأخير ناتجاً من لحظة الحماسة ما بعد 2011، لكنّ العنوان الأوّل، الذي أفصحت عنه هالة لطفي هو ما لخّص تصوُّرها الكامل لفيلمها. إنّها تصوِّرُ انسداد الأفق أمام العائلة الصغيرة، بينما جاء "الخروج للنهار" ليُعطي فسحة ولو بسيطة لكي تقول المعاناة ذاتها عبر نهار عائلةٍ مصريةٍ، لم تمُت بعد، وهذا أفضل من الجلطة الضيقة والأفقر في الدلالات.
الحياة الأُخرى
ربما هذا ما فكّرت به المخرجة، إلّا أنّ الخروج للنهار لدى المصريين القدماء، بالهيروغليفية "برت إم هرو" هو الحياة الأُخرى ما بعد الموت. سيتحقّق الموت أوّلاً وسترافق الميّت تعويذاتٌ، منها "تعويذة من أجل الحصول على قارب للتوجّه إلى حقول السلام". فالميت يُدفن محنّطاً كي يعبرَ إلى الحياة الجديدة بجسدٍ كاملٍ، ومعه نصوص وضعها الأحياء الباقون من خلفه، على أمل أنه "سيُعطى الكعك والبيرة والخبز المدوّر على مذبح الآلهة، وسيُمنح حقلاً من القمح والشعير" كما يورد كتاب "الخروج للنهار" منذ خمسة آلاف سنة.
هذا لا يحدث في الفيلم على كلّ حال. إن المشهد الأخير مخيف وتُرك بلا إجابة، حين تسأل الشابة أمها: "أين سندفن أبي وهل لنا مقبرة؟". تُركت اللقطة دون جواب، فهذه إذن جلطة وجودية، والخروج إلى النهار لم يكن رحلةً إلى السماء، بل تحديق البشر في يوم عادي. اليوم العادي هو الكابوس.
البطء
البطءُ هو الزمن الحقيقي الذي ينتج منه أمرٌ ممتاز في أوّل فيلم روائي طويل للمخرجة. امرأتان: الأم المُمرِّضة (سلمى النجار) التي تصرف على البيت، والابنة سعاد (دنيا ماهر) التي لم تتزوّج وتتقاسم مع أمها خدمةً للأب العاجز. الأب الصحافي (أحمد لطفي) الذي لعبَ الدور وقد رحل لاحقاً، وفتاة الميكروباص (دعاء عريقات) في مشهدٍ وحيدٍ من ستّ دقائق. جميع هؤلاء لا يمكن نسيانهم، فقد جرى خلقُهم سينمائياً لأول مرة، وكانت هذه شهادة الميلاد الرسمية لهم جميعاً. والبطء هو الذي جعل صورَهم حاضرة بقوة.
في الربع الأول من زمن الفيلم (96 دقيقة) منتصف النهار، إذ الرجل العاجز الذي بات لا ينام إلّا عند الفجر، فرض على ابنته موعد نوم غير طبيعي، بينما الأم تستيقظ باكراً، ولا تجد من تكلّمه. هذا كلّه سيمضي بزمنه الحقيقي، بالكلام الجافي بالغ الاختصار بين الأم وابنتها، والمحبة التي تربطهما وفقر مدقع في التعبير عنها، وتغيير حفّاظة الرجل العاجز، وإطعامه، ودهن ظهره المتسلّخ بالمراهم، وقصّ أظفاره.
بحساسية يَقِظة من المخرجة، أثبتت أن الشعر المأساوي يمكن أن يمرّ بأقلّ سرعة من الزمن وبأصوات تتطلّب إصاخة السمع. إلى أن تزداد حركة الفيلم، بانعكاس لحركة الشارع الطبيعية، إلى درجة أن الأشخاص الحقيقيين الذين يبيعون ويشترون أو يركبون الميكروباص بدَوا شركاء أصيلين في الفيلم، كأنّ المخرجة أسّست مجتمعها السينمائي على مهل. هذه خمس سنوات يمكن فيها تأمّل العبور إلى النهار - السماء منذ برديات مصر القديمة إلى نهار عائلة راهنة، تريد الحياة "إذا ما استطعنا إليها سبيلاً".