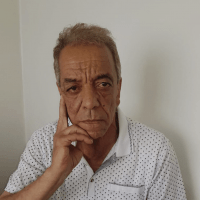الوسائط الرقمية وتأثيرها على السلوك الاجتماعي
محمد كلاوي
لا يجادل أغلب الدارسين في كون العولمة، وهذه من آثارها الإيجابية، قد حالت دون الانكفاء الثقافي في ظل متغيرات الاقتصاد والسياسة، وسمحت بتوفير آفاق جديدة نحو التثاقف والاحتكاك الحضاري. لكن سيرورتها أفضت سريعا إلى هيمنة الثقافة السائدة، وبالتالي إلى إبطال التعددية لفائدة نمط الاستهلاك الغربي والأميركي على وجه التحديد.
وفي هذا السياق، يبدو من المفيد التوقف لبرهة عند التحليل العميق والجريء للفيلسوف المعاصر أندريه كونت سبونفيل في دحض الأفكار العنصرية التي دونها صامويل هنتتنغتون في كتابه حول صراع الحضارات. في القاموس الفلسفي الذي صدر له، يميّز سبونفيل بين حضارة كونية ركيزتها العولمة وتكنولوجيا الإعلاميات، وما يترتب عنها من انتشار حتمي لحقوق الإنسان والمواطنة التي تغرف منها كل شعوب العالم، وبين الأصولية التكفيرية، وهي ثقافة منغلقة ميزتها التشدد والطائفية والتطرف.
وهذا في نظره هو الانشطار الحقيقي للحضارات، سواء كانت غربية أو مشرقية، مسيحية أو إسلامية، صينية أو هندوسية.. أي أن كل حضارة خصوصية، لأن الصدام الحقيقي هو صدام داخل كل حضارة بين تيار تنويري حداثي وتيار أصولي ظلامي. إذن حسب سبونفيل ليس هناك صراع بين الحضارات المختلفة، بل هناك فقط حضارة كونية تنويرية وحضارات خصوصية منغلقة على ذاتها.
جدير بالملاحظة أن هذا التحليل يحتوي على نسبة كبيرة من الدقة والمنطق، لكنه للأسف لا يجيب، أو بصيغة أدق، لا يستحضر مجموعة من المعضلات البنيوية في تكوين العقل العربي الإسلامي.
- لأن مفهوم العلمانية الذي ينطلق منه سبونفيل لا يزال، ولربما سيظل، يحمل في جوهره مضمونا سلبيا حتى في أعين المتنورين من المسلمين. لنتذكر أن اجتهادات سابقة لبعض دعاة العلمانية، أمثال علي عبد الرازق وفرح أنطون وحسن حنفي.. قد اصطدمت أساسا بمواقف دعاة الإصلاح كمحمد عبده والطهطاوي ورشيد رضا، لأن هؤلاء في دعوتهم للتجديد لم يتوجهوا إلى البنية العقائدية للدين، بل اكتفوا بالمظاهر الخارجية المتلازمة مع ضرورة إعادة انتاج المؤسسات والتنظيمات الغربية الحديثة.
- يجوز أن يكون منطلق دراسة سبونفيل هو تأقلم الدين الإسلامي في الغرب، وخاصة الدول العلمانية الديمقراطية، حيث شهدنا نساء يقمن بإمامة الصلاة في المساجد، ومثليين يُعقد قرانهم على أيدي أئمة مسلمين.. لكن يبقى السؤال حول مدى حياد السلطة السياسية في الموضوع.
- الدولة في العالم العربي تتناقض ومفهوم الدولة في الغرب، فإذا كان بعضها يستمد شرعيته من الدين. فركيزة الدول العربية تظل هي القبيلة حيت ينتفي وجود الفرد، وإذاً سبيل تحقيق المواطنة.
استنادا إلى هذه المعطيات، يمكننا التساؤل عن كيفية تقييم آثار شبكات التواصل الاجتماعي على سلوك الأفراد والجماعات في ظل الثورة الرقمية، خصوصا منذ أن جرى، تحت ذريعة دمقرطة المعلومة، غزو الإنترنت كلَّ مناحي الحياة المجتمعية؟
نجد في هذا السياق بوادر ردة فعل نقدية يزيدها حدة ومصداقية كونها صادرة عن أولئك الذين ابتكروا أو ساهموا بشكل مباشر في انتشار التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل، أمثال تيم كوك مدير "آبل"، وتريستان هاريس وتيم بيرنرز لي مخترع الويب.. فباعترافهم يؤكدون أنهم بصفة غير استشرافية فجّروا النسيج الاجتماعي التقليدي عبر تغيير نمط العيش لدى المتلقي. أكثر من هذا، تبيّن أنهم عملوا على تحصين أبنائهم ضد السقوط في الإدمان على هذه التقنيات، من خلال بعثهم مرافقَ تعليمية خاصة يحظر فيها العمل بها.
الصدام الحقيقي هو صدام داخل كل حضارة بين تيار تنويري حداثي وتيار أصولي ظلامي
وإذا لم تسلم من عبء التعوّد حتى الشعوب المتقدمة علميا وتقنيا، فإنه، لعوامل ثقافية وحضارية، لم يكن بنفس المقدار الذي عليه باقي الشعوب الثالثية، أي بمعنى أكثر وضوحا تلك التي لم تحقق الطفرة النوعية الكفيلة بإخراجها من براثن الاستبداد الفكري المتزمت الذي يجعلها لا تستفيد من فوائد التقنيات الحديثة، بل تحوّرها إلى وجهات تلبي طبائعها المنحرفة أو المتشددة. لنتذكر كيف استغلت التيارات المتطرفة، ولا تزال، كل الابتكارات الناجمة عن العولمة لتزكية طروحاتها الأيديولوجية، دونما أدنى إحساس بالتناقض ما دامت هذه الابتكارات من صنع "الكفار الواجبة محاربتهم".
غير أن ما يثير التساؤل هو لجوء بعض الأنظمة السياسية إلى استغلال هذه الآليات لخدمة مصالحها الضيقة التي ينطبق عليها قول ماكس ستيرنر: "إن هدف كل دولة كان دوما هو نفسه: تبخيس قيمة الفرد وتدجينه وإخضاعه واستعباده".
إن ما شهدناه مؤخرا من تفاقم مظاهر التفسخ الأسري لا يمكن تفسيره فقط بتدني المستوى المعيشي، حتى ولو لزم عدم تجاهله، بل إننا نعتقد أن إحدى علامات هذا الانحلال يعود بالأساس إلى الانعكاسات السلبية للوسائط الإعلامية، وعلى رأسها التلفزيون، الذي جعلت منه الحكومات ليس فقط أداة للترفيه والإخبار، بل سلطة قائمة الذات للتمويه والتمييع، لطمس الهوية تحت غطاء رفع نسب المشاهدة (نموذج روتيني اليومي والسهرات الفنية…).
وأمام شح، إن لم نقل انعدام، أي معطيات إحصائية دقيقة حول مدى إدمان الفئات الاجتماعية على الوسائط الإعلامية في بلادنا، سأطرح جملة من الفرضيات المستقاة من الملاحظة العينية للواقع المعاش:
- التماهي مع العالم الافتراضي خصوصا في مرحلة المراهقة.
- التجسس بواسطة تطبيق واتساب، والتذمر من عدم التفاعل السريع مع الدردشات الذي يصبح مدعاة للريبة والضغائن، وينتهي أحيانا بالخصومات المعلنة أو المضمرة.
- التطبيع مع صور العنف لدى الصغار.
- الابتزاز بشتى الطرق.
- انتشار الإباحية والتحرش الجنسي بجميع أشكاله.
- التماهي مع أبطال المسلسلات وبرامج "التلفزة الواقعية Télé-réalité" دونما إدراك لشروط صناعة الفرجة.
- الإحساس بالدونية خاصة أمام خطاب التعالي لدى الإعلام الغربي في جل البرامج والتعليقات، ما يعزز دائرة ثقافة الفشل في الخطاب المحلي. وأجرؤ على القول إن ما ساهم بنسبة كبيرة جدا في تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم خلال دورة كأس العالم الأخيرة، دون إغفال العمل الجاد والمثابرة، هو عزيمة المدرب وليد الركراكي في قتل هذه الثقافة لدى اللاعبين بإعمال "النية" في الوصول.
والواقع أن الاستفادة إيجابا من مختلف التطبيقات والمحركات الرقمية تتطلب تحرير روادها من قيود الجهل والتعصب والكبت، وهو أمر غير يسير لارتباطه بالحالة العامة للبيئة التي يعيش فيها. فبالنسبة للأطفال عموما، ابتدع رائدو الفيديوهات الرقمية التي شغلت جل أوقات المراهقين، بل وحتى غير البالغين سن التمدرس، نماذج ألعاب مختلفة ومغرية، ما شكل خطورة على ذهنية الأطفال، ولو أنها قد ساعدتهم على صقل مهاراتهم. لكن خطورتها لم تلبث أن أثارت الاهتمام، ما دفع بالشركات المنتجة لابتكار ألعاب متحكم فيها كـ"Our World". ومع ذلك، لم تمنع هذه المحاولات زرع بذرة الاكتئاب والإحباط لدى جزء كبير منهم لانسحابهم المجتمعي بسبب طول جلوسهم أمام الحاسوب.
صحيح أن شباب الشبكات العنكبوتية قد اختلق لهجة خاصة في كتابة الرسائل المتبادلة، التي بقدر ما تعبر عن قدرتهم في تلخيص الجمل بنوع من المهارة والذكاء، بقدر ما تبعدهم عن أبجديات اللغة والنحو والصرف.. والنتيجة المنطقية ضعف هائل في التعبير والبلاغة، وبالتالي في المستوى التعليمي العام.
هناك نماذج سلبية أخرى يجلو عنها الاستعمال المفرط لوسائل التواصل الرقمي، لعل أخطرها تناسل عدد اليوتوبرز ومن ينعتون أنفسهم بالمؤثرين، الذين يملؤون المواقع الإلكترونية، في الغالب بدوافع اقتصادية، والذين يجهل معظمهم أبسط أخلاقيات مهنة الصحافة والحرية في التعبير.
على الصعيد الاجتماعي، ترتب على هذا التسيب انتهاك حرمة الأشخاص من خلال المساس بمعطياتهم الخاصة، ما أسفر عنه تمزق العديد من الأسر ضحية التشهير والقذف والسب وانتشار الأخبار الزائفة، ونشر وثائق مفبركة أو مزورة، بل وزرع خطابات الكراهية، كذلك جرى استغلال الواتساب من أجل التجسس بين الزوجين، وكانت هذه الظاهرة إحدى المسوغات الرئيسية في ارتفاع نسبة الطلاق خلال العقد الأخير.
للإشارة، ارتفعت في المغرب بين الحين والآخر أصوات منددة تطالب "الهاكا" (الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري)، بداعي الدفاع عن الدين أو الأخلاق العامة، بالتدخل لمنع عرض بعض الأشرطة السينمائية أو البرامج الإذاعية والتلفزية. هنا وجب التذكير أن "الهاكا" ليست سلطة رقابية، بل مؤسسة حكامة دستورية مستقلة للضبط والتقنين، هدفها السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر (الفصل 156 من الدستور)، وعليه، تكون تدخلاتها بعدية تتطلب زمنا غير زمن الصحافة. وفي هذا الباب أصدر مجلسها الأعلى بمناسبة انتخابات 08 سبتمبر/ أيلول 2021 أول قرار حول الأخبار الزائفة بهدف الرفع من مستوى يقظة الناخب وصون اختياره.
لقد كانت هناك محاولات عدة للحد من هذه الفوضى والخروقات من طرف عمالقة الإنترنت، غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت، التي اعتمدت بعض آليات التقنين الذاتي لمحاربة الأخبار التضليلية، مثل التذكير بالقواعد العامة وضبط المضادين.. وسحبها إن اقتضى الأمر.. لكن دون جدوى على مستوى التنفيذ بسبب تطور مهارات أصحاب المراوغات التقنية على شبكة الإنترنت.
وفي المغرب، اتخذت عدة تدابير احترازية كاعتماد المصدر الأول، وتحديد هوية صاخب الخبر، والتحقق من الخبر من طرف متعهدي الاتصال السمعي البصري، العموميين والخواص، إبان تفاقم الأخبار الزائفة طوال مرحلة تفشى وباء كورونا سنة 2020، كان من نتائجها محاكمة عدد من أصحاب القنوات بتهمة نشر خبر زائف، حيث اعتبرت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو قيام المتهم بنشر تدوينة على منصة فيسبوك، ولو على سبيل المزاح، جنحة تمس الحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وعليه أدانته بشهرين سجنا نافدا.
في المقابل، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما بثلاثة أشهر سجنا نافذا ضد متهمة، بعد أن حوكمت ابتدائيا بسنة سجنا نافدا لقيامها بنشر فيديو على يوتيوب تنفي فيه وجود وباء كوفيد 19، وتحرض على عدم التقيد بالقرارات الاحترازية.
لكن الواقع يثبت عدم نجاعة كل الطرق الاحترازية أو الزجرية ما دامت الدولة لا تتحكم في فضاء الإنترنت، بحيث تصبح وسيلتها الوحيدة هي الحذف الشامل للشبكات العنكبوتية على مجموع التراب الوطني، كما فعلت بعض الدول الديكتاتورية، ككوريا الشمالية والصين.. لكن هناك طرقا عديدة تلجأ إليها حتى الدول الديمقراطية، ولو كان فيها خرق لحق الولوج إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل 19 للميثاق العالمي لحقوق الإنسان. ففي فرنسا وألمانيا مثلا، جرى حظر الصور المشيدة بالإرهاب، وتلك التي تنفي وجود المحرقة في ظل الحكم النازي والإبادة الشاملة.
وتبقى أحسن طريقة هي تحصين المواطن من خلال الرفع من مستوى التعليم ومراجعة أساليب التنشئة التقليدية. فعلى المسؤولين أن يستوعبوا أن سياسة التجهيل على المدى المتوسط والطويل لن تزيد الدولة إلا أعباء هي في غنى عنها. وكما قال أحد الحكماء: "من يعتبر التعليم مكلفا، فليجرب الجهل".