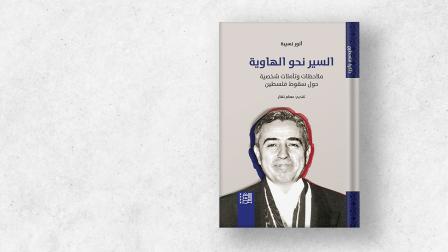كان اختراع المدرسة، بكلّ تأكيد، لحظة الذروة غير المؤرَّخة لانتصار السلطة السياسية الحديثة، وإعلان ميلاد عصر ديكتاتورية المؤسسة، التي سجّلت هزيمةً نكراء للمعرفة والشخصية في آن.
في الماضي، كان الناس يحجّون إلى مدينة فيها شاعر أو فيلسوف أو حكيم، كي يأخذوا العلم عنه. وكانت الطريق إلى بغداد أو قرطبة أو سمرقند، مثلاً، مساحة لامتزاج المعرفة والتجربة الشخصية معاً.
أوّل ما فعلته المدرسة أنها طوّبت الاختصاص، وأنهت عصر المثقّف العارف. لم يعد ممكناً بعدها أن يأتي ذلك الشخص الذي يوائم العلوم الإنسانية والتطبيقية، بحيث تبدو مترابطة مشيميّاً، فلا فرق بين الكيمياء وعروض الشعر، أو الفلسفة وعلم الفلك.
سيقول قائل: لكنّ ذلك جاء لضرورات التطوّر، كما جاء بأفضال كبرى على حياتنا. صحيح إلى حدّ ما، لكنّ في داخل ذلك التطور المزعوم، تطوّرت الأمراض بمقدار ما تطوّر الطب. أعطني أمراض عصر ابن سينا أو الرازي وسأقبل بالتطبّب على أيديهما، وفي مشافيهما.
ربما تكون اللحظة التي فُصل فيها التعليم إلى فرعين، "علمي" و"أدبي"، هي لحظة النهاية لعصر كامل من الإشراق الحسي والعقلي.
بين كل هذه الفظائع، يبقى أن الوجه الأشد شناعةً للمدرسة، في بعض دولنا، يكمن في إعادة إطلاق العنان للقبيلة، عبر "الحزب القائد"، بما لا يختلف على الإطلاق عن عالم "الأخ الأكبر" في رواية جورج أورويل.