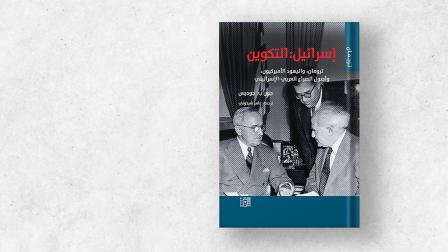في الغوطة
عندما يأتيها النبأ، ترسمه أمه شهيداً. أما والده، فيظل تائهاً في الخارج، يحرق ما تبقى في علبة السجائر وما تبقى من أحزانه. ثم يدخل إلى البيت متفقداً حاجات ابنه وملابسه، يرفعها إلى مستوى نظره ويتأملها، ربما مقاسها من مقاسه أو من مقاس إخوته الذين يصغرونه بقليل.
في حلب
كان يخاف مواجهتهم وهم مستيقظين، لم يكن يريد أن يرى نظرات الرعب في أعينهم. أغمض عينيه وقتلهم في فراشهم قبل بزوغ الفجر وهرب مبتعداً يستقبل مصيره من دون قلق. انتابته نوبة من الضحك الهستيري وهو يجري ودموعه تمتصّها رمال الأرض الجدباء شمال المدينة ثم راح يصرخ بأعلى صوته منادياً: إلهي إلهي، لماذا تركتني؟
لم ينشقّ حجاب الهيكل حينها، فلا هيكل كان هناك ولا إله.
في الشام
لم يكن شادي يتخيّل أن حلمه الصغير المتواضع سيذهب أدراج الرياح. ما هذه الحرب الملعونة! كل ما كان يطمح إليه هو أن يستقل عن أهله كما يفعل الشباب في الغرب، فيستأجر غرفتين من طابق أرضي في أحد أحياء جرمانا، مأوى الناس البسطاء.
كان سيخصّص غرفة منهما للمنامة والغرفة الأخرى لتكون مرسماً يضع فيه بالإضافة إلى مستلزمات الرسم الأساسية، أريكة كتلك الأريكة التي رآها حين زار مرسم فنانه المفضل نبهان، وهي عبارة عن صندوق خشبي يغطيه بساط خمري اللون مزركش كتلك البسط التي يستعملها أهل القرى والأرياف.
جرمانا تبعد عن بيته، أي بيت أهله، مسافة نصف ساعة. قرّر أن يقطنها أسوة بباقي الشباب الذين سبقوه إليها، لكن هيهات، كل شيء قد تغيّر الآن. "آه يا جرمانا، كان يقول، يا وجع النايات!".
في برلين
على نافذة غرفتها، وضعت سلمى صحناً صغيراً فيه منديل ورقي أبيض تفترشه بضع عشرات من حبات العدس... بلّلته قليلاً بالماء وقالت لي: خلال يومين أو ثلاثة، يصبح هذا الصحن وطناً.
* فنان تشكيلي سوري