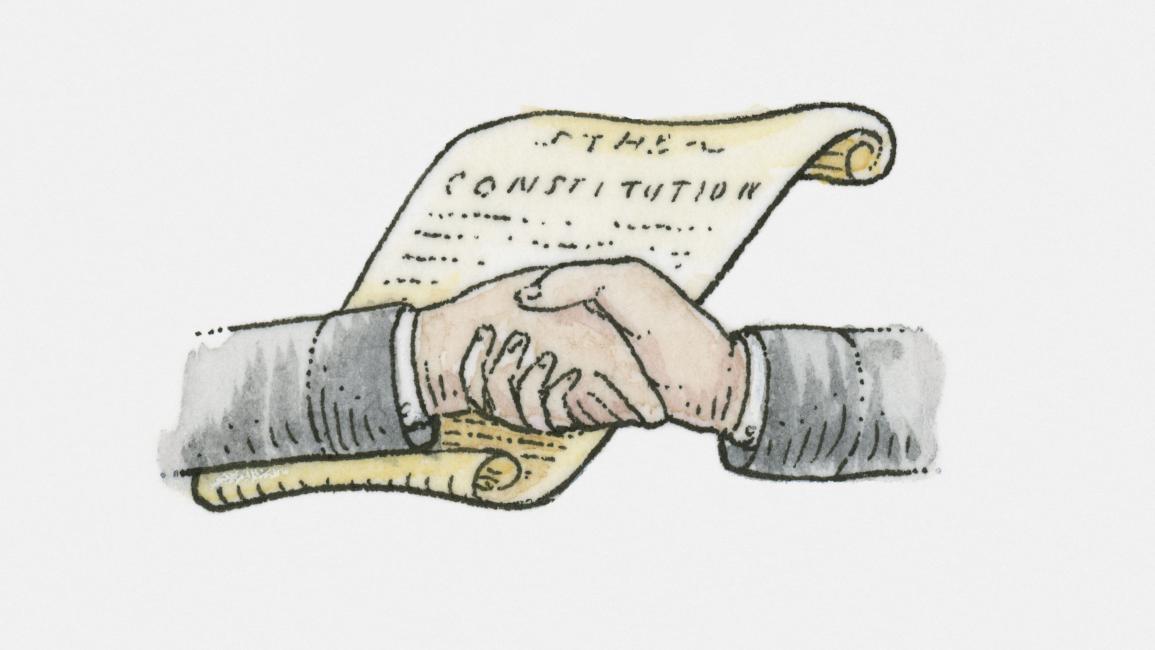في إعادة تعريف الوطنيّة
هل يمكن أن تبرّر الوطنية القتل؟ وإرهاب الدولة؟ وممارسات الأنظمة الفاشية؟ والشماتة في مصائب الآخرين؟ هل يمكن أن تحرّض على نزع إنسانية بعض المواطنين، فضلاً عن انتمائهم لأوطانهم؟ هل يمكن أن تدفع الإنسان إلى وضع "البيادة" على رأسه، ورؤوس أولاده، ولا يستشعر حرجاً، بل وهو سعيد منتش؟ وهل يمكن أن تدفع الوطنية الإنسان ليسلّم قياده لبشر يوجهه حيثما شاء؟ وهل يمكن أن يُختزل الوطن في شخص، أو نظام، فتخبو من أجلهما قيمة الإنسان والأرض والتاريخ والجغرافيا جميعاً؟
أزعم أن إجابة الإنسان العادي، في الظروف العادية، على هذه الأسئلة، من البداهة، بحيث يبدو طرحها ضرباً من السخف، أو نوعاً من التحذلق. وأحسب أن سبب البداهة ذلك القدر الفطري الذي يمتلكه الإنسان من الضمير والكرامة. وهما ليستا عرضاً في الإنسان، بل أساسيتان في أي تعريف جامع مانع له. وإلا، لماذا يحتاج الإنسان، في حالته الطبيعية، إلى كل ذلك القدر من الجهد، لقمع ما يمليه عليه ضميره، ولماذا يحتاج الجلاد لكل ذلك القدر من العنف، ليكسر عزيمة مجلوده، ولماذا يحتاج النخّاس كل ذلك القدر من الإذلال، حتى يضعف حسّ الكرامة عند مَن يسعى إلى استعباده، وبيعه، في سوق النخاسة؟
بيد أن تلك البداهة الموصوفة تخفت، وتنزوي، في أوقات أزماتٍ من نوعيات معينة، أزمات من النوع الذي يسعى إلى تشويه الوجدان، وإيجاد وعيٍ زائف، يجعل كل الشرور محامد، لا يتورّع الإنسان عن الوقوع فيها، قبل كل صلاة وبعدها. هذا هو الحال مع الثورة المضادة. فإذا كانت الثورة تمثل معاني الطهر والنقاء والغيرية والجهاد، في سبيل المستضعفين في الأرض، والتمرّد على الاستبداد، وما يصاحبه، بالضرورة، من الاستهزاء بكرامة الإنسان وحريته التي خلقه الله عليها، فإن الثورة المضادة، في جوهرها، تمثل الضد لتلك المعاني.
هنا، في ظل الثورة المضادة، تتغيّر أداة الاستفهام في الأسئلة السابقة من "هل" إلى "كيف". فلا يكون السؤال: "هل يمكن أن تبرّر الوطنية القتل والتصفيق لإرهاب الدولة ووضع البيادة فوق الرؤوس"، ليصبح: "كيف يمكن أن تبرّر الوطنية، بل وأن تتطلب، تلك الأمور". هنا، يصبح دور مثقفي السلطة التنظير لتعريف الوطنية الجديد، ودور إعلام السلطة ترويجه، ودور قضاء السلطة تطبيقه، ويصبح دور شرطة السلطة سحق كل مَن لا يخضع له، ودور تعليم السلطة إيجاد المواطن "الصالح" حسب ذلك التعريف.
هنا، فقط، يمكن أن ندرك الأثر المدمر للثورة المضادة على وجدان الإنسان. فلا يمكن لثورة مضادة أن تنجح، إلا بطمس الضمير، والقضاء على الاعتزاز الفطري لدى الإنسان بكرامته الإنسانية، أي بآدميته التي كرّمه الله بها، بحيث ينفر، في حالته الطبيعية الفطرية، من الخضوع المذلّ لأقرانه من البشر. وليس أخطر على شعبٍ ما من أن ينطمس ضميره، ويفقد شعوره بكرامته. الأمر، هنا، أكبر من هزيمةٍ عسكريةٍ تجرح الكبرياء الوطني، فقد تشحذ الهزائم الهمم، وتزيد من جذوة اعتزاز الإنسان بكرامته، بيد أن انطماس الضمير، وفقدان الشعور بالكرامة البشرية، قد تكون آفاتٍ لا علاج منها. فبقدر صعوبة التخلّص منهما، لتمكّنهما الفطري من آدمية الإنسان، يصعب على المرء استرجاعهما بعد فقدهما، ربما خوفاً من مواجهة ماضٍ قد يصعب عليه تذكّره، بعد ضياع سكرة اللحظة.
غداً يدرك بعض مَن صفّقوا وهلّلوا، وفوّضوا وباركوا، وحرّضوا واستشفوا، أنهم كانوا يسعدون حين كان ينبغي أن يحزنوا، ويصفقون حين كان ينبغي أن يصرخوا. فحين يفقد المرء شعوره بضميره، وإحساسه بكرامته، يفقد معهما إنسانيته، ويصبح عبداً مستباحاً، لا يقدر إلا على التصفيق، ولو فقد السعادة نفسها، كما سيحدث حتماً. غداً يفقدون السعادة، لكنهم لن يستردوا ضمائرهم، ولن يسترجعوا كرامتهم. غداً يدركون ما اقترفته أيديهم في حق أنفسهم، وفي حق الوطن. غداً يدركون أن إنسانية الإنسان أكبر وأبقى من حب الوطن. غداً يعلمون أن الإنسان، بوجدانٍ مشوّه، أبداً، لا يكون مواطناً كريماً في وطن عزيز. ويظل قدر الغرباء المستعدين لتحمّل تبعات التغريد خارج السرب أن يظلوا متهمين. ولكن التاريخ يفضح وينصف، ولو بعد حين. فطوبى للغرباء المتهمين.