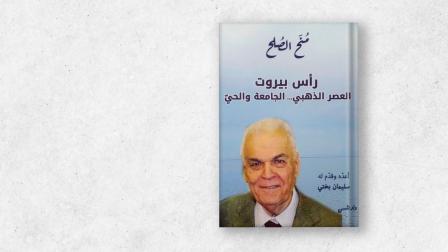ليس نقدُ الموقف الثقافوي الضاربِ بجذوره في الثقافة الغربية بالأمر الهيّن، حتى وإن بدا كذلك لأول وهلة، خصوصاً أنّ هذا الموقف يتردّد ويتكرّر في صيغ مختلفة في "دول الأطراف"، بشكل يجعلنا نتّفق مع المفكّر الاقتصادي المصري سمير أمين (1931 - 2018) حول ما سماه "مركزيةً مقلوبة"، أو مجرّد تكرار لـ المركزية الغربية.
في كتابه الذي لم يُقرَأ بشكل كافٍ "حداثة، دين وديمقراطية: نقد المركزية الغربية، نقد الثقافويات" (2008)، يعمد أمين بدءاً إلى تقديم تعريف للثقافوية، مُعتبراً أنّها نظرية تَظهر بشكل متّسق وتَفهم نفسها باعتبارها نظريةً شاملة. إنها تقوم على فرضية تقول بوجود خصائص ثقافية ثابتة تملك القدرة على الاستمرار، وذلك على الرغم من التحوُّلات الاقتصادية والثقافية. يعني ذلك أنَّ الخصوصية الثقافية ستتحوّل، وفقاً لهذه الرؤية، إلى المحرّك الأساسي للتاريخ.
ويضرب أمين مثلاً على ذلك بالنظرية الفيبرية، والتي رأت في البروتستانتية السبب الرئيس خلف التحوُّل نحو الحداثة الرأسمالية. لكن بالنسبة إلى أمين، القادم من الماركسية، فإن البروتستانتية نفسها هي نتاج للتحوُّلات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها أوروبا. إنه من الضروري أن نؤكّد ذلك في هذا المقام، وذلك لأن الثقافويين، بنقدهم السطحي، دائماً ما يزعمون بأن مشكلة الإسلام تعود إلى أنه دين لا يسمح بالإصلاح ولم يعرف التنوير. ولربما يكون من الضروري هنا أن نتحدّث عن بعض أوهام التنوير، وخصوصاً ما سُمّي بالحرية.
فهذه الحرية التي يتم الاحتفاء بها كقيمة من قيم التنوير المركزية، سيعمد النظام الرأسمالي إلى تحديد معالمها ورسم حدودها، حركاتها وسكناتها، بحيث إنه لا يمكننا أن نتحدّث عن حرية بالمطلق، ولكن عن حرية رأسمالية فحسب. وطبعاً يكرّر سمير هنا نقد ماركس للحرية البورجوازية كما تعبّر عن نفسها في فلسفة التنوير، هذه الحرية التي ستنتهي اليوم، في العصر الأميركي، إلى نوع من العقل الأداتي وتنتهي معها الذات الحرّة إلى ذات مستهلكة، فتجد جوهر حريتها في الاستهلاك، كما بيّن ذلك أقطاب "النظرية النقدية".
لكن ما تفعله الرأسمالية بالحرية، تفعله بالدين. هذا لا يعني بأن الرأسمالية من يحدّد المضمون اللاهوتي للدين، ولكنها من يرسم دوره الاجتماعي والسياسي، وهو ما من شأنه أن يعبث في النهاية بذلك المضمون ويجعله مجرّد انعكاس أو تبرير لذلك الدور. وبتعبير آخر، ففي ظلّ نظام ديمقراطي، كما الحال في الديمقراطيات الغربية، فإن الدين يمتلك دوراً مختلفاً عن الدور الذي يلعبه في "دول الأطراف"، بل حتى في دول غربية حديثة العهد بالديمقراطية.
يختلف ذلك الدور، ليس لأن المسيحية الغربية أكثر تطوّراً من الإسلام أو البوذية أو المسيحية الشرقية من وجهة نظر لاهوتية كما يدّعي الثقافويون. السبب في هذا السياق هو من طبيعة اجتماعية وليس من طبيعة لاهوتية. وسمير أمين محقٌّ حين ينتقد تلك النظريات التي تتحدّث عن "عبقرية المسيحية"، والتي لا تنافح في النهاية إلّا عن نظرية مثالية للتاريخ تقول بأن الرأسمالية نفسها هي بنت المسيحية أو بنت البروتستانتية.
أجل، لقد اضطرّت المسيحية الغربية للدخول في حوار مع إنجازات الحداثة، أي الديمقراطية والتحديث والعلمنة، وتمكّنت بفضل هذا الاصطدام المبكر بالحداثة وتحدّياتها من التحرُّر من دوغمائيتها، وهو ما لم يتحقّق للإسلام التاريخي الذي حُرم من حقّه في الدخول في حوار جدّي مع الحداثة، أو لم يكن مستعدّاً لذلك، لأسباب داخلية وأخرى خارجية، وخصوصاً لأسباب خارجية، لأن الحداثة الرأسمالية لا تسمح وإلى يومنا هذا بدمقرطة الأطراف، هي التي ما برحت تدعم مختلف أشكال الديكتاتوريات في المنطقة العربية من ثيوقراطية، وعسكراتية وطائفية ومافيوزية، وعبر ذلك تدعم سيطرة تديُّن دوغمائي يؤبّد طلاقنا الداخلي مع الحداثة.
 تعوق الرأسمالية الغربية قيام وعي حداثي في "دول الأطراف"، تماماً كما فعلت كلّ شيء من أجل ضرب الوعي الطبقي في دول المركز نفسها. إنّ ثقافة الرأسمالية تزعم أنها تقوم على كونية إنسانوية، لكنها في صيغتها الأورومركزية، تقف ضد هذه الكونية، وذلك ليس لأن "المركزية الأوروبية تدمّر الشعوب والحضارات، التي ترفض نموذجها"، كما كتب أمين، بل لأنّها تدمّر الشعوب التي تطلب استنساخ ذلك النموذج، والتحوُّل إلى شعوب حرّة.
تعوق الرأسمالية الغربية قيام وعي حداثي في "دول الأطراف"، تماماً كما فعلت كلّ شيء من أجل ضرب الوعي الطبقي في دول المركز نفسها. إنّ ثقافة الرأسمالية تزعم أنها تقوم على كونية إنسانوية، لكنها في صيغتها الأورومركزية، تقف ضد هذه الكونية، وذلك ليس لأن "المركزية الأوروبية تدمّر الشعوب والحضارات، التي ترفض نموذجها"، كما كتب أمين، بل لأنّها تدمّر الشعوب التي تطلب استنساخ ذلك النموذج، والتحوُّل إلى شعوب حرّة.
غير أنه ليس مهمّاً في هذا السياق، وهنا نتحدّث ضدّ سمير أمين، ما إذا كان الإسلام يمثّل ثورة دينية أم اجتماعية؛ فالضروري هو أن نؤكّد بأن لكل حقبة إسلامها، أو أن لكل حقبة تديُّنها، ولا يمكننا أن نعتقد بنفس الدين مرّتين، فما قاله هيرقليطس عن الكينونة، يمكننا قوله عن الدين. لا وجود لدين ثابت، ولكن فقط لتدين متحوّل. ولهذا السبب فإن الزعم الثقافوي، الذي يتكرّر منذ القرن التاسع عشر، كما هو الأمر مع الإثنولوجيين الفرنسيّين في الجزائر، والذي يرى بأن الإسلام لم يعرف الحداثة لأنه معاد لكل تطوُّر بشكل جوهراني، يمتح أفكاره من تلك الصورلوجية الفلسفية المغلقة التي أسّست لها الحداثة.
لا، إن الإسلام ابن الحداثة وتعبيرٌ عن تناقضاتها. إن له الحداثة التي يستحقُّها، حداثة الأطراف المعطوبة والمحرومة والمقهورة، أو حداثة التخلُّف المزدوج، الذي يحرمنا من معرفة تراثنا ومن معرفة الحداثة وأهمية إنجازاتها، ويربطنا بوهم الهوية وفخ الخصوصية، أي بالدور الرديء والمنبطح الذي اختاره لنا المركز.
لم يبالغ أمين حين اعتبر بأن الإسلام السياسي هو من طبيعة سياسية وليس لاهوتية، وأن هذه الحركات يتوجّب فهمها كجواب على فشل مشروع التحديث في "دول الأطراف"، لكن رفضه وصول الإسلاميّين إلى السلطة ولو عبر مسلسل ديمقراطي، يشهد على العمى الأيديولوجي الذي نجده عند جيل بأكمله، وهذا العمى يصبّ في مصلحة الديكتاتوريات التي ما برح ينتقدها باعتبارها خادمة لدى المركز الرأسمالي ومنفّذة لسياساته.
إن الحركات الشعبية والحركات التقدّمية التي يحتفي بها أمين كل مرّة، تُعبّر عن نفسها اليوم بلغة دينية، وتوجّب هنا أن ننتبه إلى مطالبها، لا أن نتوقّف، في نوع من الحساسية المَرَضية، أمام لغتها، وتوجّب أيضاً أن لا ننسى أنه لم يُسمح لها بتعلُّم لغة غيرها، أو لم يُسمح لها بترجمة لغتها إلى لغة دنيوية كما فعلت المسيحية الغربية.
ولهذا فإن حديث سمير أمين عن "فاشية إسلامية" يتوجّب الوقوف ضدها عبر دعم القوى التقدُّمية، أمرٌ يثير الأسى، فالعالم العربي لم يعرف قوىً تقدّمية، بل قوىً تسلُّطية باسم التقدُّم، وما يحدث اليوم في العالم العربي يفضح ذلك.
لقد ظلّ سمير أمين ابناً وفياً لمرحلته، ولأدلوجة التحرُّر الوطني التي فشلت على جميع المستويات، ما عدا ربما في بناء "دولة انفصالية"، كما يريدها المركز الرأسمالي، انفصلت بنفسها عن مصير الشعوب المقهورة.
لكن، لنُصغ إلى رأي أمين حتى النهاية. إنه يكتب بأنَّ الإسلام السياسي المعاصر يمثّل مشروعاً فارغاً، لأن الأمر يتعلّق بمشروع لا يتضمّن بُعداً اجتماعياً، أي ذلك البعد الضروري لتحقيق التغيير الذي يسمح بمواجهة تحديات الرأسمالية. إن الأمر يتعلّق، بالنسبة إليه، بمشروع محافظ، يرحّب به النظام العالمي للرأسمالية.
ولو تأمّلنا للحظة في السياسات غير الاجتماعية التي نفّذتها بعض الأحزاب المحسوبة على الإسلام السياسي، فلن نعترض البتّة على كلامه. أجل، ولا شك في ذلك، إن الإسلام السياسي، أو بعض تياراته حتى نكون أكثر دقّة، يُقدّم جواباً خاطئاً على تحدّيات الحداثة، لأنه جواب يتمحور حول هوية متخيّلة وليس حول أسئلة مجتمعية، ولكنه في الآن نفسه جوابٌ مشروع.
هل نحاول هنا تربيع الدائرة؟ فكيف يكون الأمر خاطئاً ومشروعاً في آن؟ ما نريد قوله هو أنَّ الإسلام السياسي في العالم العربي، الذي نعتبره مع سمير أمين، جواباً خاطئاً على تحديات الحداثة، هو من يمثّل اليوم صوت الجماعات والطبقات المسحوقة التي تمثّل أغلبية المجتمع، ورويداً رويداً، مع اتساع دائرة فشل "الدولة الانفصالية"، سيمتدّ ليعبّر عن مطالب الطبقة الوسطى أو ما تبقّى منها.
للسبب عينه، يتوجّب، بدلاً من إقامة محاكمة غير عادلة للإسلام السياسي، والتباكي على غياب المضمون الاجتماعي في مشروعه، وهو ما ليس صحيحاً دائماً، أن نُقدّم لهذا المشروع المضمون الاجتماعي الذي ينقصه، ولن يتم ذلك إلّا عبر تحريره من فخ الخصوصية، وترجمة مواقفه إلى لغة ديمقراطية. وبتعبير آخر عبر تجاوزه لنفسه. وتلك قصّة أخرى، قد تحتاج لجيل أو جيلين.