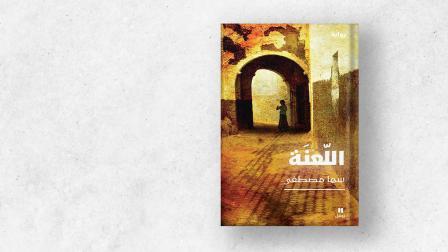على الرغم من قيمتها الفنية، بقيت تجربة الفنانة التشكيلية المصرية زينب عبد الحميد (1919-2002) في الظل، وثمة ندرة في الدراسات أو الكتابات المتاحة حول أعمالها، وتوازي هذه الندرة صعوبة الوصول إلى أعمال هذه الفنانة. وبات يخفف من هذه الصعوبة اليوم، ما تتيحه المواقع والشبكات الافتراضية، التي أصبحت تساهم في تسليط الضوء على زوايا وشخصيات كانت منسية أو مهمشة.
من خلال "فيسبوك" أرسلت لنا السيناريست علا عز الدين، ابنة الفنانة، بعضاً من لوحات والدتها التي مرّت هذا العام مئوية ولادتها؛ وذكرت عز الدين أنها طبعت كتاباً فنياً لتعريف الجيل الجديد بتجربتها.
عند الاطلاع على مقالات كُتبت عن عبد الحميد بالعربية والإنكليزية، يجد الباحث أنها كتابات تُكرر فكرة واحدة وتنسخها مرات ومرات، فرغم أنها بأقلام كتّاب عدة وفي سنوات مختلفة، إلا أن أفكارها وقراءاتها تبدو مستعارة من بعضها البعض. كأن يقال إن لوحاتها تعتمد على التسطيح (ثنائي البعد) وأن منظورها منظور عين الطائر؛ فيبرهن هذا على أن تسطيح اللوحة كان بسبب غياب الظل؛ ويرى ذاك أن منظور عين الطائر مردّه الحجوم ومساحات الكتل، وغياب التناسب في البعد في ما بينها.
 في لوحتها "صناعة المراكب في بورسعيد"، لا تظهر السماء زرقاء محكمة، بل زرقة الأسود المخففة بالأبيض، كأن اللون لظلال غيوم البحر. الأرض أيضاً من نفس اللون، ما يضع المتلقي في حيرة التساؤل أين هي الأرض من السماء، بل يبدو لوهلة أن السماء هي البحر أيضاً، فهناك إبحار لسفينة تبدو وكأنها طائرة صغيرة ملونة بأسود مخفّف. على الشاطئ يضطلع صُناع السفن على قدم وساق في صناعاتهم كي ينتهوا ويبحروا في السماء/البحر للصيد. في الجانب الأيمن المرتفع من اللوحة مقهى، ورجلان يجلسان إلى طاولة خفيضة يتبادلان الكلام، وعلى بعد ضئيل منهما يرتاح رجل مسكين يستند إلى حائط مائل قليلاً، لكنه مجرد خط؛ كل هذه التفاصيل منمنمة وغامضة.
في لوحتها "صناعة المراكب في بورسعيد"، لا تظهر السماء زرقاء محكمة، بل زرقة الأسود المخففة بالأبيض، كأن اللون لظلال غيوم البحر. الأرض أيضاً من نفس اللون، ما يضع المتلقي في حيرة التساؤل أين هي الأرض من السماء، بل يبدو لوهلة أن السماء هي البحر أيضاً، فهناك إبحار لسفينة تبدو وكأنها طائرة صغيرة ملونة بأسود مخفّف. على الشاطئ يضطلع صُناع السفن على قدم وساق في صناعاتهم كي ينتهوا ويبحروا في السماء/البحر للصيد. في الجانب الأيمن المرتفع من اللوحة مقهى، ورجلان يجلسان إلى طاولة خفيضة يتبادلان الكلام، وعلى بعد ضئيل منهما يرتاح رجل مسكين يستند إلى حائط مائل قليلاً، لكنه مجرد خط؛ كل هذه التفاصيل منمنمة وغامضة.
تطبع أقدام صنّاع السفن الرمل، تظهر خطواتهم فيه جيئة وذهاباً، ثمة رجلان مرسومان بلون باهت هو لون الأرض، كأن أحدهما ليس من اللوحة، بل قادم من مكان آخر لا ينتمي إلى صخب الصناعة والحرف الدقيقة التي انتقلت من الآباء إلى الأبناء. هناك عدة عناصر مشابهة للرجل، كما لو أنه انعكاس لفكرة أو ظلال لعناصر مستعارة من لوحة أخرى. وهذا في نظري يضيف بعداً جديداً للعمل الفني، حيث الرجل ليس في اللوحة بل قادم من المرآة، معكوساً من زجاج قريب، في تصوير لعناصر شفافة شبحية لا لون لها.
للوحة فلسفة الثقل في نظري، وليس الأبعاد المسطحة (المستوية) ولا منظور عين الطائر؛ بمعنى أن الحدث الأهم والمؤثر سيكون بحجم كبير، ملوناً بألوان صارخة، ربما صرخة الحضور وليست صرخة الرفض، أما الحدث الهامشي فسيبدو صغيراً وربما بألوان باهتة.
تزامنت المرحلة التي بدأ فيها ظهور فن عبد الحميد يظهر مع صعود الناصرية في مصر عام 1952، حيث حدث ما يشبه الثورة في الفن من سينما وموسيقى وتشكيل، واهتمت المؤسسة الرسمية بدعم الفن الشعبي والذي ينتمي إلى الثقافة المصرية والعربية ويرفض فنون الغرب، حتى أنه جرى تأسيس "المجلس الأعلى للفنون والآداب" وأدخلت لأول مرة في مصر حقيبة "وزارة الإرشاد القومي" إذ إن القومية العربية وتطلعاتها هي المفتاح لتطور شامل أصيل منبعه عربي وليس غربياً.
لكن، لم تكن "الثورة" هي التي دلّت عبد الحميد في مسارها الفنّي، بل كانت الموهبة والأصالة، والحساسية الخام غير المشوهة، والطفولة الأبدية، فتمزج الألوان وتقترب ثم تدور كي تدل على الثورة والبهجة والنصر.
هناك طاقة إيجابية في لوحاتها ووصول وإصرار وقوة وخيال باذخ فنان، لا يقول شيئاً ويقول كل شيء، لأن ما تعرضه اللوحة من لحظة اقتناص وتصوير هو غير العرض في التصوير الواقعي (في رسم عصر النهضة مثلاً) بل هي اللحظة وقد تحوّلت إلى حكاية؛ كل مقطع في اللوحة له زمن ومكان مختلفين. عدة لقطات سُكبت في اللوحة كي يمتد الزمن ويصبح دراما، ومن هنا جاء اختلاف اللون وتداخله وتغير الأشكال وأحجامها وكأن العمل كله منظور ليس من عين طائر فقط بل من عدة عيون؛ سرب من الطيور يغطي المكان ويلظم معه الزمان في أيقونة واحدة.
 اللوحة حلم، حلم يقظة المستقبل، ولهذا كي يتأقلم التفسير مع اللوحة يجب معرفة رموزها، ففي كل مرة نشاهدها أو نلقي لمحة سريعة عليها تنبثق فكرة في الخيال وتندفع ذكرى جديدة غير ذاتية، ذكرى حلم روحي يقف في مكان ما؛ ربما شبيه بذكريات الحيوات السابقة التي تبعث في الإنسان ذكرى غريبة وربما لم تحدث له في الماضي، بل ستحدث معه في المستقبل، تحمل دلالة الحدوث والتحقق. ومن هنا يتضح أن اللوحة التي ترسمها زينب عبد الحميد هي لوحة رؤيا (الحاضر) وليست إشعارات وانفعالات نفسية.
اللوحة حلم، حلم يقظة المستقبل، ولهذا كي يتأقلم التفسير مع اللوحة يجب معرفة رموزها، ففي كل مرة نشاهدها أو نلقي لمحة سريعة عليها تنبثق فكرة في الخيال وتندفع ذكرى جديدة غير ذاتية، ذكرى حلم روحي يقف في مكان ما؛ ربما شبيه بذكريات الحيوات السابقة التي تبعث في الإنسان ذكرى غريبة وربما لم تحدث له في الماضي، بل ستحدث معه في المستقبل، تحمل دلالة الحدوث والتحقق. ومن هنا يتضح أن اللوحة التي ترسمها زينب عبد الحميد هي لوحة رؤيا (الحاضر) وليست إشعارات وانفعالات نفسية.
هذه الطريقة الشرقية التي تطورت عن فن المنمنمات وازدهرت في الحضارة الإسلامية ولا سيما في المرحلة العباسية وكان لها جذور قديمة في بابل، تفتح باباً واسعاً أمام الفنانين والكتّاب العرب، إذ تخلط أوراق الزمان والمكان لتقول أكثر مما تسمح به مساحة اللوحة، إلا أن الفكرة واضحة: صناعة السفن في هذه اللوحة، وعوامات النيل، وفي لوحة أخرى حيّ شعبي، تنقل أكثر من مشهد ومن موقف.
ما يجري في العالم العربي اليوم وكل يوم خلال القرن الحالي والفائت محرّض بالنسبة إلى هذا النوع من التشكيل، ومعنى وجود إضافي للفن، ومن خلاله ربما يقام مرفأ آخر للسفن التي تبحر سريعاً بين أمواج الشرق العاتية. في هذا النوع من مدرسة الرسم قدرة أكبر على التعبير، وثمة مساحات واسعة تنتظر من يملأها، إنه أداة جديدة في يد المبدع كي يقول للعالم الحقيقة ويتواصل مع الوجدان والقلب.
* كاتب سوري مقيم في الولايات المتحدة