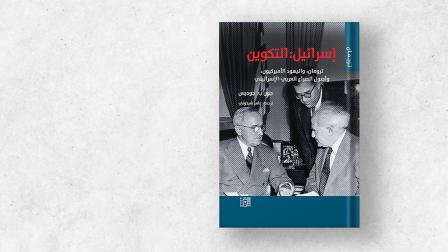يعود تاريخ الرواية الجزائرية، بحسب الباحثين، إلى القرن الثاني من الميلاد، من خلال رواية "الحمار الذّهبي" لـ لوكيوس أبوليوس، ابن حاضرة مداوروش في أقصى الشّرق الجزائري، فيما يرى آخرون أن الرواية كتبت باللّغة الرّومانية، وكان تأثيرها في السّياق الرّوماني لا في السّياق الجزائري، لذلك فهي محسوبة على التراث الأدبي لروما، ولا تعني الجزائريين إلا من حيث أنها تراث إنساني.
شمل هذا الاختلاف أيضاً رواية " تحفة العشّاق"، التي كتبها محمّد بن إبراهيم عام 1845، سابقةً على رواية "زينب" للمصري محمد حسين هيكل عام 1914. ووجه الاختلاف أن الكاتب ذو أصول تركية من جهة، ومن جهة ثانية فهي لم تظهر إلا عام 1977 على يد المحقّق والباحث في التاريخ الثقافي الجزائري، أبي القاسم سعد الله، وهي، بهذا التأخّر في الظهور، لم تحفر في الوعي السّردي لأجيال الرّواية الجزائرية.
من هنا، فإن العتبات الأولى الجديرة بأن يبنى عليها التأريخ للتجربة الروائية الجزائرية، تبدأ مع عشرينيات القرن العشرين، من خلال رواية "أحمد بن مصطفى، غومييه" لمحمد بن سي أحمد بن شريف التي صدرت عام 1920، ورواية "مريم بين النّخيل" لمحمّد ولد الشيخ عام 1936، وصولاً إلى "الدّار الكبيرة" لمحمّد ديب في 1952، ورواية "نجمة" لكاتب ياسين عام 1956. وكلّهم كتّاب بالّلغة الفرنسية، ذلك أن أول رواية جزائرية كتبت بالّلغة العربية هي "ريح الجنوب" التي صدرت عام 1970 لـ عبد الحميد بن هدوقة (1925-1996)، لتتبعها تجارب أخرى أهمها تجربة الطاهر وطّار (1927-1978).
مع بداية سبعينيات القرن العشرين إذاً، بدأت ازدواجية الّلغة داخل المدوّنة الروائية الجزائرية، بكلّ ما تمخّض عن ذلك من تجاذبات فرضتها الأيديولوجيا، وأدّت بروائي له تأثير عميق في الرّوائيين المفرنسين والمعرّبين معاً هو مالك حدّاد (1927-1978) إلى أن يترك الكتابة أصلاً، بحجّة أنه لم يعد يملك مبرّراً للمواصلة بالكتابة بغير لغته الأم، بل إننا نجد هذه الازدواجية اللغوية لدى الكاتب الواحد نفسه، مثل رشيد بوجدرة وواسيني الأعرج وأمين الزّاوي ومحمّد ساري.
رغم ذلك ظلّ الذوق الجزائري العام شعرياً، ومانحاً "سلطة" أكبر للشّعراء بالمقارنة مع الرّوائيين، حتى تسعينيات القرن العشرين، حيث استطاعت الرّواية أن تزحزح الشّعر، وتتفوّق عليه في الحضور، من خلال انخراطها في تفاصيل تجربة العنف والإرهاب، التي عاشها الجزائريون، ليس بوصفها أداةً جمالية فقط، بل بوصفها أداة مقاومةٍ أيضاً. وهو ما أدّى إلى ظهور مصطلح "الأدب الاستعجالي"، في إشارة إلى الفقر الجمالي الذي وسم الكثير من الرّوايات، التي ظهرت في هذه المرحلة وتناولتها في الوقت عينه.
ظهرت هذه النّزعة الشعرية في الذّوق الجزائري العام من جديد، داخل المتون الرّوائية نفسها، مثال على ذلك ثلاثية أحلام مستغانمي، ونزوح قطاع واسع من الشعراء الجزائريين نحو الكتابة الرّوائية؛ ظاهرة لا يمكن إعفاؤها من "شعرنة" المدوّنة السردية الجزائرية الجديدة، على نحو يفوق ما تقتضيه الدّواعي الفنية.
من المعروف في الجزائر، أن تقسيم أجيال الرّواية يعتمد معيار العشريات، فيقال جيل السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. وقد تمّ إطلاق أحكام، على كلّ جيل، باتت في حكم المسلّمات، بعضها واقعي وبعضها متعسّف، على الأقل في حقّ بعض التجارب، التي كانت تكتب خارج التّصنيف.
يسمّي علماء الطبيعة الأنهار الشغّالة تحت الأرض بالأنهار العمياء. وهي في العادة لا تعلن عن نفسها إلا عند مصبّاتها. فهل هناك أنهار عمياء في حقل الكتابة؟ نقلت "العربي الجديد" هذا السّؤال إلى الرّوائي الخيّر شوّار (1969) فقال إنه اشتغل في الصّحافة الأدبية منذ عشرين عاماً، وعاش داخل الوسط الأدبي أكثر ممّا عاش داخل وسطه العائلي، وكان يعتقد أنه من أكثر العارفين بملامح المشهد الأدبي في الجزائر، "لكنّني وجدت نفسي، خلال الدورتين السّابقتين من معرض الكتاب، جاهلاً بعشرات الأسماء التي ظهرت فجأةً، دون أية مقدّمات، علماً بأنها هي نفسها لا تعرفني".
هناك عرفت، يقول صاحب رواية "حروف الضّباب"، أن هناك قطيعة شبه جذرية بيننا نحن أجيال ما قبل " فيسبوك"، وجيل ما بعده. يشرح فكرته: "لطالما تعاملت المنظومات المختلفة في الجزائر، منها المنظومة الأدبية، مع مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها مجرّد نسخ متطوّرة من الألعاب التقليدية، وغفلت عن دورها في التّأسيس لمفاهيم جديدة تؤدّي بالضرورة إلى رؤىً وتناولاتٍ جديدة. وهذا ما حصل بالضّبط في المشهد الرّوائي الجزائري".
بدوره، يقول صاحب دار "الجزائر تقرأ" قادة زاوي إن "فيسبوك" كسر المفهوم القديم للتواصل بين الكاتب والناشر، فلم يعد بحاجة إلى وساطة من غيره، علماً بأن الوساطة، التي كان يقوم بها قطاع واسع من الأسماء المكرّسة لم تكن نزيهة، وهو ما عتّم، بحسبه، على تجارب حقيقية وأضاء تجارب مغشوشة، "فأدهشني أنني وقفت على عشرات الرّوايات لأسماء جزائرية لم تتجاوز عقدها الثاني، نشرت في دور نشر عربية بعضها ذو سمعة عالية، بسبب تواصلها المباشر مع أصحاب هذه الدّور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بهذا كسرت الحصار المفروض عليها في الدّاخل".
من هنا، قام الناشر الشابّ، بتأسيس دار نشر هدفها الاستثمار في هذا الجيل الجديد، و"اعتماد طرق غير كلاسيكية في تسويق نصوصه، انسجاماً مع طبيعته، بصفته خرّيج مرحلة ما بعد الأبوية والوصاية"، مضيفاً "كان جيل التسعينيات من الكتّاب يوصف بأنه جيل اليتم لقلّة المنابر المحتفية بنصوصه، لكن معظم وجوهه كانت معروفة إعلامياً، فكيف يُسمّى جيل موجود فعلاً، لكن معظم تجاربه ووجوهه غير مرصودة أصلاً؟".
ويشير محدّث " العربي الجديد" إلى دهشته من التبرّم، الذي أبداه كتّاب وإعلاميون من موجة الكتّاب الجدد، بحجّة أنها تساهم في تمييع مفهوم الكتابة. يقول: "ما معنى أن يرفض مثقف ما الوصاية السّياسية، ويُمارس هو نفسه الوصاية الأدبية؟ أتفهم أن ينتقد كلّ حالة على حدة، انطلاقاً من قراءة نصّها، لكنني لا أتفهم الحكم على الجميع بالرّداءة، قبل قراءة النّصوص أصلاً".
اقترب "العربي الجديد" من نخبة من هذه الأسماء الجديدة، لرصد هواجسها وأسئلتها وردود فعلها نحو ما قيل ضدّ ظهورها المفاجئ، حتى أن بعضهم استعمل مصطلح "أدباء الصّدفة" في وصفها، فلمس لديها ثقة واضحة بنفسها وبمشروعها الرّوائي وبحقها في الوجود.
يقول عمر بن شريّط (1999) الذي أصدر رواية بوليسية عنوانها "الجريمة البيضاء"، إن الذين ينتخبون مترشّحاً سياسياً من غير أن يُعاينوا برنامجه، فقط لأنه ابن القبيلة، هم أنفسهم الذين يحكمون على كاتب جديد بالرّداءة والسّطحية من غير أن يطّلعوا على نصّه: "من كان صادقاً في حبّه للأدب، فليحتكم إلى النصّ بعيداً عن مراعاة سنّي، فلست منزّهاً عن النقد، بل إن نضجي مرتبط به، ومن كان مفخخاً بنوايا غير أدبية، فليضرب رأسه بالجدار، من غير أن ينسى أن هناك نوعين من الجدران الآن، واقعي وافتراضي".
وبرّر عمر شريّط توجّهه إلى الرّواية البوليسية بكونه انسجم مع جيله الميّال إلى روح المغامرة وفكّ خيوط الجريمة. يقول: "الذين عاشوا ثورة التحرير كتبوا رواية تاريخية، وكتب الذين عاشوا مرحلة الإرهاب رواية متماشية مع مناخاتها. ومن حقي أن أكتب رواية أجد أن لدي الخبرة الكافية لكتابتها".
يشرح فكرته: "أنا من جيل ما بعد الهاتف الثّابت. أتحكّم في كل الآلات عن بعد، وفتحت عيني على عبارة (كلمة السّر) في الإيميل وفيسبوك، ولم يحدث أن أرسلت رسالة ورقية مستعملاً بصاقي لغلقها، كما أشاهد جديد أفلام هوليود مقرصنة بنصف دولار أمريكي". يختم: "لم أبلغ العشرين بعد، لكني أملك النضج، الذي يجعلي أفهم أنها حساسية جيل تربّى على (سنان)، من جيل تربّى على (بوكيمون)".
هاجس الهوية
ساهمت عوامل موضوعية، منها الجوائز العربية والفرنسية - آخرها كان في "جائزة كتارا"، والتي حازها سعيد خطيبي وعبد الوهاب عيساوي مؤخراً، وناصر سالمي العام الماضي- إلى جانب زيادة اهتمام الناشر الأجنبي بالرواية الجزائرية، في ظهور أسماء جديدة بات لها حضورها مثل كمال داود وسمير قسيمي وهاجر قويدري؛ وهم وإن ابتعدوا عن المقولات الأيديولوجية والوطنية المباشرة فإن هاجس أعمالهم هو سؤال الهوية.