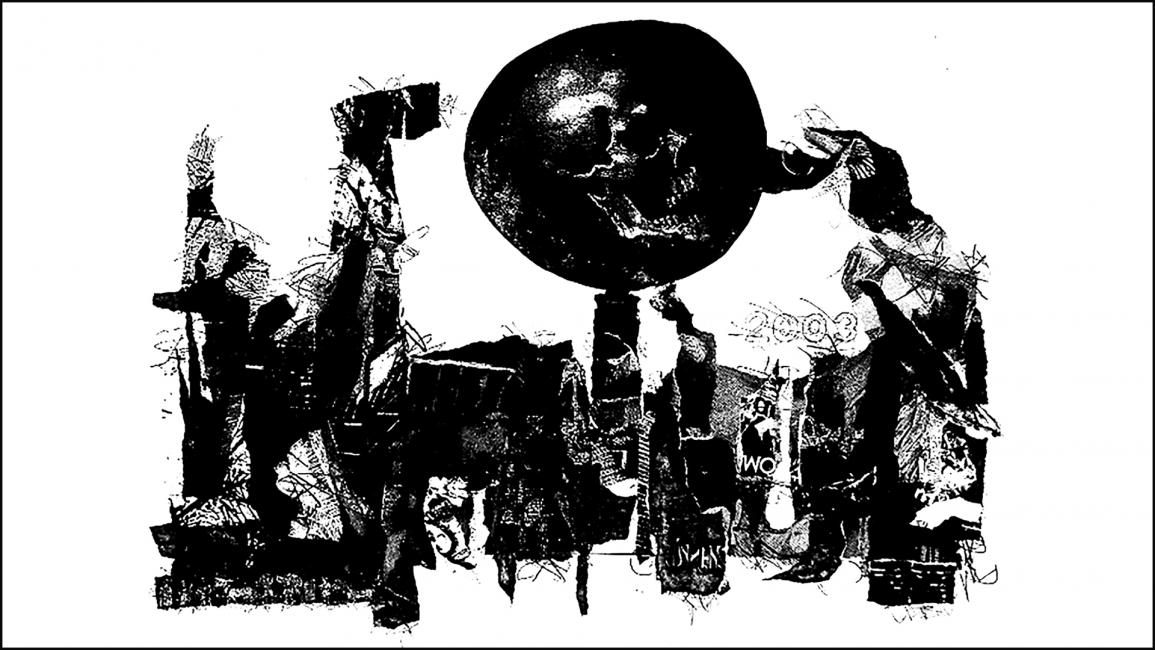28 يناير 2024
بنطال بلا رقعة
اعتاد أن يتحسس الرقعة على مؤخرة بنطاله، كل صباح، قبل أن يخرج إلى عمله الجديد الذي حظي به، أخيراً، عامل مقهى في شركة. والحال أن هذه العادة لم تكن وليدة المصادفة، بل أصبحت لازمة في حياته، منذ كان جامع خردوات و"أنتيكات"، وقطع بلاستيك من مخلفات الشوارع. وليس من مبالغة في القول إنه لم يعد محتاجاً لعينيه اللتين أغلقهما فعلياً منذ أصبح العالم ضئيلاً فيهما، لا يتجاوز حدود الخردوات التي يجمعها، والشوارع التي يعبرها.
أما كيف غدا يرى العالم ويحكم على الناس والحوادث المحيطة به، فتلك "رقعة" أخرى، تستوجب التفصيل:
يستيقظ صباحاً، ويرتدي بنطاله على عجل، ثم يتحسس الرقعة إياها، وكأنه يطمئن على موقع قدميه في هذا العالم المهتز، وما إن تقع أصابعه على الرقعة، حتى يضيء دماغه، فيفتح المذياع ويقلب المحطات الإخبارية، واحدة تلو الأخرى، وكلما مر خبر يحتاج إلى تحليل ذهني، سرعان ما يتحسس الرقعة ليصل إلى استنتاج يطمئن إليه.
مثلاً، إذا ورد خبر عن أي مرسوم حكومي جديد، يتحسس الرقعة، ليستنتج حجم "الكارثة" المقبلة، وإذا سمع عن نشاط جديد لـ"الزعيم"، يتحسس الرقعة أيضاً، لعله يستنتج ماذا "يطبخ تجار الشام على نار جهنم"، على حد تعبير شاعره المفضل مظفر النواب الذي يحس أنه خير من يحكم على هذا العالم "المرقّع"، وكثيراً ما كان يردد عبارة النواب: "رقعة الشباك كم تشبه جوعي". ثم تطور الأمر مع "صاحب الرقعة"، فصار يتحسس رقعته، وهو يتجول في الشوارع في أثناء عمله، خصوصاً حين يجد نفسه مضطراً للحكم على البشر، فإذا رأى مسؤولاً حكومياً، يتحسس الرقعة، وإذا شاهد صور الزعيم المعلقة على الحوائط، يكرر الفعلة. وكذلك الأمر إذا سمع نشيد تلاميذ المدارس الصباحي: "موطني.. موطني"، وفي النتيجة، تطمئن نفسه، ويشعر أن في وسعه التعايش مع ركام الزيف الذي يحاصره.
باختصار؛ توصل إلى قناعة مفادها أن الفقراء والمهمشين لا يستطيعون التآلف مع العالم، إلا إذا رأوه بمؤخراتهم، لا بعيونهم.
غير أن هذه الطمأنينة تبددت في ذلك الصباح الكانونيّ البارد، حين استدعاه مديره في عمله الجديد، ليهدي إليه بذلة سموكن فاخرة، طالباً منه أن يرتديها في اليوم التالي، بمناسبة الزيارة التي يزمع "الزعيم" القيام بها إلى مقر الشركة، وكأن المدير يودّ أن يقول له، على نحو غير مباشر: "المهم أن تتخلص من هذه الرقعة أمام الزعيم"، من دون أن يدري المدير أن موظفه هذا، حصراً، لا يستطيع أن يرى الزعيم إلا من خلال هذه الرقعة، وليس من المبالغة القول إن الوطن كله غدا في عينيه "رقعة" تاريخية، لا جغرافية.
دارت الدنيا بعينيه، وهو يتأمل تلك البذلة، وتلعثم لسانه، لأنه كان يود أن يعرف المدير ما تعنيه له تلك الرقعة التي يريد تخليصه منها، لكنه وجد نفسه ضعيفاً، لا يقوى على الكلام، فما كان منه إلا أن حمل البذلة بكلتا يديه الممدودتين للأمام، حرصاً على أن لا ينثني أي جزء منها. وفي المقابل، كان يشعر بغبطة داخلية، خصوصاً، أنه (كرّم الله جسده) لم يرتد طوال حياته أي بذلة، وراح يحلم بذلك الشعور الذي سينتابه، حين يحظى بهذه التجربة الفريدة.
حمل البذلة بارتباك، وراح يمشي كالسلحفاة، متجنباً الأماكن المزدحمة، بل وآثر أن يلف نصف المدينة على قدميه، سالكاً الشوارع الخالية، حتى وصل إلى بيته، حفاظاً على هذه الهدية التي أربكت حياته.
في المساء، مدّد البذلة على سريره، حيث ينام، فيما افترش هو الأرض ونام بعين واحدة، وظلت الأخرى معلقة بالبذلة، تحرسها من وحوش الظلام.
استيقظ متعباً بسبب القلق، واتجه مباشرة إلى البذلة، وارتداها بحرص بالغ، وبعد أن تهيأ تماماً، راحت يده، من دون وعي، تتحسس مؤخرته بحثاً عن الرقعة، وحين لم يجدها شعر بفراغ مفاجئ في رأسه، وغبش لم يعهده في عينيه، والأنكى أنه لم يعد يعرف ما يدور حوله.
لم يستغرق الأمر طويلاً عقب خروجه من بيته، حتى شوهد وهو يسير زائغ النظرات، أبله الملامح، وحوله رهط من الأطفال يهتفون: رجل أعمى.. رجل أعمى.
يستيقظ صباحاً، ويرتدي بنطاله على عجل، ثم يتحسس الرقعة إياها، وكأنه يطمئن على موقع قدميه في هذا العالم المهتز، وما إن تقع أصابعه على الرقعة، حتى يضيء دماغه، فيفتح المذياع ويقلب المحطات الإخبارية، واحدة تلو الأخرى، وكلما مر خبر يحتاج إلى تحليل ذهني، سرعان ما يتحسس الرقعة ليصل إلى استنتاج يطمئن إليه.
مثلاً، إذا ورد خبر عن أي مرسوم حكومي جديد، يتحسس الرقعة، ليستنتج حجم "الكارثة" المقبلة، وإذا سمع عن نشاط جديد لـ"الزعيم"، يتحسس الرقعة أيضاً، لعله يستنتج ماذا "يطبخ تجار الشام على نار جهنم"، على حد تعبير شاعره المفضل مظفر النواب الذي يحس أنه خير من يحكم على هذا العالم "المرقّع"، وكثيراً ما كان يردد عبارة النواب: "رقعة الشباك كم تشبه جوعي". ثم تطور الأمر مع "صاحب الرقعة"، فصار يتحسس رقعته، وهو يتجول في الشوارع في أثناء عمله، خصوصاً حين يجد نفسه مضطراً للحكم على البشر، فإذا رأى مسؤولاً حكومياً، يتحسس الرقعة، وإذا شاهد صور الزعيم المعلقة على الحوائط، يكرر الفعلة. وكذلك الأمر إذا سمع نشيد تلاميذ المدارس الصباحي: "موطني.. موطني"، وفي النتيجة، تطمئن نفسه، ويشعر أن في وسعه التعايش مع ركام الزيف الذي يحاصره.
باختصار؛ توصل إلى قناعة مفادها أن الفقراء والمهمشين لا يستطيعون التآلف مع العالم، إلا إذا رأوه بمؤخراتهم، لا بعيونهم.
غير أن هذه الطمأنينة تبددت في ذلك الصباح الكانونيّ البارد، حين استدعاه مديره في عمله الجديد، ليهدي إليه بذلة سموكن فاخرة، طالباً منه أن يرتديها في اليوم التالي، بمناسبة الزيارة التي يزمع "الزعيم" القيام بها إلى مقر الشركة، وكأن المدير يودّ أن يقول له، على نحو غير مباشر: "المهم أن تتخلص من هذه الرقعة أمام الزعيم"، من دون أن يدري المدير أن موظفه هذا، حصراً، لا يستطيع أن يرى الزعيم إلا من خلال هذه الرقعة، وليس من المبالغة القول إن الوطن كله غدا في عينيه "رقعة" تاريخية، لا جغرافية.
دارت الدنيا بعينيه، وهو يتأمل تلك البذلة، وتلعثم لسانه، لأنه كان يود أن يعرف المدير ما تعنيه له تلك الرقعة التي يريد تخليصه منها، لكنه وجد نفسه ضعيفاً، لا يقوى على الكلام، فما كان منه إلا أن حمل البذلة بكلتا يديه الممدودتين للأمام، حرصاً على أن لا ينثني أي جزء منها. وفي المقابل، كان يشعر بغبطة داخلية، خصوصاً، أنه (كرّم الله جسده) لم يرتد طوال حياته أي بذلة، وراح يحلم بذلك الشعور الذي سينتابه، حين يحظى بهذه التجربة الفريدة.
حمل البذلة بارتباك، وراح يمشي كالسلحفاة، متجنباً الأماكن المزدحمة، بل وآثر أن يلف نصف المدينة على قدميه، سالكاً الشوارع الخالية، حتى وصل إلى بيته، حفاظاً على هذه الهدية التي أربكت حياته.
في المساء، مدّد البذلة على سريره، حيث ينام، فيما افترش هو الأرض ونام بعين واحدة، وظلت الأخرى معلقة بالبذلة، تحرسها من وحوش الظلام.
استيقظ متعباً بسبب القلق، واتجه مباشرة إلى البذلة، وارتداها بحرص بالغ، وبعد أن تهيأ تماماً، راحت يده، من دون وعي، تتحسس مؤخرته بحثاً عن الرقعة، وحين لم يجدها شعر بفراغ مفاجئ في رأسه، وغبش لم يعهده في عينيه، والأنكى أنه لم يعد يعرف ما يدور حوله.
لم يستغرق الأمر طويلاً عقب خروجه من بيته، حتى شوهد وهو يسير زائغ النظرات، أبله الملامح، وحوله رهط من الأطفال يهتفون: رجل أعمى.. رجل أعمى.