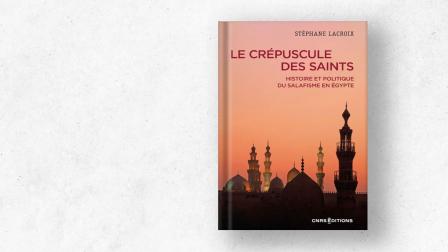حدّثني عن "أوّل كتاب" هزّك هزّاً، سألتني. ماذا أختار؟ روايةٌ مترجمة للعربية وجدتُها وأنا في الرابعة عشرة، في محل بائع كتب مفروشة في ضواحي عدَن، لم أنس اسمه البديع: الحاج السماوي، رغم وفاته بعد ذلك بقليل. لم أنس ابتسامته الدائمة أيضاً، وغمزتهُ الشهيرة بعد اقتناء أي كتاب. كان يسمح لنا بالاقتناء دَيناً ولا يُذكِّر أحداً بدَينهِ إن لم يتذكره هو نفسه.
أتذكّر روايةً ممزّقة الغلاف، لم أر حتّى اسم كاتبها. لعلّ عنوانها: "ذلك الشتاء الطويل"، لكني لستُ متأكداً جدّاً. كلّ ما تبقى في ذاكرتي منها هو أن يومياتها تدور، من غلافها إلى غلافها، في صقيعِ بلدٍ قطبي. وأنها استحوذتني حينها بجنون. جعلتني أرتجف من البرد في قيضِ عدَن، وما زلتُ أرتجفُ منه حال تذكُّرِها اليوم، حتى وإن كنتُ في معمعان صيفٍ استوائيٍّ قاتل.
لأترك كلّ ذلك جانباً، وأحكي قصّة أوّل كتابٍ فكري نصحني به الحاج السماوي، وغيّرَ مجرى حياتي، بالفعل. لعلّه هو من فتح لي أبواب الطيران بأجنحة: "أصول الفلسفة الماركسية"، للفيلسوف الفرنسي بوليتزر، الذي لخّص فيه كل أسس الماركسية على شكل دروسٍ مبسّطة ولذيذةٍ جداً، بلغة تربويةٍ سهلة، ممتلئةٍ بالأمثلة الحيّة، موجّهةٍ للخلايا العمالية الشيوعية في الخمسينات من القرن الماضي، في عزِّ أيّام الستالينية.
كنت في سنة الصحوة الكبرى؛ الرابعة عشرة. قرأتهُ مخبولاً حينذاك، أبهرني وأسرني أسراً. قرأتهُ قراءةً دينية، قبلتُ كلَّ ما يقوله كمؤمنٍ كليٍّ يصغي لكتابٍ سماوي. ثم طلّقتهُ مع مرّ السنين: رميت كل أفكاره الستالينية، وتحريضه على التغيير الثوري بالنار والحديد، بحجّة أنه كي يتحوّل الماء إلى بخار، يلزم ارتفاع درجة النار أسفله حتّى تصل إلى الدرجة المائة.
طلّقته لأني لو كنتُ ماءً لما أحببتُ التحوّلَ إلى بخارٍ تحت النار. أكره النار. كنت سأفضِّل التحوّل إلى بخارٍ تحت أشعة الشمس، في الهواء الطلق، مثل مياه البحار. تحوّلتْ علاقتي بالثورة كعلاقة الشمس بالبحر.
أو لعلّي أتحدّثُ عن كتاب علميٍّ مترجمٍ للعربية، وجدته في مفرش الحاج السماوي (أدخله الله فسيح جنّاته)
أمتلأ الكتاب بشرح تجارب كيماوية وفيزيائية بسيطة يمكن لأي طالبٍ صغير مثلي حينها إجراؤها في بيته، وإن عاش في ضاحيةٍ فقيرة من ضواحي مدن عالمنا الثالث الفسيح، شريطة أن تكون له علاقة طيبة بصاحب "كاراج" سيارات يعثر منه على بقايا بطاريةِ سيارةٍ نصف خاربة، أو قنينة من حمض الكبريتيك المركّز.
كان ذلك حالي وحال صديق عزيز ألمعيٍّ جدّاً: جمال. اتجهنا نحو صاحب الكاراج للعثور على البطارية. لم ينقصنا بعد ذلك، إلا إناءُ ماءٍ بسيط يُشبِه إناء تجربة الكتاب، وبالونتان بلاستيكيتان فارغتان نربطهما بطرفي السلك الكهربائي الذي يلمس الإناء في طرفيه، ويمرّ عبره تيار البطارية الذي يحلِّلُ الماء إلى غازين.
كان ذهولنا لا حدّ له ونحن نرى البالونتين تنتفخان فعلاً رويداً رويداً، تمتلئ إحداهما بالأوكسجين والأخرى بالهيدروجين، كما تشرح التجربة تماماً؛ ثمّ ونحن نتحقّق من ذلك بأم أعيننا: غاز الهيدروجين أخفّ من الهواء، لذلك تطير بالونته عموديّاً نحو السقف وتلتصق به عدّة أيام، قبل أن يتسرّب منها الغاز وتذبل.واصلنا التجربةَ وقتاً طويلاً لنملأ عشرات البالونات، ولنحدّق في قطيع بالونات الهيدروجين وهو يعانق السقف، أو في قطيعٍ كنّا نرميه في وسط الشارع، يصعدُ عموديّاً نحو السماء، حيث تحلِّقُ روح الحاج السماوي.
تغيّرتْ حياةُ جمال وحياتي بعد تلك التجربة. لأتحدَّثَ هنا عن جمال فقط: توطّدت علاقتهُ بأصحاب الكاراجات في عدن. صار يقضي معظم وقتهِ يساعدهم مجّاناً، يتعلّم منهم، ويستفيد من خبرتهم لِمعرفة كلِّ أنواع وأسرار البطاريات الكهربائية، تركيبِ وآليةِ عمل الموتورات، كيفيةِ تشغيل المحوِّلات التي تحوِّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية وحركة.
السبب: تفجّرت فيه رغبة عارمة لِصناعة طائرةٍ كهربائية صغيرة تصعد ولو بضعة أمتار في قلب شارعنا الصغير بعدَن: شارع يافا.
ارتبط جمال بعلاقة وثيقةٍ جدّاً بصاحب كاراج، كان له منزلٌ صغير في طرف شارعنا، يواصل أمامهُ مساءً علاج السيارات العاطلة بضوءِ فانوسٍ زيتيٍّ جبّار، تحت سمائنا الليلية الساحرة.
كان جمالُ يقضي بمعيّتهِ بضعة ساعات كلّ مساء ينحتُ الصفائح التي يجدها هنا وهناك، يُسوِّي قضبان الحديد، يُلحِّمها لِصناعة جسدِ طائرته الذي لم يتجاوز المتر والنصف طولاً، يصيغُ مراوحَها بانعطافٍ لولبي يتوسّطه ثقبٌ يرتبط بموتورٍ صغيرٍ، يُلحِّم الجناحين، يُجهّز قلبَ طائرته النابض: البطارية - التي كانت تقلّه أكثر ما تقلقه، ولزمته تجارب كثيرة لاختيارها- والموتور الصغير والمحوّل.
أسابيع من العمل الليلي القلق، ببدلةٍ زرقاء موشّحةٍ بالسواد، أمام أعين أولاد شارعنا الذين كانوا يرون الطائرة تنمو يوميّاً، تتعانقُ فيها الصفائح والأسلاك والعجلات المطاطية. إعجابٌ جماعيٌّ أشعلَ نرجسيّة جمال، التي تفتّقت منذ أن أمتلأت سماء شارعنا ببالونات الهيدروجين.
لم يكن أحدٌ مع ذلك واثقاً أن طائرة جمال ستطير ولو متراً واحداً، بمن فيهم أنا، صديقه الأثير. ولم يكن لِجمال من هدفٍ غير ذلك.
وضعها ذات مساء في الأرض "المسفلتة" في وسط صفّي البيوت المتوازية لشارعنا، كي تطير بشكلٍ موازٍ لهما. ثمّ ماذا بعد، إذا ما طارت فعلاً؟ ستنفذ طاقتها سريعاً، وستسقط بالتأكيد على الأرض، ستنكسر. عمل أسابيع طويلة ستطويه الرياح.
لا يهمّ جمالَ ذلك. يكفي أن تطير باتجاه السماء ولو قليلاً، باتجاه الحاج السماوي.
ثمّ ذات ليلةٍ ليلاء التفّ كل شباب شوارعنا حول جمال الذي قاد طائرته الصغيرة بفخر وقلق إلى قلب الشارع. محاولاتٌ عديدة قبل أن نلاحظ دوران مراوحها فعلاً، تقدّم عجلاتها الصغيرة رويداً رويداً، على إيقاع هيجان وفرحات أولاد الشارع، وزغردات نساءٍ في شرفات منازل. انتظار، عثرات، فشل.
ثمّ انطلقت، نعم انطلقت بشكلٍ مفاجئٍ سريع، بلمحة بصر: متر، متران، ثلاثة، أكثر قليلاً.
لم نلاحظ كيف مرّ ذلك، قبل أن نشعر أنها انحرفت عن المسار الذي توقَّعهُ موازياً لصفّي بيوت شارعنا، كي تسقطَ بعد ذلك في وسط الشارع، كما كان يفترض. لماذا انحرفت وأخذت مساراً قوسيّاً مفاجئاً؟ لا أحد يعرف.
ارتطمت بجدران الدور الأوّل من عمارةٍ مجاورة. تهشّمتْ واندلعَ منها بعض نارٍ ودخان. لا يهمّ، كان جمال سعيداً، كنا سعداء. عناقٌ جماعي وسط الشارع. في أعلاه، لمحنا غمزةً سعيدةً للحاج السماوي الذي أسرى بنا إلى السماء.
أتذكّر روايةً ممزّقة الغلاف، لم أر حتّى اسم كاتبها. لعلّ عنوانها: "ذلك الشتاء الطويل"، لكني لستُ متأكداً جدّاً. كلّ ما تبقى في ذاكرتي منها هو أن يومياتها تدور، من غلافها إلى غلافها، في صقيعِ بلدٍ قطبي. وأنها استحوذتني حينها بجنون. جعلتني أرتجف من البرد في قيضِ عدَن، وما زلتُ أرتجفُ منه حال تذكُّرِها اليوم، حتى وإن كنتُ في معمعان صيفٍ استوائيٍّ قاتل.
لأترك كلّ ذلك جانباً، وأحكي قصّة أوّل كتابٍ فكري نصحني به الحاج السماوي، وغيّرَ مجرى حياتي، بالفعل. لعلّه هو من فتح لي أبواب الطيران بأجنحة: "أصول الفلسفة الماركسية"، للفيلسوف الفرنسي بوليتزر، الذي لخّص فيه كل أسس الماركسية على شكل دروسٍ مبسّطة ولذيذةٍ جداً، بلغة تربويةٍ سهلة، ممتلئةٍ بالأمثلة الحيّة، موجّهةٍ للخلايا العمالية الشيوعية في الخمسينات من القرن الماضي، في عزِّ أيّام الستالينية.
كنت في سنة الصحوة الكبرى؛ الرابعة عشرة. قرأتهُ مخبولاً حينذاك، أبهرني وأسرني أسراً. قرأتهُ قراءةً دينية، قبلتُ كلَّ ما يقوله كمؤمنٍ كليٍّ يصغي لكتابٍ سماوي. ثم طلّقتهُ مع مرّ السنين: رميت كل أفكاره الستالينية، وتحريضه على التغيير الثوري بالنار والحديد، بحجّة أنه كي يتحوّل الماء إلى بخار، يلزم ارتفاع درجة النار أسفله حتّى تصل إلى الدرجة المائة.
طلّقته لأني لو كنتُ ماءً لما أحببتُ التحوّلَ إلى بخارٍ تحت النار. أكره النار. كنت سأفضِّل التحوّل إلى بخارٍ تحت أشعة الشمس، في الهواء الطلق، مثل مياه البحار. تحوّلتْ علاقتي بالثورة كعلاقة الشمس بالبحر.
أو لعلّي أتحدّثُ عن كتاب علميٍّ مترجمٍ للعربية، وجدته في مفرش الحاج السماوي (أدخله الله فسيح جنّاته)
أمتلأ الكتاب بشرح تجارب كيماوية وفيزيائية بسيطة يمكن لأي طالبٍ صغير مثلي حينها إجراؤها في بيته، وإن عاش في ضاحيةٍ فقيرة من ضواحي مدن عالمنا الثالث الفسيح، شريطة أن تكون له علاقة طيبة بصاحب "كاراج" سيارات يعثر منه على بقايا بطاريةِ سيارةٍ نصف خاربة، أو قنينة من حمض الكبريتيك المركّز.
كان ذلك حالي وحال صديق عزيز ألمعيٍّ جدّاً: جمال. اتجهنا نحو صاحب الكاراج للعثور على البطارية. لم ينقصنا بعد ذلك، إلا إناءُ ماءٍ بسيط يُشبِه إناء تجربة الكتاب، وبالونتان بلاستيكيتان فارغتان نربطهما بطرفي السلك الكهربائي الذي يلمس الإناء في طرفيه، ويمرّ عبره تيار البطارية الذي يحلِّلُ الماء إلى غازين.
كان ذهولنا لا حدّ له ونحن نرى البالونتين تنتفخان فعلاً رويداً رويداً، تمتلئ إحداهما بالأوكسجين والأخرى بالهيدروجين، كما تشرح التجربة تماماً؛ ثمّ ونحن نتحقّق من ذلك بأم أعيننا: غاز الهيدروجين أخفّ من الهواء، لذلك تطير بالونته عموديّاً نحو السقف وتلتصق به عدّة أيام، قبل أن يتسرّب منها الغاز وتذبل.واصلنا التجربةَ وقتاً طويلاً لنملأ عشرات البالونات، ولنحدّق في قطيع بالونات الهيدروجين وهو يعانق السقف، أو في قطيعٍ كنّا نرميه في وسط الشارع، يصعدُ عموديّاً نحو السماء، حيث تحلِّقُ روح الحاج السماوي.
تغيّرتْ حياةُ جمال وحياتي بعد تلك التجربة. لأتحدَّثَ هنا عن جمال فقط: توطّدت علاقتهُ بأصحاب الكاراجات في عدن. صار يقضي معظم وقتهِ يساعدهم مجّاناً، يتعلّم منهم، ويستفيد من خبرتهم لِمعرفة كلِّ أنواع وأسرار البطاريات الكهربائية، تركيبِ وآليةِ عمل الموتورات، كيفيةِ تشغيل المحوِّلات التي تحوِّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية وحركة.
السبب: تفجّرت فيه رغبة عارمة لِصناعة طائرةٍ كهربائية صغيرة تصعد ولو بضعة أمتار في قلب شارعنا الصغير بعدَن: شارع يافا.
ارتبط جمال بعلاقة وثيقةٍ جدّاً بصاحب كاراج، كان له منزلٌ صغير في طرف شارعنا، يواصل أمامهُ مساءً علاج السيارات العاطلة بضوءِ فانوسٍ زيتيٍّ جبّار، تحت سمائنا الليلية الساحرة.
كان جمالُ يقضي بمعيّتهِ بضعة ساعات كلّ مساء ينحتُ الصفائح التي يجدها هنا وهناك، يُسوِّي قضبان الحديد، يُلحِّمها لِصناعة جسدِ طائرته الذي لم يتجاوز المتر والنصف طولاً، يصيغُ مراوحَها بانعطافٍ لولبي يتوسّطه ثقبٌ يرتبط بموتورٍ صغيرٍ، يُلحِّم الجناحين، يُجهّز قلبَ طائرته النابض: البطارية - التي كانت تقلّه أكثر ما تقلقه، ولزمته تجارب كثيرة لاختيارها- والموتور الصغير والمحوّل.
أسابيع من العمل الليلي القلق، ببدلةٍ زرقاء موشّحةٍ بالسواد، أمام أعين أولاد شارعنا الذين كانوا يرون الطائرة تنمو يوميّاً، تتعانقُ فيها الصفائح والأسلاك والعجلات المطاطية. إعجابٌ جماعيٌّ أشعلَ نرجسيّة جمال، التي تفتّقت منذ أن أمتلأت سماء شارعنا ببالونات الهيدروجين.
لم يكن أحدٌ مع ذلك واثقاً أن طائرة جمال ستطير ولو متراً واحداً، بمن فيهم أنا، صديقه الأثير. ولم يكن لِجمال من هدفٍ غير ذلك.
وضعها ذات مساء في الأرض "المسفلتة" في وسط صفّي البيوت المتوازية لشارعنا، كي تطير بشكلٍ موازٍ لهما. ثمّ ماذا بعد، إذا ما طارت فعلاً؟ ستنفذ طاقتها سريعاً، وستسقط بالتأكيد على الأرض، ستنكسر. عمل أسابيع طويلة ستطويه الرياح.
لا يهمّ جمالَ ذلك. يكفي أن تطير باتجاه السماء ولو قليلاً، باتجاه الحاج السماوي.
ثمّ ذات ليلةٍ ليلاء التفّ كل شباب شوارعنا حول جمال الذي قاد طائرته الصغيرة بفخر وقلق إلى قلب الشارع. محاولاتٌ عديدة قبل أن نلاحظ دوران مراوحها فعلاً، تقدّم عجلاتها الصغيرة رويداً رويداً، على إيقاع هيجان وفرحات أولاد الشارع، وزغردات نساءٍ في شرفات منازل. انتظار، عثرات، فشل.
ثمّ انطلقت، نعم انطلقت بشكلٍ مفاجئٍ سريع، بلمحة بصر: متر، متران، ثلاثة، أكثر قليلاً.
لم نلاحظ كيف مرّ ذلك، قبل أن نشعر أنها انحرفت عن المسار الذي توقَّعهُ موازياً لصفّي بيوت شارعنا، كي تسقطَ بعد ذلك في وسط الشارع، كما كان يفترض. لماذا انحرفت وأخذت مساراً قوسيّاً مفاجئاً؟ لا أحد يعرف.
ارتطمت بجدران الدور الأوّل من عمارةٍ مجاورة. تهشّمتْ واندلعَ منها بعض نارٍ ودخان. لا يهمّ، كان جمال سعيداً، كنا سعداء. عناقٌ جماعي وسط الشارع. في أعلاه، لمحنا غمزةً سعيدةً للحاج السماوي الذي أسرى بنا إلى السماء.