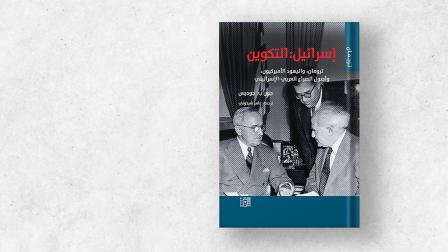الممثل مايكل كين في افتتاح فيلم "شباب" (Getty)
منذ فيلمه الروائي الطويل ما قبل الأخير، "الجمال العظيم"، (2013)، الفائز بجائزتي "الكرة الذهبية (غولدن غلوب)" و"أوسكار" أفضل فيلم أجنبي في عام 2014، تتردّد مقولة "تختزل" عالمه السينمائيّ، وسلوكه الإبداعي، واشتغالاته الفنية والدرامية، وتصوّراته ورؤاه الثقافية والاجتماعية؛ وهذا كلّه عبر سؤال مغزى الصورة السينمائية في التقاط نبض واقع وحياة، أو في أن تكون انعكاساً لواقع وحياة، وإنْ يُصوَّران بسخرية أو بواقعية أو بمحاكاة أو بانتقاد. الإيطالي باولو سورنيتينو (1970)، يُقرّ بنوعٍ من الهوس بالمعلّم فيديريكو فيلليني (1920 ـ 1993). هذا وحده، إن يدلّ على شيء ما، فهو يعكس بالتأكيد قدرة سورنتينو على إيجاد معادلات بصرية رائعة في أعماله، ترتكز ـ في مرجعيّتها الأساسية ـ على سينما فيلليني تحديداً، بأشكالها وأنماطها وأدوات تعبيرها، لكن على نسق فرانتشيسكو روزي (1922 ـ 2015) أيضاً.
الفيلم الأخير لباولو سورنيتينو ـ الذي أخرج "إل ديفو" في عام 2008، ونال بفضله جائزة لجنة التحكيم الخاصّة بالمسابقة الرسمية للدورة الـ 61 (14 ـ 25 مايو/ أيار 2008) لمهرجان "كان" السينمائيّ ـ يحمل عنواناً إنكليزياً هو Youth، أي "شباب" (2015)، المُقدَّم دولياً للمرّة الأولى في المسابقة الرسمية للدورة الـ 68 (13 ـ 24 مايو/ أيار 2015) لمهرجان "كان" أيضاً، والمهدى إلى المعلّم الإيطالي الآخر، روزي نفسه. منذ ذلك الحين، يُعرض الفيلم في صالات تجارية أوروبية، ويُشارك في احتفالات ومهرجانات مختلفة، آخرها "مهرجان السينما الأوروبية" في بيروت (لبنان)، في دورته الـ 22 (25 يناير/ كانون الثاني ـ 6 فبراير/شباط 2016).
قراءات نقدية
يختلف نقّادٌ عديدون في مقارباتهم السجالية لهذين الفيلمين. فعلى الرغم من تقديرهم جمالية النصّ والصورة، المحمَّلين بكم هائل ومبطّن من السخرية اللاذعة في تبيان وقائع العيش على حافة الانهيارات و"خواتيم" المسارات؛ وفي مقابل غوصهما ـ وإن بأشكال ومستويات جمالية مختلفة بينهما ـ في تداعيات العيش في "اللحظات الأخيرة" للحياة (الخاصّة بمدينة أو فرد أو أفكار أو مرحلة أو مسار مهنيّ، إلخ.)؛ إلاّ أن بعضهم يرى في "الجمال العظيم" ذروة تألّق إبداعي في ابتكار نسق انتقادي معقود على بهاء صورة، وصفاء توليف، ونقاء سياق. هذا كلّه بالتكامل التام فيما بينها، وبالانصهار معاً في بوتقة واحدة، هي في الواقع بوتقة اللغة السينمائية الآسرة في تفكيك معالم الحياة اليومية، القائمة إما على شفير الهاوية، أو في أعماقها القاتلة، في حين أن بعضاً آخر من هؤلاء النقّاد يعتبر "شباب" أعمق درامياً وإنسانياً في ذهابه إلى ما هو أبعد من "شفير الهاوية" تلك، بسرده حكاية عجوزين (مخرج سينمائيّ عاجز عن تحقيق ما يُمكن أن يكون "فيلمه الأخير"، وقائد أوركسترا موسيقية "ينبني" مجده الفنيّ ـ من دون إرادته طبعاً ـ على تذكّر الجميع لحناً واحداً له بعنوان "أغان بسيطة") يعيشان عند التخوم النهائية للحياة، ويحاولان إيجاد منافذ لهما تُعينُهما ـ بطريقة أو بأخرى ـ على استكمال رغباتهما وهواجسهما ومساراتهما؛ أو على تحقيق بعض رغباتهما وهواجسهما، وإن في اللحظات الأخيرة لمساراتهما.
اقرأ أيضًا: لا ممثلين وممثلات سودًا في ترشيحات الـ "أوسكار" 2016
لكن "إل ديفو" ـ المتمحور حول سيرة ذاتية ومهنية لشخصية سياسية فاعلة ومؤثّرة في المشهد الإيطالي العام، تُدعى جيوليو أندرويتي (1919 ـ 2013)، وهي سيرة مفتوحة على المال والأعمال والمصالح والمافيا والفساد الاقتصادي ـ لن يكون أقلّ جمالية سجالية، مبنيّة على ركيزة سينمائية مشغولة بحرفية توليفية سريعة الإيقاع في توغّلها داخل السياسة والمال والأعمال وعالم المافيا وكواليسها، وكاشفة مكامن الخلل والفساد والعفن في الشأن العام المفتوح على ألف سؤال ومصيبة.
بالتالي، هناك فيلم قصير بعنوان "الثروة"، يصنعه سورنيتينو ضمن إطار فيلم جماعي بعنوان "ريو، أنا أحبّك" (2014): لن يخرج الفيلم هذا على مسار انتقاديّ هازئ، يتناول شتّى أمور الحياة والعلاقات والعيش على تخوم النهاية المحتومة، لكن المؤجّلة. العودة قليلاً إلى البدايات السينمائية الأولى له، المنطلقة بعد دراسة جامعية خاصّة بالتجارة والاقتصاد إثر مقتل والديه الاثنين في حادث تسرّب غاز في عام 1987 (عند بلوغه الـ 17 عاماً من عمره)، تجعل استعادة "عواقب الحبّ" (2004) مثلاً بمثابة تذكّر ما لبذور مشروعٍ سينمائيّ لعلّه لم يكن واضحاً حينها بشكل كبير، يتمثّل بـ "عناصر أساسية" يتكشّف بعضها ـ بعمق إنساني بصري أكبر وأهمّ درامياً وفنياً وجمالياً ـ في "شباب"، وقبله ـ وإنْ بأساليب مختلفة ـ في "الجمال العظيم": الوحدة، الحبّ، الجسد الأنثوي، الأسئلة المتعلّقة بالحياة والانتماء والموت، معنى المقبل من الأيام، الذاكرة، التاريخ، الأفكار، الأحلام، التطلّعات، العلاقات، إلخ.
بدايات سينمائية
ربما لن يتمكّن "عواقب الحبّ" من طرح أجوبة ما على التساؤلات كلّها هذه. ربما لم يكن يطمح إلى طرح التساؤلات هذه أصلاً، وإنْ يبدو بعضها بمثابة امتحان سينمائيّ لمن يتخلّى عن كلّ شيء في حياته الشبابية الأولى، كي يصوغ لنفسه مكانةً سينمائية سرعان ما تعثر على حيّزها الإبداعي في السينما الإيطالية أوّلاً، وفي المشهد الدولي العام ثانياً. لكن الفيلم يبقى انطلاقة ثابتة في تحديدها المعالم الأولى لنسق سينمائيّ ينفتح لاحقاً على اختبار اللغة البصرية في مقارباتها المتنوّعة، وعلى امتحان المواجهة السينمائية للحياة والقدر والخيبات والهزائم والتحوّلات.
في الفيلم الروائي الطويل الثاني هذا "عواقب الحبّ"، المُنجز بعد 3 أعوام على الروائي الأول "رجلٌ بالزائد" (2001)، يرسم باولو سورنيتينو عالماً ذاتياً منغلقاً، بطله تيتا دي جيرولامو (توني سيرفيلّو) مقيمٌ في عزلة داخل فندق منذ 8 أعوام، بترتيب خاصّ مع الـ "كوزا نوسترا" (المافيا الصقلية، والتعبير الإيطالي يعني "ما هو لنا")، ولا يمتلك تسليةً واحدةً خارج التعاطي اليومي للهيرويين. في الوقت نفسه، وعلى الرغم من كل شيء، هناك ما يشغل باله وقلبه في آن واحدٍ: خادمة مقصف الفندق، المدعوة صوفيا (أوليفيا مانياني). فيها ما يشدّه إليها، وفي محيطها ما يُفترض به أن يُنهيه عن الخروج على الاتفاق المبطّن مع من يتولّى حمايته. هذا كلّه ضمن سياق يستدعي البحث الجمالي في شؤون مطروحة أعلاها، كما في المسار المقبل للمخرج نفسه، الذي يبدأ الخروج على بداياته الأولى، كي يغوص ـ أكثر فأكثر ـ في تشعّبات السياسيّ والاقتصاديّ والإنسانيّ والرثائيّ العام للحياة برمّتها.
اقرأ أيضًا:
الرثائيّ العام هذا نفسه يُمكن أن يتمّ التعامل معه على أساس أنه نواة أصلية لبنيان سينمائيّ ممتدّ من "الجمال العظيم" إلى "شباب"، مروراً بـ "الثروة". لكن، قبل الأفلام الثلاثة هذه، هناك ما يتوجّب التنبّه إليه: "لا بُدّ أن يكون هذا هو المكان" (2011)، الفيلم المُصوَّر باللغة الإنكليزية، والمنتقل في أمكنة أنغلوساكسونية (المملكة المتحدة والولايات المتحدّة الأميركية)، علماً بأن ممثليه الأساسيين أميركيون. فبالتعاون مع شون بن وفرنسيس ماكدورماند ودود هيرش وكيري كوندون وغيرهم، يلتقط باولو سورنيتينو نبض العيش في المسافة الفاصلة بين الذاكرة/ التاريخ/ الماضي والآنيّ/ الراهن/ الحاضر: شايِّين (شون بن) نجم سابق في عالم الـ "روك غوتيك". يعيش عزلة خاصّة به، إثر بلوغه البدايات الأولى للخمسينيات من عمره، في دبلن. وفاة والده تدفعه إلى نيويورك، حيث تنكشف أسرار ماضٍ، يُفترض بها أن تجعله يغتسل، عبر قسوة الذاكرة وتفاصيله، من أدران أمسٍ قميء وقذر ودموي وعنيف. ففي أميركا هذه، "يُطارِد" البطل ماضي والده، عبر بحثه عن مُعذِّبه النازي السابق في "أوشفيتز".
أنغلوساكسونية وعولمة
ما يُقال بخصوص أنغلوساكسونية "لا بُدّ أن يكون هذا هو المكان"، يُمكن أن يُساق في معرض الكلام على "شباب" أيضاً. وما يوصف به الفيلم السابق على مستوى "عولمة" سينمائية مفتوحة على حكايات إنسانية عامة، يُمكن اعتماده هنا أيضاً في قراءة "شباب".
مع الثنائي مايكل كاين وهارفي كايتل، إلى جانب راشيل وايز وجاين فوندا وغيرهما، يُشيّد باولو سورنيتينو عمارة سينمائية لن تبلغ الجمالية القصوى لـ "الجمال العظيم" في رثاء الحياة والماضي والأحلام المعلّقة، لكنه يبقى حيوياً في مقاربته أسئلة الوجود، أو المتبقي منه على الأقلّ، عبر عزلة الشخصيتين في فندق فخم يقع في منطقة جبال الألب السويسرية ـ هو الفندق نفسه الذي يكتب فيه توماس مان (1875 ـ 1955) روايته "الجبل السحري" (1924) ـ لأسباب مختلفة: مايك بويل (كايتل) يريد إنجاز "فيلم العمر"، مُضمّناً إياه وصيته وخلاصة عيشه. وفْرِد بالينغر (كاين) يبدو كهاربٍ من ضجيج الحياة إلى صفاءٍ ما يتعكّر بذكرى سقوط زوجته في المرض، وأسره بلحنٍ واحدٍ، وسعيه المعطّل إلى استكمال نهمه للحياة.
شخصيات عابرة أمام الكاميرا لن تقلّ أهمية عنهما، إذْ لكلٍّ منها خيبة وألم وانكسار وتمزّق ما. شخصيات تعشق الحياة، لكنها تبدو كمن يفهم إشارات النهاية والخراب اللاحق بها.
في أحد الأوصاف النقدية لاشتغالات باولو سورنيتينو، هناك ما يختزل عالمه ببضع كلمات صائبة: "كأي إيطالي، يولي سورنيتينو أهمية للأحاسيس النابعة من الفيلم. يقوم بجهدٍ كبيرٍ كي لا يتغلّب طبعه التهكّمي الساخر على التطبّع".
(كاتب لبناني)
الفيلم الأخير لباولو سورنيتينو ـ الذي أخرج "إل ديفو" في عام 2008، ونال بفضله جائزة لجنة التحكيم الخاصّة بالمسابقة الرسمية للدورة الـ 61 (14 ـ 25 مايو/ أيار 2008) لمهرجان "كان" السينمائيّ ـ يحمل عنواناً إنكليزياً هو Youth، أي "شباب" (2015)، المُقدَّم دولياً للمرّة الأولى في المسابقة الرسمية للدورة الـ 68 (13 ـ 24 مايو/ أيار 2015) لمهرجان "كان" أيضاً، والمهدى إلى المعلّم الإيطالي الآخر، روزي نفسه. منذ ذلك الحين، يُعرض الفيلم في صالات تجارية أوروبية، ويُشارك في احتفالات ومهرجانات مختلفة، آخرها "مهرجان السينما الأوروبية" في بيروت (لبنان)، في دورته الـ 22 (25 يناير/ كانون الثاني ـ 6 فبراير/شباط 2016).
قراءات نقدية
يختلف نقّادٌ عديدون في مقارباتهم السجالية لهذين الفيلمين. فعلى الرغم من تقديرهم جمالية النصّ والصورة، المحمَّلين بكم هائل ومبطّن من السخرية اللاذعة في تبيان وقائع العيش على حافة الانهيارات و"خواتيم" المسارات؛ وفي مقابل غوصهما ـ وإن بأشكال ومستويات جمالية مختلفة بينهما ـ في تداعيات العيش في "اللحظات الأخيرة" للحياة (الخاصّة بمدينة أو فرد أو أفكار أو مرحلة أو مسار مهنيّ، إلخ.)؛ إلاّ أن بعضهم يرى في "الجمال العظيم" ذروة تألّق إبداعي في ابتكار نسق انتقادي معقود على بهاء صورة، وصفاء توليف، ونقاء سياق. هذا كلّه بالتكامل التام فيما بينها، وبالانصهار معاً في بوتقة واحدة، هي في الواقع بوتقة اللغة السينمائية الآسرة في تفكيك معالم الحياة اليومية، القائمة إما على شفير الهاوية، أو في أعماقها القاتلة، في حين أن بعضاً آخر من هؤلاء النقّاد يعتبر "شباب" أعمق درامياً وإنسانياً في ذهابه إلى ما هو أبعد من "شفير الهاوية" تلك، بسرده حكاية عجوزين (مخرج سينمائيّ عاجز عن تحقيق ما يُمكن أن يكون "فيلمه الأخير"، وقائد أوركسترا موسيقية "ينبني" مجده الفنيّ ـ من دون إرادته طبعاً ـ على تذكّر الجميع لحناً واحداً له بعنوان "أغان بسيطة") يعيشان عند التخوم النهائية للحياة، ويحاولان إيجاد منافذ لهما تُعينُهما ـ بطريقة أو بأخرى ـ على استكمال رغباتهما وهواجسهما ومساراتهما؛ أو على تحقيق بعض رغباتهما وهواجسهما، وإن في اللحظات الأخيرة لمساراتهما.
اقرأ أيضًا: لا ممثلين وممثلات سودًا في ترشيحات الـ "أوسكار" 2016
لكن "إل ديفو" ـ المتمحور حول سيرة ذاتية ومهنية لشخصية سياسية فاعلة ومؤثّرة في المشهد الإيطالي العام، تُدعى جيوليو أندرويتي (1919 ـ 2013)، وهي سيرة مفتوحة على المال والأعمال والمصالح والمافيا والفساد الاقتصادي ـ لن يكون أقلّ جمالية سجالية، مبنيّة على ركيزة سينمائية مشغولة بحرفية توليفية سريعة الإيقاع في توغّلها داخل السياسة والمال والأعمال وعالم المافيا وكواليسها، وكاشفة مكامن الخلل والفساد والعفن في الشأن العام المفتوح على ألف سؤال ومصيبة.
بالتالي، هناك فيلم قصير بعنوان "الثروة"، يصنعه سورنيتينو ضمن إطار فيلم جماعي بعنوان "ريو، أنا أحبّك" (2014): لن يخرج الفيلم هذا على مسار انتقاديّ هازئ، يتناول شتّى أمور الحياة والعلاقات والعيش على تخوم النهاية المحتومة، لكن المؤجّلة. العودة قليلاً إلى البدايات السينمائية الأولى له، المنطلقة بعد دراسة جامعية خاصّة بالتجارة والاقتصاد إثر مقتل والديه الاثنين في حادث تسرّب غاز في عام 1987 (عند بلوغه الـ 17 عاماً من عمره)، تجعل استعادة "عواقب الحبّ" (2004) مثلاً بمثابة تذكّر ما لبذور مشروعٍ سينمائيّ لعلّه لم يكن واضحاً حينها بشكل كبير، يتمثّل بـ "عناصر أساسية" يتكشّف بعضها ـ بعمق إنساني بصري أكبر وأهمّ درامياً وفنياً وجمالياً ـ في "شباب"، وقبله ـ وإنْ بأساليب مختلفة ـ في "الجمال العظيم": الوحدة، الحبّ، الجسد الأنثوي، الأسئلة المتعلّقة بالحياة والانتماء والموت، معنى المقبل من الأيام، الذاكرة، التاريخ، الأفكار، الأحلام، التطلّعات، العلاقات، إلخ.
بدايات سينمائية
ربما لن يتمكّن "عواقب الحبّ" من طرح أجوبة ما على التساؤلات كلّها هذه. ربما لم يكن يطمح إلى طرح التساؤلات هذه أصلاً، وإنْ يبدو بعضها بمثابة امتحان سينمائيّ لمن يتخلّى عن كلّ شيء في حياته الشبابية الأولى، كي يصوغ لنفسه مكانةً سينمائية سرعان ما تعثر على حيّزها الإبداعي في السينما الإيطالية أوّلاً، وفي المشهد الدولي العام ثانياً. لكن الفيلم يبقى انطلاقة ثابتة في تحديدها المعالم الأولى لنسق سينمائيّ ينفتح لاحقاً على اختبار اللغة البصرية في مقارباتها المتنوّعة، وعلى امتحان المواجهة السينمائية للحياة والقدر والخيبات والهزائم والتحوّلات.
في الفيلم الروائي الطويل الثاني هذا "عواقب الحبّ"، المُنجز بعد 3 أعوام على الروائي الأول "رجلٌ بالزائد" (2001)، يرسم باولو سورنيتينو عالماً ذاتياً منغلقاً، بطله تيتا دي جيرولامو (توني سيرفيلّو) مقيمٌ في عزلة داخل فندق منذ 8 أعوام، بترتيب خاصّ مع الـ "كوزا نوسترا" (المافيا الصقلية، والتعبير الإيطالي يعني "ما هو لنا")، ولا يمتلك تسليةً واحدةً خارج التعاطي اليومي للهيرويين. في الوقت نفسه، وعلى الرغم من كل شيء، هناك ما يشغل باله وقلبه في آن واحدٍ: خادمة مقصف الفندق، المدعوة صوفيا (أوليفيا مانياني). فيها ما يشدّه إليها، وفي محيطها ما يُفترض به أن يُنهيه عن الخروج على الاتفاق المبطّن مع من يتولّى حمايته. هذا كلّه ضمن سياق يستدعي البحث الجمالي في شؤون مطروحة أعلاها، كما في المسار المقبل للمخرج نفسه، الذي يبدأ الخروج على بداياته الأولى، كي يغوص ـ أكثر فأكثر ـ في تشعّبات السياسيّ والاقتصاديّ والإنسانيّ والرثائيّ العام للحياة برمّتها.
اقرأ أيضًا:
الرثائيّ العام هذا نفسه يُمكن أن يتمّ التعامل معه على أساس أنه نواة أصلية لبنيان سينمائيّ ممتدّ من "الجمال العظيم" إلى "شباب"، مروراً بـ "الثروة". لكن، قبل الأفلام الثلاثة هذه، هناك ما يتوجّب التنبّه إليه: "لا بُدّ أن يكون هذا هو المكان" (2011)، الفيلم المُصوَّر باللغة الإنكليزية، والمنتقل في أمكنة أنغلوساكسونية (المملكة المتحدة والولايات المتحدّة الأميركية)، علماً بأن ممثليه الأساسيين أميركيون. فبالتعاون مع شون بن وفرنسيس ماكدورماند ودود هيرش وكيري كوندون وغيرهم، يلتقط باولو سورنيتينو نبض العيش في المسافة الفاصلة بين الذاكرة/ التاريخ/ الماضي والآنيّ/ الراهن/ الحاضر: شايِّين (شون بن) نجم سابق في عالم الـ "روك غوتيك". يعيش عزلة خاصّة به، إثر بلوغه البدايات الأولى للخمسينيات من عمره، في دبلن. وفاة والده تدفعه إلى نيويورك، حيث تنكشف أسرار ماضٍ، يُفترض بها أن تجعله يغتسل، عبر قسوة الذاكرة وتفاصيله، من أدران أمسٍ قميء وقذر ودموي وعنيف. ففي أميركا هذه، "يُطارِد" البطل ماضي والده، عبر بحثه عن مُعذِّبه النازي السابق في "أوشفيتز".
أنغلوساكسونية وعولمة
ما يُقال بخصوص أنغلوساكسونية "لا بُدّ أن يكون هذا هو المكان"، يُمكن أن يُساق في معرض الكلام على "شباب" أيضاً. وما يوصف به الفيلم السابق على مستوى "عولمة" سينمائية مفتوحة على حكايات إنسانية عامة، يُمكن اعتماده هنا أيضاً في قراءة "شباب".
مع الثنائي مايكل كاين وهارفي كايتل، إلى جانب راشيل وايز وجاين فوندا وغيرهما، يُشيّد باولو سورنيتينو عمارة سينمائية لن تبلغ الجمالية القصوى لـ "الجمال العظيم" في رثاء الحياة والماضي والأحلام المعلّقة، لكنه يبقى حيوياً في مقاربته أسئلة الوجود، أو المتبقي منه على الأقلّ، عبر عزلة الشخصيتين في فندق فخم يقع في منطقة جبال الألب السويسرية ـ هو الفندق نفسه الذي يكتب فيه توماس مان (1875 ـ 1955) روايته "الجبل السحري" (1924) ـ لأسباب مختلفة: مايك بويل (كايتل) يريد إنجاز "فيلم العمر"، مُضمّناً إياه وصيته وخلاصة عيشه. وفْرِد بالينغر (كاين) يبدو كهاربٍ من ضجيج الحياة إلى صفاءٍ ما يتعكّر بذكرى سقوط زوجته في المرض، وأسره بلحنٍ واحدٍ، وسعيه المعطّل إلى استكمال نهمه للحياة.
شخصيات عابرة أمام الكاميرا لن تقلّ أهمية عنهما، إذْ لكلٍّ منها خيبة وألم وانكسار وتمزّق ما. شخصيات تعشق الحياة، لكنها تبدو كمن يفهم إشارات النهاية والخراب اللاحق بها.
في أحد الأوصاف النقدية لاشتغالات باولو سورنيتينو، هناك ما يختزل عالمه ببضع كلمات صائبة: "كأي إيطالي، يولي سورنيتينو أهمية للأحاسيس النابعة من الفيلم. يقوم بجهدٍ كبيرٍ كي لا يتغلّب طبعه التهكّمي الساخر على التطبّع".
(كاتب لبناني)